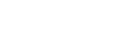*ميثاق: مقالات وآراء
ترجمة الميثاق: المصدر”New Lines Magazine“
يشعر العالم بالقلق تجاه “الفكر الجهادي” الذي يتبناه القادة السوريون الجدد، لكن العالم يتغافل عن هذه النقطة.
حالياً، لا يمكن رؤية أبي “محمد الجولاني” الجهادي في أي مكان. ومع ذلك، فإن اسمه البديل، أحمد الشرع، السياسي، يظهر على شاشة التلفزيون وفي القصر الرئاسي. لقد تولى بسلاسة دور رئيس الدولة، والتقى بشخصيات أجنبية بارزة، وأصدر نصائح حكيمة للأمة وطمأنة الأقليات بأن حقوقها ستتم حمايتها.
حتى الآن، تتطابق مهارات الشرع السياسية ومهارات الاتصال مع “براعة” الجولاني العسكرية أو حتى تحل محلها. قبل بضع سنوات، كان الرجل جهادياً مرتبطاً بالقاعدة يرتدي عمامة. ثم عاش في مرحلة “تشي جيفارا” ، مرتدياً الزي الرسمي. واستمر ذلك حتى دخوله المنتصر إلى الجامع الأموي في دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. والآن، بعد أن تخلى عن الاسم الحركي واستخدم باسمه الحقيقي، مرتدياً بدلة وربطة عنق، يشدد على رغبته – أي سوريا – في الاستقرار الداخلي والإقليمي. وخشية أن لا يزال أي شخص يعتبره ظلامياً متخلفاً، فإنه يسخر من الآخرين بسبب هواجسهم الغريبة بالماضي البعيد.
في 22 كانون الأول/ديسمبر، كان الشرع جالساً إلى جانب الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، وأشار إلى تدخل إيران للدفاع عن نظام بشار الأسد. نظمت إيران ميليشيات شيعية من أماكن بعيدة مثل باكستان للقتال في سوريا، وحشدتها بقصص عن صراعات على السلطة بين الخلفاء المباشرين للنبي محمد. “الأحداث التي حدثت قبل 1400 عام … ما علاقتهم بنا؟ سأل الشرع. “ما هي هذه العقلية؟ ما هو هذا المنطق؟
إنه لأمر رائع في الوقت نفسه أن يكون لسوريا مثل هذا القائد الماهر في هذه اللحظة الحساسة والمخيفة أن مثل هذه الشخصية القوية تلقي بظلالها على النظام السياسي الذي يولد. إن قدرات الشرع الهائلة وجاذبيته الجديدة، وحجم انتصاره (وإن لم يكن بأي حال من الأحوال انتصاره فقط) تزيد من احتمالات أن يتحول مرة أخرى، هذه المرة إلى رجل وطني قوي، وهو ما لا يحتاجه سوريا على الأرجح وهي تخرج من تحت الديكتاتورية القديمة.
كتب المفكر السياسي السوري ياسين الحاج صالح عن “الفاشيين ذوي ربطة العنق” و “الفاشيين الملتحيين”. إن الأمر لا يتعلق هنا بالملابس، بل بالفاشية. حتى الآن، يفعل الشرع ما يريده الشعب (على الأرجح) ويبتعد عن الفاشية. يقول إنه ستكون هناك انتخابات وأن المدنيين سيحكمون. وبطبيعة الحال، ما زال من غير الواضح ما يعنيه بالانتخابات. ذلك أن التيار السلفي الجهادي الذي ينبثق منه يعتبر الديمقراطية عموماً غير إسلامية. فهل غير الشرع رأيه حقاً في هذه المسألة؟ وهل يقبل الرجال تحت قيادته هذا التغيير في الرأي؟ وهل يسعى هو وهم من الآن فصاعداً إلى إقناع المجتمع بوجهة نظرهم، كما قد يفعل أي حزب سياسي عادي؟
إن التركيز على الحكم المدني هو رسالة ذات أهمية متساوية للسوريين والقوى الأجنبية. هذا يشير إلى أن الرجال الذين يحملون البنادق سيقفون جانباً، أو على الأقل يتخلون عن أسلحتهم. سيتم نزع سلاح المقاتلين المسلمين الأجانب الذين ساعدوا في محاربة الأسد ومنحهم الجنسية السورية. المجتمع ككل منزوع السلاح. لم يعد تلاميذ المدارس يرتدون الزي شبه العسكري ولم يعد اليوم الدراسي يبدأ بالتحية العسكرية. ستنتهي “الخدمة الوطنية” الإلزامية وسيتم بناء جيش محترف متطوع بدلاً منه. (هذا بلا شك شيء جيد. كانت الخدمة الوطنية في عهد الأسد مصممة لتخويف الشباب ومعاملتهم بوحشية. لقد كانت وسيلة لهزيمة المجتمع بدلاً من الدفاع عنه.) والأهم من ذلك، سيتم حل الفصائل المعارضة والعمل المقاتلون تحت إشراف وزارة الدفاع الجديدة.
*مواد ذات صلة:
في هذا السياق، أثار الجدل عندما ظهر رئيس حكومة تصريف الأعمال السوري الجديد، محمد البشير، أمام علم يحمل جملة الشهادة مكتوبة بخط اليد على خلفية بيضاء، بالإضافة إلى العلم السوري الحر (علم الثورة). كان علم الشهادة الذي وضع خلف شخصية يفترض أنها وطنية طائفياً من ناحيتين: لأنه يمثل الدين الإسلامي ولأنه ينتمي إلى فصيل معين، هيئة تحرير الشام. في الظهور العلني التالي للبشير، بعد عاصفة من الانتقادات، كان علم هيئة تحرير الشام غائباً بشكل واضح.
يشير أولئك الذين يميلون إلى الحكم الإسلامي إلى أن المعارضين المسلمين، مقاتلي الفصائل الإسلامية، هم الذين حرروا سوريا. هذا صحيح بالتأكيد، لكنها حقيقة جزئية. بدأت الثورة في عام 2011، وظلت مستمرة من نواح كثيرة بعد ذلك، من قبل مواطنين عزل يطالبون بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. من بين أولئك الذين شاركوا في الهجوم النهائي في عام 2024، فإن المقاتلين الذين ثاروا في درعا وريف حمص ليسوا بالضرورة إسلاميين، وبالتأكيد ليس بنفس الطريقة التي شاركت بها هيئة تحرير الشام، على الرغم من أنهم غالباً ما يكونون محافظين اجتماعياً. الفصائل الدرزية التي طردت قوات الأسد من محافظة السويداء قبل التقدم نحو دمشق ليست إسلامية بأي شكل من الأشكال. وحتى المقاتلون تحت مظلة هيئة تحرير الشام ليسوا بالضرورة سلفيين جهاديين سواء في السياسة أو الثقافة. غالباً ما شوهدوا وهم يغنون الأغاني على طريقة الصوفيين للاحتفال بالتحرير.

- ولكن من العدل أن نقول إن المقاتلين المنتصرين هم أبناء سكان محافظين اجتماعياً بشكل عام، حيث يتمتع الإسلام ــ على النقيض من أي برنامج إسلامي محدد ــ بجاذبية هائلة. ومن العدل أيضاً أن نقول ــ وإن كان هذا نادراً ما يقال خارج سوريا ــ إن المسلمين السنة في سوريا تعرضوا للقمع على أساس هويتهم الدينية. وتُظهِر وثائق أمن نظام الأسد أن حضور صلاة الفجر في المسجد المحلي كان كافياً لوضع سوري تحت المراقبة والاحتجاز المحتمل. وكان قمع المجتمعات السنية دائماً شرساً بشكل غير مسبوق. فمنذ بداية الثورة، كان المحتجون في الأحياء العلوية أو المسيحية أو المختلطة يتعرضون للملاحقة الفردية من قِبَل السلطات، وعندما يتم القبض عليهم، يتعرضون للتعذيب أو القتل. ولكن عندما احتج سكان الأحياء السنية، ارتُكِبَت أعمال عنف شديدة ضد المجتمع بأكمله، وليس المحتجين فقط. وفي إطار ما يسميه عالم الأنثروبولوجيا باولو غابرييل هيلو بينتو “التوزيع الانتقائي للعنف” على أسس طائفية، نظم نظام الأسد أيضاً سلسلة من المجازر بحق النساء والأطفال السنة في الجزء الأوسط من البلاد، بين حمص وحماة، وخاصة في عام 2012.
لذلك، ليس فقط المقاتلون، ولكن قطاعات كبيرة من المجتمع قد تشعر أن الوقت قد حان لتطبيق شكل من أشكال “الحكم الإسلامي”. بعد كل شيء، جلبت الانتخابات الحرة الأولى في تونس ومصر الأحزاب الإسلامية إلى السلطة، ولم تعاني تلك البلدان من سنوات من الحرب الطائفية مثل سوريا، ولا الصدمة المرتبطة بالحرب التي تميل إلى تقريب الناس من دينهم.
في هذا السياق، فإن التحول إلى السياسة الدينية ليس مفاجئاً ولا إشكالياً في حد ذاته. من الطبيعي والمنطقي أن يرغب مجتمع متدين إلى حد كبير ومسلم إلى حد كبير في استكشاف أفكار التنظيم السياسي وفن الحكم من منظور دينه وثقافته. (ستكون الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي مختلفة حتماً عن النسخ الغربية، التي تأتي على أي حال مع مشاكلها الهائلة).
لكن المجتمع السوري ليس متديناً فحسب، أو مسلماً فقط، والعديد من المسلمين المتدينين يؤمنون إيماناً راسخاً بضرورة وجود دولة مدنية بدلاً من دولة دينية. والسؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت النزاعات بين شرائح المجتمع تدور من خلال النقاش المحترم أو العنف.
وجاء اختبار مبكر في 19 كانون الأول/ديسمبر، عندما تجمع المئات في وسط دمشق للتظاهر من أجل “العلمانية” والدولة المدنية. أرسلت إدارة العمليات العسكرية – الحكام الجدد بحكم الأمر الواقع – ضابطاً لمخاطبة الحشد. عندما قال “لا للطائفية!” صفق الحشد. عندما أوضح أن الإسلام ضد الطائفية، ردّ عليه الحشد بهتافات “لا للحكم الديني!“
يمكن للمرء أن يكتشف بذور الأمل في هذا المشهد، واليأس أيضاً. أمل لأن الناس كانوا يعبرون عن آراء مخالفة في الأماكن العامة ولم يتم القبض على أحد أو إطلاق النار عليه. هنا أخيراً كانت السياسة الحقيقية، في بلد كانت عقوبة السياسة قبل أسبوعين هي الإعدام بالتعذيب. ولكن أيضاً اليأس، لأن الضابط والحشد كانوا يتحدثون لغات سياسية مختلفة تماماً وبدا أنهم غير قادرين على فهم بعضهم بعضاً.
ولكن مع تداول مقاطع فيديو للمظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، سرعان ما أشار البعض إلى أن العديد من المشاركين كانوا قبل أسبوعين من ذلك التاريخ من المؤيدين الصريحين لحرب الأسد ضد “الشعب/الإرهابيين“. وفي ضوء هذا، فإن المظاهرة كانت احتجاجاً على النظام الجديد من جانب أنصار الطبقة الحاكمة القديمة أكثر من كونها تعبيراً عن الالتزام بالحريات العالمية التي تشير إليها عادة عبارة “العلمانية” في البيئات الغربية. وكانت بمثابة تذكير بأن الصراعات الطبقية تكون أحياناً مخفية وراء الثنائية الإسلامية العلمانية، وأن “العلمانية” كانت في كثير من الأحيان قوة معادية للديمقراطية في العالم الإسلامي. وكانت “العلمانية” أحد الشعارات المستخدمة ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطياً للرئيس محمد مرسي في مصر، والتي استغلت لإعادة الحكم العسكري تحت قيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي. ولا توجد أي فرصة لاستعادة نظام الأسد بنفس الطريقة ــ فقد انهار تماماً ــ ولكن العلمانيين المؤيدين للثورة سوف يجدون صعوبة بالغة في العمل مع العلمانيين الذين كانوا مؤخراً من أتباع الأسد.
هناك مخاوف مشروعة من فقدان الحريات الشخصية الذي يلوح في الأفق، لكنها في الوقت الحالي لا تستند إلى أحداث فعلية. لا يقتصر الأمر على فتح الحانات في دمشق (لاستخدام مقياس للحرية المتنازع عليه للغاية والمبتذل في بعض الأحيان)، بل إنها في الواقع محمية من قبل السلطات الإسلامية. في 18 كانون الأول/ديسمبر، دخل رجل يدعي أنه من هيئة تحرير الشام حانة في دمشق ينتقد شرب وبيع الكحول. عندما اتصل أصحاب الحانة بالسلطات الفعلية، ألقوا القبض على الرجل. كما طلبت السلطات من كوادرها عدم التدخل في خيارات ملابس النساء. ومن الجدير بالذكر أن هيئة تحرير الشام لم ترسل “ديوان حسبة” أو هيئة دينية في محافظة إدلب الشمالية الغربية، التي تسيطر عليها، لعدة سنوات، وأنها وافقت على تعيين أول امرأة على الإطلاق لولاية سوريا، محسنة المحيثاوي، في محافظة السويداء.
يبدو أن البراغماتية والمرونة هي أمر اليوم. تم تطبيق المدونة القانونية التي التزمت بها حكومة الإنقاذ السابقة المتحالفة مع هيئة تحرير الشام في إدلب في جميع أنحاء سوريا في هذه المرحلة من الرعاية، ولكن مع إجراء تعديلات وفقاً للمعايير الاجتماعية لكل محافظة. في طرطوس، على سبيل المثال، حيث يضم السكان المختلطون العديد من العلويين والمسيحيين، لا توجد لوائح تتعلق بالكحول أو الحجاب.
في بعض النواحي، يبدو أن رؤية هيئة تحرير الشام الحالية تعكس اللامركزية العثمانية، حيث اتبعت المجتمعات الطائفية (أو القبلية) المختلفة (المعروفة باسم “الملل”) قواعدها الخاصة. حافظ النظام العثماني ما قبل الحداثة على الحقوق المجتمعية وقدراً جيداً من الحكم الذاتي المجتمعي. ما لم يفعله هو حماية الحقوق الفردية. كان على المسلم السني الالتزام بالشريعة الإسلامية، والمسيحي الأرثوذكسي بموجب قانون الكنيسة، سواء أحبوا ذلك أم لا. إن تكييف القانون وفقاً للجغرافيا بدلاً من مجرد الطائفة، كما في حالة طرطوس، قد يقدم حلاً وسطاً. إذا أراد شخص ما في إدلب أن يعيش أسلوب حياة “علماني“، فيمكنه الانتقال إلى طرطوس، أو على الأقل قضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك. إذا أراد أحد سكان طرطوس العيش في بيئة أكثر إسلامية، فيمكنه الانتقال إلى إدلب.
لقد حدثت اللامركزية بشكل طبيعي خلال سنوات الثورة وكانت متشابكة بشكل وثيق مع التجارب السورية الشعبية في الحكم الذاتي. في مرحلة ما – قبل أن تسحقها القوى الاستبدادية، بما في ذلك هيئة تحرير الشام – كان هناك أكثر من 800 مجلس محلي شبه ديمقراطي يدير الشؤون في المناطق المحررة، كل منها يطبق نموذجًا قرره السكان المحليون. إن مبدأ التنظيم الذاتي المحلي مبدأ قيم، وتطبيقه يمكن أن يمنع سوريا من الوقوع تحت طغيان مركزي متسلط آخر. يشعر السوريون بالقلق بحق من أن الفيدرالية قد تؤدي إلى انقسامات إقليمية قد تستغلها دول أجنبية معادية – إسرائيل وإيران على وجه الخصوص. في حين تمنح الفيدرالية سلطات دائمة لا رجعة فيها للمحافظات، مما يضعف الحكومة المركزية، يمكن سحب السلطات الممنوحة للسلطات الإقليمية بموجب اللامركزية بسهولة إذا أدت إلى صراع. إن السلطات التي أقترحها للامركزية ستغطي في كل الأحوال القضايا الاجتماعية والثقافية، وليس المسائل العسكرية أو الأمنية. إن الآلية التي تسمح بالاختلاف الاجتماعي يمكن أن تساهم في الواقع في الوحدة الوطنية وتعزيز الأمة ضد التهديدات الأجنبية.
لا ينبغي أن يكون معيار الحكم على الحرية مدى علمانية أو إسلامية النظام السياسي، بل مدى استبداده. غالباً ما يفترض أن “العلمانية” مرادفة للحرية في الغرب، لكن النسخ التي تمارس في العالم الإسلامي غالباً ما كانت استبدادية. كانت علمانية الأسد، في حين أنها سمحت للناس بشرب الكحول وارتداء التنانير القصيرة، استبدادية وطائفية على حد سواء. كانت العلمانية الكمالية في تركيا، مثل الشكل الذي كان يمارس في تونس حتى عام 2011، معادية للدين واستبعدت النساء اللواتي يرتدين الحجاب، على سبيل المثال، من بعض الأماكن العامة.
من ناحية أخرى، استوعبت “الإسلاموية“، في بعض الحالات – النادرة – الحقوق المدنية والإنسانية. كانت الميليشيا الثورية الرئيسية في ضاحية داريا في دمشق تسمى شهداء الإسلام. ومثل بقية مجتمع داريا، تأثر مقاتلوها بالشيخ جودت سعيد “الإسلامي الليبرالي“، الذي شدد على أهمية المشاركة الشعبية في الحكم وحقوق المرأة والأقليات. ربما كانت “شهداء الإسلام” هي الميليشيا الوحيدة في كل سوريا التي تعمل تحت السيطرة المدنية.
إن الخطاب المعادي للعلمانية في البلدان الإسلامية كان عادة رد فعل على أشكال العلمانية الاستبدادية أو التي تسعى إلى التغريب بشكل عدواني. وعلى نحو مماثل، كانت الإسلاموية في الممارسة العملية عموماً شكلاً من أشكال القومية الإسلامية، وهي القومية التي ترفض غالباً الحدود التي أقامها الغربيون في العالم الإسلامي، أو على أساس النماذج الغربية، في حين تعمل ضمناً ضمن هذا الواقع. وكانت مهووسة بالاستيلاء على الدولة ما بعد الاستعمارية القوية واستخدامها لتنفيذ برنامجها الإيديولوجي، وكثيراً ما تشبثت برموز الحكم الإسلامي ــ مثل عقوبات “الحدود“، بما في ذلك البتر والرجم ــ على وجه التحديد لأن هذه هي جوانب الشريعة الإسلامية التي تثير غضب الغربيين أكثر من غيرها. ولكن فضلاً عن العقوبات الصارمة، فإن الإسلام يتطلب العدالة الاجتماعية. والواقع أن الاقتصاد السليم وقدراً من العدالة الاقتصادية يعتبران ضروريين ــ على غرار الخليفة عمر، الذي أوقف/ عطّل عقوبة السرقة أثناء المجاعة ــ قبل أن يتسنى تنفيذ عقوبات الحدود.
لم تكن الأنظمة السياسية الإسلامية ما قبل الحداثة دولاً مطلقة القدرة بالمعنى المعاصر، ولم تكن تراقب سلوك الناس بشكل عام. في سوريا المعاصرة أيضاً، يجب ترك الشعب يحكم نفسه في الشؤون الاجتماعية والأيديولوجية. سيتم مقاومة الإكراه من أعلى إلى أسفل، وليس فقط من قبل الأقليات الطائفية. من الأفكار الأخرى لياسين الحاج صالح أنه لا توجد “أغلبية سنية” في سوريا، على الرغم من أن غالبية السوريين هم من السنة، لأن أفراد الفئة السنية منقسمون حسب الطبقة والأصل الإقليمي، فضلاً عن مستويات وأنواع مختلفة من المعتقد والانتماء.
وبدلاً من السعي إلى إجبار الشعب على الدخول في أي قالب أيديولوجي، من الأفضل للنظام السوري الجديد أن يسعى إلى رؤية إسلامية لمجتمع عادل بالطريقة التي حاول بها حزب العدالة والتنمية في تركيا، أو الأفضل من ذلك، على طريقة راشد الغنوشي “ما بعد الإسلامي” في تونس، الذي يرى أن حرية اختيار التقيد (بدلاً من الإكراه) ذات قيمة دينية. وبالمثل، التحرر من الدولة المتغطرسة، سواء كانت علمانية أو دينية، لتكون مرغوبة دينياً وسياسياً. (شارك الغنوشي في تأسيس حزب النهضة، الذي حكم تونس بعد ثورة 2011، لكنه مسجون حالياً من قبل الدولة المتسلطة في ظل ديكتاتورية الرئيس قيس سعيد).
بالنسبة لسوريا، بعد عقود من الاستبداد وسنوات طويلة من الحرب، كلما قل التباهي الأيديولوجي، كلما كان العمل عملياً أكثر، كان ذلك أفضل. إن الروح الإيجابية للدين في العمل مطلوبة، بدلاً من فرض الرموز الأدائية.
يقول الشيخ أحمد صياصنة، رجل الدين الثوري المنفي من درعا والذي عاد الآن: “سواء كانت الحكومة المنتخبة من قبل الشعب هي حكومة دينية أم لا، فإن أهم شيء هو أن تحكم سوريا ديمقراطياً. يجب ألا يكون إرهاب أو هيمنة المواطنين السوريين جزءاً من الحكومة الجديدة”.
وهذه هي النقطة. سواء كانت الدولة دينية أو علمانية، فإن سوريا بحاجة إلى مجتمع قوي، وليس رجلاً قوياً.