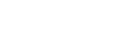*ميثاق: بورتريه
خالد العظم
الرجل (تمهيد)
كان الوقت قد تأخر قليلا في مساء في آخر شتاء وبداية ربيع 1903، عندما وصلت إلى جامع خالد بن الوليد في حمص سيدة دمشقية من أسرة عريقة، ودخلت مباشرة على الصحابي الجليل مستجيرة به وطالبة منه الشفاعة عند خالقها ليرزقها غلاما، بعد أن مات لها غلامان، على امتداد خمسة وعشرين عاما. وقد وعدت السيدة الصحابي بأن تسمي الغلام باسمه إن تحقق رجاؤها. ولا شك أنها بالغت في هز الشبك المحيط بضريح الصحابي كثيرا، لدرجة أن صاحب الضريح استجاب لها، واستجاب الله لهما، فما أن قفلت السيدة عائدة إلى بيتها في حي ساروجة بدمشق، واستقرت فيه مع زوجها بضعة أيام حتى شعرت بأعراض الحمل، وفي 6 تشرين الثاني، ولدت السيدة وكان الوليد غلاما. على أن ذلك كان منة ليس عليها فحسب، وإنما على السوريين جميعا. كانت السيدة هي حرم محمد فوزي باشا العظم، أما الوليد فكان خالد العظم.
لو طلب إلي أن ألخص تاريخ سورية في ثلاثة رجال لاخترت هاشم الأتاسي وفارس الخوري وخالد العظم. ولو طلب إلي اختصاره في رجل لترددت كثيرا في الاختيار، ولرسوت أخيرا على خالد العظم، مفضلا إياه على صاحبيه، لأن الأولين كانا مناضلين وطنيين عظيمين ساهما في استقلال البلاد سياسيا. أما العظم فكان الرجل الذي أسهم في استقلال سورية الاقتصادي وفي تنميتها وتقدمها، و،أهم من ذلك ربما، إعطائها هويته الوطنية الحقيقية.
كان خالد العظم مسكونا بسورية. وكان رجلا حاد الذهن، وفي أحيان كان عرافة، بيد أن ذكاءه كان عائدا إلى مستوى تفكيره، وهو ما كان شاتوبريان يدعوه بذكاء عظمة الروح. وهو مسكون بسورية كما كان شارل ديغول مسكونا بفرنسا وماو بالصين ونهرو بالهند. بيد أنه يختلف عن الجميع، بأنه لم يطبع البلد باسمه، كما فعل الآخرون.
وذلك ربما عائد إلى طبيعته. فهو، على عكس القادة الكبار، رجل انطوائي، خجول، شديد الحساسية، يميل إلى العزلة، وربما كان الأجدر به أن يكون شاعرا أو فيلسوفا أكثر منه سياسيا. وهو يذكر بتولستوي أكثر ما يذكر بلينين، وبأندريه مالرو أكثر من الجنرال ديغول، وبمحمد إقبال أكثر من محمد علي جناح.
حين بلغ سن التعليم، كان يخاف الذهاب إلى مدرسته وحيدا، فكان على المربية ليس أن تصحبه فقط، ولكن أن تجلس بجواره في الصف. أما المدرسة لابتدائية فلم يستطع تحملها لأنه وجد نفسه وحيدا بين أولاد لا يعرفهم، فانتابه وجل سببه على الأرجح عدم اعتياده مخالطة الناس. ذلك أن أباه كان يمنع عليه مخالطة من كان في سنه، ومنعه من ارتياد المقاهي والملاهي ودور السينما، فكان أن أمضى معظم وقته في بيته معزولا, برفقة معلم خاص، كان يغافله ويمضي للعب أو لتناول الشوكولاتة. ثم أحضر والده له مربية إفرنسية وأخرى سويسرية علمتاه الفرنسية والعلوم وآداب المجتمع.
وما أن بلغ السادسة عشرة حتى عرض عليه أبوه الزواج، فتزوج أول مرة من قريبة له، تكبره سنا. وحضر زفافه (التلبيسة) وحضر الزفاف الأمير فيصل والأمير زيد والحاكم العسكري رضا باشا الركابي وأركان الحكم آنذاك. وحين دخلت العروس بيته، وحاولت لصق العجينة بالجدار، وقعت العجينة على الأرض، ثم انقطع السلك الذي يحمل المصباح الكهربائي الكبير الذي كان ينير الحفلة، فتشائم الخلق. وربما كان تشاؤمهم محقا، فلم يمض شهران على الزفاف حتى مات والد العريس. أما العروس فماتت قبل أقل من سنة. وترك الفتى الخجول المدلل ليكمل طريقه الحياة وحيدا. وكان لذلك أثر سيئ على تركيبته النفسية حيث أمسى منكمشا على نفسه، شاكا – ونحن نستعير هنا عباراته بالحرف “في الجميع، وفي كل ما يقال، عديم الاعتماد على أحد، سيئ الظن بأقرب الناس وأخلصهم.” وبينما كان يرى إلى البشر كيف يكونون صداقات بيسر وسهولة، كان هو يبقي علاقاته بمن يتعرف عليهم سطحية في غالب الأمر، فغلب عليه وصفه بالتكبر والعجرفة. في حين أن الأمر لم يكن أكثر من طبع خجول انعكس في كونه رجلا “غير أليف،” لا يحب رفع الكلفة بينه وبين الآخرين. وكان لا يحبذ أن يكون محط الأنظار ويستحي من احتلال مكان الصدارة في مجلس. وكثيرا ما كان يذهب إلى صالة السينما لمشاهدة فيلم، فيدخل بعد أن تطفأ الأنوار، لكي لا يميزه أحد.

- ومرجع ذلك كله هو أبوه محمد فوزي باشا العظم، الذي كان واحدا من أهم وجهاء دمشق وبلاد الشام. فهو كان نائبا في مجلس المبعوثان العثماني لأكثر من مرة، كما كان وزيرا في حكومة الصدر الأعظم مختار باشا. وكان له الفضل في الضغط السياسي الذي دفع بالحكومة المركزية إلى طرد جمال باشا السفاح من ولاية الشام، وجر مياه عين الفيجة بقساطل الفولاذ إلى منازل دمشق. وبعد انسحاب العثمانيين، وقيام الحكم الوطني، نافس قائمة (رجال الغيب) بقيادة شكري القوتلي وجميل مردم التي كان يؤيدها الأمير فيصل والقائد رضا الركابي بقائمة وطنية وفاز في الانتخابات، ثم نافس الرئيس هاشم الأتاسي، زعيم سورية الأول، على رئاسة المؤتمر الوطني السوري، وفاز برئاسة المؤتمر حتى وفاته.
هذه الشخصية الكبيرة تركت ظلالها على الصبي الصغير والفتى الذي تزوج في السادسة عشرة وفقد أباه وزوجته في سنة واحدة. ولعل تربيته، صبيا، لعبت دورا في تعقيد شخصيته. فهو مفكر اقتصادي وزعيم سياسي، بيد أنه طالما افتقر إلى الحزم والشجاعة، ولم يعرف التهور في حياته، وغالبا ما فضل الحلول الدبلوماسية على الحلول الراديكالية. ونستطيع أن نقول إنه كان يفتقر إلى الشجاعة الشخصية والإقدام. وقعت أخته مرة في بحيرة قرب بيته في تركيا وكان يلعب معها ومع ابن خالة له. وعندما رآها تغوص في الماء ولم يعد يظهر لها أثر، تولاه الخوف فقفز هاربا إلى البيت. وكان من الممكن أن يفقها إلى الأبد لولا أن ابن خالته تملك جأشه، وظل واقفا قرب البحيرة حتى رآها تطفو فحاول إخراجها بخشبة ففشل، ثم ناداه ليساعده فعاد خالد من البيت، وتعاون الولدان على إنقاذ الصبية. غير أنه لم يقل الحقيقة لأخته وظل يمننها بأنه هو الذي أنقذ حياتها. و عندما اندلعت ثورة 1925، هرب إلى مصر، حيث أقام هناك أربعة أشهر، حتى خفت حدة الثورة، فرجع إلى دمشق. وعندما استلم العسكر مقادير الأمور في البلاد منذ الثلاثين من آذار سنة 1949، لم يواجههم بشكل مباشر، وإن عمل كل جهد مستطاع ليحد من تأثيرهم السلبي ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
على أنه كان شديد الذكاء والحساسية. وكان يتمتع بحس قيادي مرهف، تميز مبكرا مثلا بإصدار جريدة كان يحررها مع ثلاثة من صحبه في المدرسة الابتدائية، ويوزعها على أربعة أشخاص هم في الواقع آباء أعضاء هيئة التحرير. ولم يكتف خالد الصغير بكتابة القصص على الورقة مباشرة، بل كان يطبعها على الجيلاتين، بقياس 22 X 30 سم. وهو يصف ذلك فيقول:”وكنا نتقاضى بدل الاشتراك (حسب) مقدرة المشترك المالية، ونعنى بالتحرير والطبع ونقضي أوقات فراغنا في هذه المهنة، حتى يأتي يوم الإصدار الأسبوعي.” وهكذا لم يقض خالد وقته يلعب كرة الشراب في الشارع، بل قاد فريقا من ثلاثة صحاب لإصدار مجلة.
من الاقتصاد إلى السياسة:
عاش خالد العظم طفولته وصباه وشبابه في دمشق وبيروت واستنبول. وحين عاد إلى دمشق أخيرا بعد غياب دام سنتين منذ اندلاع ثورة 1925، قرر أن يبدأ حياته في الحقل الاقتصادي ولكنه فشل في تجنب الحقل العام الذي كان نوعا من الإرث الذي ورثه عن مركز والده الرفيع.
وفي 1927، ارتبط اسمه بحدثين مهمين: الأول كان مساهم في تأسيس النادي السوري-الفرنسي، سوية مع رئيس الجمهورية المقبل محمد علي العابد وأمين العاصمة واثق العظم. أما الحدث الثاني فكان تأسيس غرفة للزراعة. فلقد أدى المسعى الذي قام به العظم الشاب لدى رئيس الحكومة آنذاك الداماد أحمد نامي بك للحصول على موافقته على تأسيس غرفة زراعية، تعنى بشؤون المزارعين. وشغل العظم منصب أمين السر فيها، وكان العمود الرئيسي في أداء أعمالها، وخاصة عقدها مؤتمرا زراعيا هو الأول في تاريخ سورية.
إلى ذلك، وعندما كان عضوا في مجلس بلدية دمشق، كان أحد الساعين وراء بناء مدينة حديثة الطراز، نظيفة ومتألقة. وكان المجلس البلدي هو الذي استدعى المهندس التخطيطي الشهير دانجه ومعه المهندس إيكوشار، اللذين ارتبط اسماهما بجمال مدينة دمشق، قبل الفوضى المعمارية التي اجتاحت المدين بعد الستينات. فهما اللذان وضعا المخطط العام للمدينة، وبفضل مخطط دانجه أصبحت دمشق المدينة الجميلة التي ظلت على جمالها حتى نهاية الستينات، تزهو بأحيائها الحديثة، وبحدائقها العامة، وبحسن تنسيق شوارعها، والأشجار المغروسة على جوانبها. على أن مأثرت في بلدية دمشق هي إصراره على الوقوف في وجه الحاكم الإداري وائق المؤيد الذي كان يريد بالاتفاق مع الإفرنسيين تزوير لانتخابات النيابية عام 1032 ذلك أن الانتخابات كانت تجرى بإشراف المجلس البلدي وقتذاك. وهو يقول في ذلك: “كنت في الواقع أشعربأنني لا اقوم بأي عمل لخدمة بلدي، ولا أشارك المجاهدين والعالمين في سبيله، فأحببت أن أدخل المعترك، ووجدت تلك المناسبة فرصة قيمة.” تلك إذن أولى الصدامات بين العظم والسلطات الفرنسية. وهي على أية حال لم تكن كثيرة.
غير أنه لم يترك نشاطه الاقتصادي، إذ أنه كان مساهما كبيرا في شركة لصنع الإسمنت، وكان مديرها العام لفترة من الزمن. وهو لم يستثمر أمواله في مشاريع تدر عليه ربحا سريعا، وإنما ساهمدائما في تأسيس منشئات كانت بمعايير ذاك الزمان تعتبر مؤسسات عملاقة بالنسبة للقطاع الخاص.
*مواد ذات صلة:
واستفاد من إدارته لشركة الإسمنت خبرة في الإدارة ووعيا اقتصاديا استثمره فيما بعد في إدارة الدولة. وزد على ذلك أنه سافر مرارا إلى أوروبا لشراء آلات والبحث في عقود جديدية، مما أكسبه أيضا وعيا في العالم لذي حوله، ولم تكتف حدود ثقافته بحدود الثقافة العثمانية التي تلقاها في طفولته ومطلع صباه. ولقد استهلك العمل الخاص من وقته بضعا من سنوات الثلاثينات التي كانت موارة بالعمل الوطني، ففيها تم انتخاب مجلس نواب 1932، وفيها حل، وفيها وصلت النازية إلى الحكم في ألمانيا ووصلت حكومة اشتراكية إلى الحكم في فرنسا، ووقعت فرنسا معاهدة الاستقلال مع الحكومة السورية ثن نقضتها. وإنه ليكرس جل وقته في توسيع معمل الإسمنت، عندما زاره السيد نجيب الأرمنازي، مدير مكتب رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي، وعرض عليه أن يكون وزيرا في حكومة جديدة سيشكلها السيد نصوح البخاري. فأثنى العظم على اختيار البخاري للمنصب، ولكنه فوجىء بعرض حقيبة وزارية إليه، وقال للأرمنازي إنه منشغل الآن بتوسيع معمل الإسمنت وليس لديه وقت للعمل السياسي. بيد أن الرئيس الأتاسي أصر على استيزاره، وزاره كذلك الرئيس الملف نصوح البخاري، ليقنع بالاشتراك بحكومة وصفها العظم فيما بعد بانزاهة والحزم. وهكذا صار العظم لأول مرة وزيرا بينما كان لا يتجاوز السادسة والثلاثين من العمر. على أن وزارته لم تتجاوز بضعة أسابيع، إذ وصلت حكومة البخاري إلى طريق مسدود مع المفوض السامي الفرنسي الذي كان يريد النكوص عن معاهدة 1936، ورفض البخاري إضافة أي ملحق للمعاهدة يغير من مضمونهاالذي يصفه هو بأنه لم يكن “شيئا يبكى عليه.” فاستقالت الحكومة وفشل الأتاسي بتشكيل حكومة جديدية واستحصل المفوض السامي على صلاحيات مطلقة لإدارة سورية، وأعلن فك ارتباط لواء اسكندرونة وجبل الدروز عن الحكومة السورية، فاستقال الأتاسي، وأوقفت الحياة لانيابية وشكلت حكومة مديرين لتسيير أمور البلاد.
في هذه الظروف الحرجة التي كانت تزداد سوءا يوما بعد يوم، عرض على خالد العظم أن يشكل حكومة جديدة. هو موقف لا يحسد عليه. فمن جانب سيكون تشكيل حكومة مدنية إنهاء لحكم الفرنسيين المباشر وحكومة المديرين وانتهاء الحكم غلى أمثال تاج الدين الحسيني أو بهيج الخطيب؛ ومن جانب آخر فإن التاريخ لن ينسى أنه قبل برئاسة الحكومة دون إعادة الحياة الدستورية إلى البلاد. هل تحسم المسألة بزيارة للرئيس المستقيل؟ يركب خالد العظم سيارته ويتجه إلى حمص ويناقشه في الأمر، حتى يحصل على مباركته. بيد أن القوتلي وأعضاء التلة الوطنية في دمشق يعملون لإفشال مشروعه تشكيل حكمة وطنية. ورغم أن العظم لم يكن يحب المواجهة ويرجح المسالمة في كل أمر حتى ولو أدى هذا الأمر إلى خسارته، فإنه ههنا يقرر العزم على المضي في طريقه، ومواجهة الجاعة التي يوقول عنها إنها وقفت في وجه ترشيحه للنيابة سنة 36، وابعدته عن كل شأن عام، خوفا من منافسته لها وتفوقه عليها. وشجعه على موقفه دعم الرئيس الأتاسي والسيد فارس الخوري، فشكل أول حكومة برئاسته، وضمت محسن البرازي وحنين صحناوي ونسيب البري وصفوت قطرأغاسي.
وبذلك انضم خالد إلى القافلة العريقة من حكام سورية من آل العظم . وستكون تلك أول حكومة من خمس حكومات يشكلها طوال حياته السياسية. والغريب أن رياسته للوزراة كانت غالبا ما تنتهي بكارثة أو ثورة أو حرب.ففي 1941 قامت الحرب بين الديغوليين والفيشيين، وانتهت وزارته الثانية بانقلاب حسني الزعيم ودخوله السجن، وآلت وزارته الرابعة إلى استيلاء الشيشكلي على مقاليد الأمور، أما وزارته الأخيرة فانتهت بانقلاب 8 آذار 1963.
خلال وزارته الأولى، استطاع العظم على امتداد 165 يوما أن يحقق الكثير للسوريين، إن لم يكن سياسيا فعلى صعيد الحياة المعيشية والاقتصادية. وكان أهم ما قامت به حكومته هو حق تسيير أمور الإعاشة التي كانت حكرا على الفرنسيين وتخفيض سعر الطحين، باستصدار قرار يجيز للحكومة إدارة مطاحن الحبوب الخاصة. وأطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين. بيد أن مأثرته الكبرى كانت في تعامله مع واحد من أصعب الأوضاع التي مرت بها سورية قبل الاستقلال: اجتياح القوات البريطانية والديغولية لسورية. وتبرز هنا حكمة هذا الشاب الذي لم يصل إلى الأربعين بعد في إدارة الأوضاع محاولا أن يجنب دمشق أي خسارة محتملةز واستطاع أن ينتزع من المفوض السامي صلاحيات استثنائية استخدمها في تجنيب دمشق قصفا بريطانيا كان يمكن أن يكون مدمرا. كان يمكن لأي غر في إدارة الحكم، كما كان حال العظم، أن يقع في الوهن والتشوش ويؤثر السلامة أو يرتجل قرارات كارثية مستفيدا من السطةالمطلقة التي منحها في الفترة الأخيرة. ولكنه تجاوز المحن بأقل الخسائر، وتوج نجاحه بجلسة حوار طويلة مع الجنرال المنتصر شارل ديغول، طالبه فيها بإعادة الحياة الدستورية وإعادة الأتاسي إلى الحكم. وبهت ديغول بهذا الشاب الذي يطلب الحكم لغيره ولا يطلب شيئا لنفسه.
وحين أحس بأنه أدى دوره، تنحى عن رئاسة الوزارة. وأراد أيضا أن ينسحب من الشأن العام، لينال قسطا من الراحة، فلم يسجل اسمه لانتخابات 1943، لولا إلحاح السيد صبري العسلي عليه في الساعة الأخيرة قبل إغلاق الباب أمام الترشيح. وانضم غلى قائمة الرئيس شكري القوتلي فقط لتبدأ بين الرجلين علاقة فذة من الاختلاف الدائم والاحترام المتبادل. لم يكن القوتلي يروق للعظم. ورغم أن والده طلب إليه أن يعزز صداقته معه، عندما كان فتى صغيرا، ورغم احترامه الكبير لأبيه، فإنه لم يستطع أن يستلطف الرجل. ولعل العظم كان محقا، فإن شخصية قيادية طاغية مثل القوتلي، جاءت من قلب الميدان، الحي الدمشقي الوطني العريق ولكن الأقرب إلى الهوج والحدة ما كان لتأتلف مع شاب مثقف مرهف الحس، غربي الثقافة، قادم من حي ساروجة، مثل خالد العظم. ومع ذلك فإن القوتلي كان يحترم ذكاء العظم وثقافته، بينما كان العظم يكبر فيه روحه الكفاحية العالية، وينسب إليه بدون تردد فضل تحقيق جلاء القوات الأجنبية وتحقيق الاستقلال الناجز لذي لا تحده معاهدة أو محالفة مع أية دولة أجنبية.
والحق أن العظم كان موضوعيا إزاء خصومه. فلطالما أبدى خلافه مع طريقةالكتلة الوطنية في السياسة وإدارة الحكم. ومع ذلك، فقد كان له رأي إيجابي بفارس الخوري وسعد الله الجابري وجميل مردم وغيره، وإن كان لا يجاملهم في مواطن ضعفهم. فالقوتلي فردي، يستأثر برأيه ويريد فرضه على الجميع؛ والخوري كان رجل دولة خبيرا ولكنه لا يملك جأشه في الأزمات، أما الجابري فشجاع لا يهاب الإقدام على شيئ فيه صلاح البلد. وأما صبري العسلي فقد وصفه لالوطنية والحزم والوفاء وسعةالتفكير.
مسيرة العظم والقوتلي أسفرت دائما عن منصب وزاري كان العظم يشغله في معظم حكومات الرئيس القوتلي. فشغل حقيبة المالية والاقتصاد والعدلية والإعاشة والخارجية والدفاع. وكان في كل واحدة يقدم عملا يقرن باسمه: ففي المالية، قام بسياسة إصلاح النقد وفصل المؤسسات المالية السورية عن الفرنسية؛ وفي وزارةالإعاشة، أصدر قانونا يضرب على يد المتلاعبين بالمواد الغذئية ويرفعون الأسعار وأنشأ مستودعات ضخكة لتخزين الحبوب؛ وفي وزارة العدلية، الغى المحاكم المختلطة التي كانتتعطي للأجانب وضعا خاصا عند ارتكاب جرم على الأراضي السورية.
ولست ادري إذا ما كان من حسن حظه أنه كان وزيرا مفوضا لسوريا في باريس أثناء اندلاع حرب فلسطين، على أنه من حسن حظ السوريينأنه تراس الحكومة بعد الهزيمة، فسار بالبلد بهدوء وروية ليبتعد بها عن الآثار السلبية التي خلفتها هزيمة العرب وخسارة فلسطين.
وداعا للديموقراطية الأولى:
في نهاية 1948، واجه الرئيس شكري القوتلي أزمة حكومية حادة، أجبرته على أن يختار شخصية غير حزبية ليشكل الحكومة. كان القوتلي يعاني من عقابيل تمديد رئاسته دورة ثانية، بخلاف الدستور. ولعله، كما يرى بعض المؤرخين كان يريد تمرير اتفاق مد خطوط النفط السعودي إلى سورية، على يد شخصية مستقلة نزيهة لا يطالها الشك بإيثار مصلحة خاصة على مصلحة البلد، فاستدعى خالد العظم الذي كان هو نفسه قد أبعده إلى باريس ليكون وزيرا مفوضا هناك. وشكل العظم ثاني حكومة في حياته السياسية، بعد أن تجاوز عدة صعوبات كادت أن تدفعه للاعتذار والعودة إلى باريس وإرسال رسالة اعتذاره من هنا. ولكنه قرر المواجهة وحصل على تأييد مطلق من الرئيس، واتفق الطرفان على أن الخطر الأول الآن هو مواجهة الخطر الهاشمي الآتي من العراق ومواجهة الدولة اليهودية التي انزرعت إلى الجنوب من الحدود.
بالنسبة للعظم كانت سورية درة تاجه، وكان الدفاع عن استقلالها وتنميتها وتطويرها أبعد غاياه. وكان يرى أن بديله للحكم المطروح عادل عسيران لن يكون قادرا على مواجهة هذه التحديات السياسية والاقتصادية، فقرر الاستمرار وتشكيل الحكومة.
وكانت الأيام وااسنون قد زاددت خبرته فيمجال العمل البرلماني والحكومي. وخففت م حدته وخشونته التي كانتا تميزان حياته النيابية الأولى، عندما كان يرد بقسوة أو يغادر الجلسة كلما أحس سوء نية من أحد النواب. غير أن خبرة السنين وإقامته في باريس، حيث حضر الكثير من جلسات النقاش في البرلمان الفرنسي أكسبتاه خبرة ومرانا استفاد منهما بكثرة في حكوماته التي شكلها من 48 إلى 51، وفي مناصبه الوزارية الأخرى.
وكان أهم ما أنجزته هذه الحكومة هو إنجاز الاتفاق النقدي المعقود مع فرنسا وعرضه على محلس الشعب، ومعالجة النتائج الكارثية لخسارة فلسطين وموضوع الخبز. وكما سوف نرى، فإن كل حكومات العظم كانت تركز على الإصلاحات الاقتصادية والتنمية واستقلال سورية وتكريس مفهوم سورية بعتباره وطن السوريين، وليس جزءا من وطن آخر.
على أن العظم لم ينتبه وهو يوجه كل جهده إلى إصلاح النقد إلى الخطر القادم من خاصرته، وهو خطر الجيش. ففي صباح أحد ايام آذار 1949، قرر شكري القوتلي أن يحضر تجربة الذخائر التي اشتراها الجيش مؤخرا، في سهل المزة ، وصحبه في ذلك خالد العظم رئيس الوزراء ووزير الدفاع. واستقبلها رئيس اركان الجيش الزعيم حسني الزعيم، فقط ليفاجاالرئيسان بأن الذخائر فاسدة، وأن الطعام الذي كان يقدم للجنود كان فاسدا أيضا. وهنا ارتكب الرئيسان خطيئتين بحق العسكر: فأما القولي فقد صفع عقيدا بالجيش؛ وأما العظم فقد أحال العقيد البستاني الذي كان مسؤولا عن المشتريات في الجيش إلى المحاكمة. وكانت المحاكمة سوف تبين أن العقيد البستاني لم يكن لوحده في الصفقات الفاسدة، فتحرك الجيش بقيادة الزعيم البرازي ليستولي على الحكم ويعلن البيان رقم 1، والذي بدأ عهدا من الانقلابات العسكرية السورية التي وأدت الديموقراطية السورية في مهدها.
وفي حوالي الساعة الثانية من صبيحة يوم 30 آذار، اقتحمت ثلة من الجنود منزل خالدالعظم، واقتاداه بقوة السلاح إلى سجن المزة، حافي القدمين، حاسر الرأس، بدون نظارتيه اللتين كان لا يستطيع الرؤية بدونهما، وليس عليه سوى بيجامته التي كان ينام فيها. واقتاده العسكر إلى سجن المزة حيث وضع في زنزانة، ترابية مستطيلة، ضيقة، فيها فتحة لمرحاض تنبعث منها رائحة كريهة. وقال العظم لنفسه:” إذن هذه هي السلول.” لم يكن العظم قد أمر بسجن أحد في حياته، وعندما كان بإمكانه كان أقرب إلى العفو، وكان هو الذي سوف يعفو بعد سنوات عن عدنان لأتاسي فيخفف حكم الإعدام عنه. وشعر العظم بالبرد الشديد والوحدة والخوف والعطش، وافتقد ظارته التي لا يستطيع الرؤية بدونها. ثم تذكر الحدود الجنوبية والجيش الإسرائيلي ومشروع الهدنة ومطامع الهاشميين في سورية، فوقع في بلبلة وخوف على نفسه وعلى بلده. ولم يكن العظم من النوع الذي يتمتع بقوة الاعصاب في حالات ماثلة، لذلك عندما زاره اثنان من أقربه انخرط في بكاء مرير. وفي اليوم التالي نقل العظم إلى المستشفى العسكري حيث وضع مع الرئيس في غرفة واحدة، ثم عزل عنه وغيرت نوعية الطعام المقدمة إليه ونزعت منه الكتب التي أعطيها بعد أن ردوا نظارته إليه، فأضرب عن الطعام حتى أعيدت إليه أشياؤه. وفي هذا الوقت كان القوتلي يبدي بسالة عجيبة في رفضه الاستقالة وفي كيله سيلا من الشتائم والسباب على قائد الانقلاب ومن شايعه. وفي 7 نيسان وافق على تقديم استقالته، فكتب سطرا واحدا: “أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة السورية.” وهو سوف يعيد البكاء مرة ثانية عندما سوف يتعقل مرة ثانية، بعد ثلاث عشرة سنة، إثر انقلاب 28 آذار 1962.
هل كانت الأسلحة والأغذية الفاسدة هي السبب الوحيد وراء انقلاب الزعيم؟ أم أن هنالك أسباب أخرى من ولدنة السياسيين وتراجع الأداء لوطني وهزيمة العرب في فلسطين؟ ربما كان العاملان معا. بيد أن انقلاب الزعيم سوف يئد الديموقراطية السورية الوليدة غلى الأب. وحتى عودة الديموقراطية في الخمسينات لن يكون بمثل وهج لأربعينات، بسبب تدخل العسكر المستمر في أداء السياسيين.
أطيح بالزعيم، وانتخبت جمعية تسيسية فصاغت دستور 1950، وانتخب هاشم الأتاسي رئيسا للجمهورية وأراد رجلا مستقلا قادرا على قيادة البلاد سيسا واقتصاديا لإخراجها من دور العنف والركود التي مرت به، فلم يجد خيرا من خالد العظم. وشكل العظم بين 1950 و1951 وزارتين كانتا براي الكثيرين من أهم المراحل السياسية التي عززت استقلال سورية السياسي والاقتصادي. وفيهما قام العظم باستكمال سياسة الاصلاح النقدي وفصل الجمارك السورية-اللبنانية، واغلق الحدود مع لبنان، وبدأ ببناء مرفأ اللاذقية وسكة الحديد الحجازية وغيرها من المشاريع التي أعطت سورية وججها المستقل.
في أواخر عام 1949، تسلم خالد العظم رئاسة الحكومة في الجمهورية السورية. وكانت العلاقات مع الحكومة اللبنانية بين شد وجذب منذ حصول كلا البلدين على استقلاهما قبل ست سنوات. وسبب توتر العلاقات كان شعور السوريين بالغبن من هيمنة الرأسمال اللبناني على الاقتصاد في سورية ولبنان معا. وذلك بسبب الوحدة الجمركية بين البلدين. فقد كانت الجمارك المشتركة مرؤوسة دائما من قبل مدير لبناني، وكانت الحكومة اللبنانية ترفض تداول رئاسة الهيئة بين البلدين.
وغالبا ما كان المدير اللبناني يتجاهل مصلحة السوريين في عملية الاستيراد والتصدير. ولأن المرفأ المشترك كان في بيروت، ولأن سورية لم تكن تملك مرفأ مستقلا، كان اللبنانيون أقدر على التحكم بهذه العملية، التي غالبا ما تترك أثرها على اقتصاد الدولتين معا، خصوصا إذا أضفنا ذلك أن اللبنانيين كانوا يتمتعون بميزة حصرية الوكالات الأجنبية لكل من سورية ولبنان.
وارتأى العظم أن من العدل أن يتم تعميم الخير على الشعبين السوري واللبناني، طالما أنهما يملكان إدارة جمركية موحدة، وطالما أن البرجوازية اللبنانية تلعب دورها بالأصالة عن نفسها والنيابة عن شقيقتها السورية.
ومن هنا كانت فكرة العظم قيام وحدة اقتصادية بين البلدين. ولتحقيق ذلك طلب من وزير اقتصاده معروف الدواليبي أن يجتمع مع قادة الرأي الاقتصادي في سورية لأخذ رأيهم. وبالفعل اجتمع الدواليبي مع خبراء اقتصاديين ومع ممثلي الغرف التجارية والصناعية والتجارية لمدة أيام في جامعة دمشق. ووصل الجميع إلى رأي موحد: إما وحدة اقتصادية ونقدية يخلص لها البلدان وإما انفصال عاجل يكون فيه كل من البلدين حرا في اتباع السبيل الذي يناسبه.
وقرر العظم أن يرسل إلى الحكومة اللبنانية مذكرة يعرض عليها فيها رأي حكومته في مسألة الوحدة الاقتصادية ويطلب من نظيره اللبناني، رياض الصلح، الرد في مهلة معقولة. وشرح العظم في مذكرته أن من أسباب الضعف والاضطراب اللذين منيت بهما المصالح المشتركة ارتكازها على اتفاقات مؤقتة قصيرة الأمد، محدودة النطاق وسعي الحكومتين عند أي خلاف إلى حلول مؤقتة جزئية للقضايا الأساسية والطارئة.
وجاء رد الرئيس الصلح سلبيا، ملاحظا أن حكومته لا يسعها التسليم بمحتوى المذكرة السورية التي وصفها بأنها اتخذت شكل “إنذار.” وفي اليوم التالي أصدرت حكومة العظم مرسوما بفصل الجمارك السورية عن اللبنانية وتأسيس مديرية عامة للجمارك مرتبطة بوزارة المالية.
ولتعزيز الموقف السوري، قرت حكومة العظم أيضا إصلاحات نقدية جذرية، بتطبيق أنظمة القطع على العمليات التجارية بين سورية ولبنان، وعدم السماح بتدفق القطع السوري إلى لبنان لتبديله بالليرة اللبنانية لتسديد قيمة البضائع التي تشتريها سورية. وهو ما كان أدى إلى هبوط الليرة السورية وارتفاع قيمة الليرة اللبنانية.
ثم قررت الحكومة منع نقل البضائع من لبنان إلى سورية باستثناء البضائع العابرة (الترانزيت) والبضائع المعفاة من الجمارك والمحروقات. وصدر ذلك بالمرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1950.
وكانت أول خطوة قام بها الرئيس العظم بعد توقيع الرئيس هاشم الأتاسي على المرسوم هو لقاء السيد رشدي الكيخيا، رئيس مجلس النواب لإطلاعه على المرسوم، ومن ثم لقاء الصحافيين وإبلاغهم نص القرار ومضمونه وإجراؤه حوارا مطولا معهم حول ذلك، فلقي منهم دعما غير مسبوق.
يقول العظم في مذكراته إن تأييد هذا القرار “كان شاملا جميع أنحاء البلاد وجميع عناصرها.” وهو يعزو سبب الارتياح إلى أن الشراكة الجمركية كانت قد “عادت بالخسارة على البلاد،” واستبشر السوريون بإلغاء الوساطة التجارية اللبنانية في جميع المستوردات السورية من الخارج. وتحمس الصناعيون لمنع مزاحمة الصناعة اللبنانية لمنتجاتهم، وهي مزاحمة كادت تؤدي إلى إفلاس بعضهم.
كان قرار العظم ضربة كبيرة للاقتصاد اللبناني ولمكانة الرئيس الصلح السياسية. غير أن العظم لم يكن يريد ذلك، خاصة وأنه كان دائما معجبا بتوجه الصلح القومي. لذلك حين أرسل الأخير وسيطا يطلب من خلاله أن يقوم العظم بزيارته في بيروت، سارع المنتصر السوري إلى تلبية الطلب وزار بيروت وتحدث مع الرئيسين الخوري والصلح، وأكد لهما أنه قدم إلى بيروت “لكي يعلم الرأي العام السوري واللبناني والعربي أننا وإن اختلفنا في الشؤون الاقتصادية فإن اتحادنا في الشؤون السياسية العربية وطيد لا تزعزع.”
ويبدو الآن أن قرار العظم حقق منافع لا تحصى للسورين عموما، فبدأ السوريون، حتى اللذين لم يتعاطوا التجارة في سابق حياتهم، يبذلون جهدا واسعا في التجارة الدولية، وراحوا، وفقا لسجلات غرف التجارة السورية، يستحصلون على وكالات الشركات الأجنبية في سورية، ويستجلبون البضائع الأجنبية إلى سورية مباشرة بعد أن كانت تأتي عن طريق التاجر اللبناني حصرا.
يقول العظم في مذكراته إن أهل دمشق حفظوا له “في قلوبهم منة لتحقيقي ما عاد عليهم جميعا بالوفر والربح والعمل.” ويبد أن الدمشقيين أظهروا له هذه المنة في الانتخابين التشريعيين في 1954 و1961، حين فاز العظم بأعلى نسبة من الأصوات، وتفوق على مرشحي الحزبين الكبيرين آنذاك: الشعب والوطني، وجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب التقدمية كحزب البعث والشيوعي.
يمكننا هنا أن نميز دور رجل الدولة الليبرالي القوي بسلسلة من السمات. أولا: كان من المؤكد أن قرار الرئيس العظم يومذاك قرارا اقتصاديا محضا، وليس ردة فعل سياسية على موقف سياسي قامت به الحكومة اللبنانية أو الشعب اللبناني.
ثانيا: حين دار بخلد الرئيس العظم فكرة إنهاء الوحدة الجمركية، كان أول شيء فعله أن استدعى عددا كبيرا من قادة الرأي الاقتصادي ليشاورهم في الأمر، ويرى إلى حسنات مثل هذا القرار وسلبياته على سورية والسوريين عموما.
ثالثا: تم دراسة القرار في مجلس الوزراء، ثم صادق عليه رئيس الدولة، وتم إطلاع رئيس البرلمان عليه.
رابعا: سارع رئيس الحكومة إلى الاتصال بالصحفيين لإبلاغهم بالقرار وشرح أبعاده لهم، ولم يتركهم يتحزرون فيما إذا كان هنالك قرار سياسي بهذا الخصوص أم أن الأمور خطوة مزاجية اتخذتها جهة ما.
خامسا: سارع العظم إلى زيارة بيروت واللقاء مع الرئيسين الخوري والصلح لإيضاح الأمر ولإفهام الرأي العام في سورية ولبنان أن الموضوع اقتصادي بحت وليس له أي بعد سياسي. وكرر الشيئ نفسه في اجتماع الجامعة العربية في القاهرة.
سادسا: أغلقت الحدود في وجه الشاحنات اللبنانية التي كانت متجهة للتفريغ في سورية فقط ولم تمنع الشاحنات العابرة (الترانزيت.)
وأهم من كل ذلك، فقد كانت خطة العظم خطة اقتصادية متشابكة ومتكاملة. ولقد ارتبطت قضية الفضل الجمركي مع ثورتين حقيقيتين قام بهما رئيس الحكومة، هما: إصلاح النقد وإنشاء مرفأ اللاذقية.
على صعيد إصلاح النقد،أصدرت حكومة خالد العظم سلسلة من القرارات والتشريعات كانت في جملتها تهدف إلى إلغاء حق المصرف السوري في إصدار النقد وحصر هذا الحق ملكا للدولة السورية وحدها، عبر مؤسسة سورية مائة بالمائة أطلق عليها اسم “مؤسسة إصدار النقد السوري.” وأدت ثورة العظم النقدية إلى رفع قيمة الليرة السورية فصارت تساوي أكثر قليلا من 405 ميلليغراما من الذهب.
وأما إنشاء المرفأ فكان واحدا من أهم المشاريع الاقتصادية والعمرانية التي ينبغي أن ترتبط باسم هذا الرجل المتفرد. لقد رأى العظم أن الفائض الممكن تصديره من الناتج الزراعي والصناعي السوري متمركز في شمال وشرق البلد أكثر من جنوبه وغربه. فإذا افترضنا أن حلب هي مركز تخزين للمواد المراد تصديرها، فإن حسبة صغيرة تخبرنا أن مرفأ في اللاذقية سوف يختصر أكثر من نصف المسافة إلى بيروت. فإذا أضيف ذلك إلى ضرورة أن يكون لسورية مرفأ تسيطر به على سياسة التصدير والاستيراد من أجل استقلال اقتصادي حيقي، علمنا كيف كان العظم يربط بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، في نسيج فريد في تاريخ سورية.
خسارة سورية:
هل قامت الوحدة بين سورية ومصر بسبب خالد العظم؟ يبدو السؤال للوهلة الأولى ساذجا. فالقوميون يرون أن الوحدة تحققت لأنها مطلب جماهيري للشعبين العربيين في البلدين. أما الماركسيون فقد طوروا نظرية مفادها أن البورجوازيةالسورية سارعت برمي نفسها في أحضان الرئيس المصري جمال عبد الناصر خوفا من تزايد خطر الشيوعية في سورية. على لأن ثمة من يرى أن سبب الوحدة كان خالد العظم، وبتحديد أكثر كان مفهوم سورية الذي رفعه العظم وناضل من جله، وكان من الممكن أن يحققه لو أتيح له مزيد من الوقت.
في الوقت الذي كانت القوى الإقليمية والدولية تتصارع على جذب سورية كل إلى طرفه. وفي الوقت الذي كان حزب الشعب والرأسمالية الحلبية والهاشميون يحاولون تحقيق وحدة سورية مع العراق المدعوم بريطانيا، وكان الحزب الوطني والرأسمالية الدمشقية تقف في وجه ذلك التيار وتشد سورية أكثر باتجاه الحلف المصري-السعودي، المدعوم أمريكيا، ظهر خالد العظم بمفهوم سورية، باعتبارها وطنا للسوريين وباعتبارها بلدا مستقلا كامل السيادة. ومن أجل ذلك كان هم العظم هو تحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلد بعد الاستقلال السياسي. من هنا نفهم استراتيجية العظم في العلاقات مع لبنان والسعودية وفرنسا، وأهم من كل ذلم الاتحاد السوفياتي، الذي رأى فيه إمكاني لتنمية اقتصادية حقيقية، تؤدي غلىزيادة الدخل القومي زيادة تجعله قادرا على مواجهة النفقات وإيجاد موارد جديدة للدولة. ومن هنا نفهم حرصه على بناء مرفأ اللاذقية والسكة الحديدية والإصلاح النقدي.
هذه الرؤية كانت خطرا على جميع اللاعبين الأساسيين في الداخل والخارج. فالقوميون والبعثيون والاشتراكيون العرب كان هاجسهم تحقيق الوحدة العربية الكبرى؛ والهاشميون كان يريدون وحدة مع العراق والأردن؛ والقوميون السوريون كان طموحهم وحدة الأمة السورية في سورية الكبرى؛ أما العسكر والمرتزقة من السياسيين وقادة الانقلابات فكانوا يميلون مع التيار ومع مصالحهم الخاصة حيثما مال. على أن العظم لم يكن ليشكل خطرا جديا كبيرا، رغم الشعبية التي يتماع بها في دمشق، لأنه كان دائما لاعبا فردا. الخطر جاء عندما قرر خالد العظم تشكيل حزب سياسي يضم فئات واسعة من البورجوازية المدينية الإسلامية-المسيحية على امتداد سورية. وكانت المبادئ العمة للحزب تقوم على “التقدمية المتئدة والتطور الاجتماعي، الذي يضمن رخاء الطبقات (…) عن طريق وضع مشاريع زراعية وصناعية وعمرانية ضخمة تزيد في الانتاج القومي.” أما الأشخاص الذين كانوا سوف يؤسسون نواة هذا الحزب فهم رجال لا يرقى إليهم الشك من نحية كفاءتهم ونزاهتهم وحسهم الوطني، من مثل هاني السباعي وجورج شلهوب ورئيف ملقي وأسعد المحاسني وهاني الريس.
هنا تحول الخطر الفردي ليغدو خطرا جماعيا قادما من حزب سياسي منظم قائم على مبادئ وقواعد وبرامج محددة ويقوده إضافة إلى العظم حفنة من أهم رجالات سورية في ذلك الوقت. وهذا هو الخطر الذي دفع برجل كشكري القوتلي ومن يمثلهم من فئات اجتماعية واسعة يقبلون بوحدة مستعجلة مع مصر. وهكذا، وبدون أن يقصد، دفع خالد العظم الذي كان يعمل من أجل مفهوم سورية كوطن للسوريين إلى، إلى خسارة سورية كوطن.
ولم يأل العظم جهدا في بذل كل ممكن للحفاظ على كيان سورية في إطار اتحاد فدرالي، وطالب ببقاء الأحزاب وبقاء دولة الوحدة دولة برلمانية تحد من صلاحيات الرئيس، على الطريقة السورية، لكنه جهوده العقلانية ذهبت سدى تحت أقدام البعثيين والشعبيين والعسكرالذين طغت عواطفهم على عقلهم فارتموا في أحضان الرئيس الأسمر الشاب، فقط ليتنفضوا هم أنفسهم على نظام الوحدة، بعد 38 شهرا، أمضاها العظم في بيته، منكفئا ومكتئبا وشبه سجين، حيث لم يسمح له بمغادرة سورية حتى يوم 27 أيلول، 1961. ويصف العظم السنة الأخيرة من عهد الوحدة بشكل خاص بأنه كان “كابوسا ثقيلا.” ويضيف أن موظفي المخابرات كانوا “يختلقون وسائل الضغط المعنوي علي. فتارة يحولون دون دخول أصدقائي إلى داري، أو يرسلون من يهددهم ويخيفهم من الاستمرار على ذلك. وتارة كانوا يبعثون بدراجة نارية يركبها إثنان من عملائهم، أو بسيارة محشوة برجالهم، لتلاحق سيارتي وتلامسها، حتى تكاد السيارتان تتصادمان.” بيد أن أسوأ ما تعرضله خالد العظم عندما حجزت السلطات على منزله وأثاث بيته، فاشتد الخناق عليه، لدرجة أنه عندما سمح له أخيرا بالذهاب إلى لبنان، شعر كأنه خلق من جديد، وفق تعبيره.وقال لنفسه:” لا شيئ أعز من الحرية. ولو كان المرأ فقيرا معدما، (فإنه) يكفيه غنى أن يكون حرا.”
ونام تلك الليلة نوما هادئا ومديدا، ليصحو في اليوم التالي على خبر فصل الوحدة بين سورية ومصر. انهمرت الدموع من عينيه، كما يقول عند سماعه النشيد السوري الذي “حرمنا من سماعه ثلاث سنوات.” وحزم حقائبه ليعود إلى بلده، ولكن ذلك ان بالأمر اليسير. فلسبب ما ارتأى سادة دمشق الجدد وحكومة السيد مأمون الكزبري أن عودته ليست ملائمة. وكان ذلك أمرا عجبا، فالعظم كان الوحيد الذي تحفظ على الوحدة وانتقدها ولم يستلم ي منصب سياسي طوال عهدها. على أن المنع لم يطل أكثر من يام، سمح له بعدها بالعودة في الوقتالمناسب ليشارك في الاجتماع الشهير لذي عقده السياسيون في منزل أحمد الشرباتي. كان هذا الاجتماع التوتر هوالذي حسم أمر العهد الجديد. ولقد حضره أهم السياسيين عصرذاك، من أقصى اليمين غلى أقصى اليسار. ولعب العظم دورا مهما في الحصول على الإجماع المطلوب لتأييد استقلال سورية وإعادة الحكم إلى المدنيين.
بيدأن العسكريين الذين هيمنوا على الوضع بعد الانفصال لم يكونوا فعلا يرغبون بالعودة غلى ثكناتهم والإفساح فيالمجال أمام السياسيين ليحكموا البلد. ولذلك كان أهم أعداؤه هو الرجل الذي كان يمثل أهم مدني قادر على حكم سورية في ذلك الوقت. والحق أن علاقة العظم والجيش كانت دائما متوترة، فلا هو أحب العسكر ولا هم أحبوه. ومنذ أول صدام له عندما كان وزيرا للدفاع مع حسني الزعيم، لم يعرف يوما لم ينغص العسكريون فيه حياته.
ولكن حتى العسكر لم يستطيعوا هزيمته في اللعبة الديموقراطية رغم التدخلات الكبيرة التي قام بها الجيش في انتخابات 1962. وحصل العظم مجددا على أعلى نسبة من أصوات الدمشقيين (قرابة الخمسة وثلاثين ألف صوتا.) وبذلك كان محتما تكليفه بتشكيل حكومته الخامسة التي انتهت كما انتهت سابقاتها بحدث كبير هو انقلاب 8 آذار، 1963. وكانت خطته الأساس في حكومته تلك “أن تترافق الديموقراطية السياسية بالديموقراطية الاجتماعية.” وبالفعل، عملت حكومة العظم على البدء بإرساء الجناحين التي لا يمكن للديموقراطية أن طير إلا بهما. وألغى العظم الأحكام العرفية التي كان الجيش والرئيس ناظم القدسي قد أعلناها في آذار 1962، الأمر الذي لم يرق للرئيس. وبعد انقلاب 1963، لامه البعض أن إلغءه قانون الطوارئ هو الذي سهل للناصريين والبعثيين القيام بالانقلاب. غير أن العظم ظل حتى النفس الأخير مؤمنا بالديموقراطية، ويتهم الجيش والرجعية لسياسية والولايات المتحدة بأن احدا منهم لا يحبذ نظاما ديموقراطيا برلمانيا في سورية. وهو يقول إنأمريكا “تستقبل بترحاب مخجل كل دكتاتور يقلب النظام البرلماني ويقيم محله نظاما فرديا تتعايش معه أمريكا وتضمن مصالحها بواسطته.”
على أن الخير لا ينتصر دائما. ففي صباح يوم ربيعي جميل، كان عليه أن يغادر بلده مرة أخرى، ولكن هذه المرة إلى الأبد. وهو أبد لن يطول، إذ لم يمر عليه عامان في المنفى حتى فارق الروح وعومفلس، تاركا زوجته تعيش على إحسان أصدقائه القدامى حتى وفاتها.
الإنسان (خاتمة):
الفن:
كان خالد العظم ليبراليا في السياسة والاقتصاد محافظا في الفن وبعض الجوانب الأخرى. فهو في الموسيقى متحمس لغناء سلامة حجازي الذي يتذكره منذ أيام طفولته، ويرى أن سيد درويش الذي يفخر المصريون به قد شوه الموسيقى العربية الراقية. ولكنه يشكر للسنباطي وعبد الوهاب وأم كلثوم وأحمد رامي أنهم أعادوا للأغنية العربية مجدها إلى أن جاء من يسميهم “المغنين الجدد الذين اكتسبوا شهرة لا يستحقونها من أمثال فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ ومحرم فؤاد.” ويرى العظم أن العامة قد تعلقت بهذه الأغاني الجديدة، لا لأنها تعبر عن روح موسيقية رفيعة، بل “لأن في مقدور اي من الناس أن يفتح فمه ويتلفظ كلمات أغاني عبد الحليم حافظ مثلا، مع شيئ بسيط من النغم ليشبه إليه أنه من عبقريته، ناهيك بالدعاية الواسعة التي ترافق مطربينا الجدد في الصحف والإذاعة والتلفزيون، والوله والإعجاب حتى العبادة، تظهرها فتياتنا الكواعب نحو المغني الشاب أو يظهرها شبابنا الصاعد نحو المغنية الفتية.”
ورأي العظم في الأغنية العربية الكلاسيكية يماثل رأيه في الموسيقى الكلاسيكية العالمية التي يرى أنها تتراجع بقوة لصالح موسيقى البوب الصاخبة السريعة.وهو يربط ذلك بالسرعة التي صارت سمة العصر.
وكان العظم، رغم ليبراليته السياسية والاقتصادية متدينا في أعماقه، وإن كان تدينه هو ذلك النوع من التدين الذي عرفت به سورية على مر العصور. التدين العميق،الهادئ، المقرون بالسكينة والهدوء والذي لا ينكر على الآخرين دياناتهم، ولا يدفع أتباعه للتبشير والتكفير،وإنما يدفعهم لخوض علاقة حميمة خاصة مع خالقهم. على أن العظم لم يكن يحمل من الإجلال لرجال الدين مقدار ما كان يحمل للدين نفسه، ولطالما ضحك من نهمهم وحبهم للطعام ما ونوعا. وأهم من ذلك أنه لم يلجأ مرة للدين يستخدمه أداة في تحقيق غاياته السياسية.
وكان له رأي متقدم بالمرأة، رغم تجربته الخاصة مع زوجته الثانية. وهو يشيد بالمكانة التي وصلت إليها و “اشتراكها مع الرجل في محيطه وعمله ومورد رزقه، وتوليها أمر جمعيات خيرية مختلفة الأهداف، وانتسابها إلى الجامعة بمختلف كلياتها، وممارستها المحاماة والطب والتجارة والموارد العامة، وغير ذلك من مظاهر التطور الذي كاد ويصل السيدة العربية إلى سوية السيدة الأوروبية أو الأمريكية.” بيد أنه يأسف لأن هذه المظاهر محصورة في بعض الأحياءالراقيةمن المدن الكبرى ويعبر عن أمله بأن يشمل هذا التقدم النسوة في المناطق الأخرى.
ولسووء الحظ، لم يكن العظم سعيدا في حياته العائلية. وقصته مع زوجته الثانية، فلها في حياته وقع مر وغصة دائمة. فبعد زواج هانئ، لكن قصير، مع زوجته الأولى السيدة سنية مردم بك، والذي لم يكمل العام، عاش العظم فترة طويلة عازبا عن الزواج، حتى وقع على ما يبدو بغرام سيدة جميلة هي السيدة ليلى الرفاعي، التي لا يأتي العظم على ذكرها مطلقا، على عكس ذكره زواجه الأول بالتفصيل. ولكن إذا صدقنا السيد أكرم حسن العلبي في كتابه “خالد العظم آخر حكام دمشق من آل العظم،” فإن السيدة ليلى “لم تجد عند خالدالعظم ما كانت تريده، فعكفت على الشراب والقمار في دارها في أبي رمامنة التي وهبها لها الزوج الولهان، ثم باعتها بعد وفاته وصرفت ثمنا على موائد القمار. وكانت في ذلك صويحباتها في مصر: الملكة نازلي والسيدة حرم النحاس باشا.”
وبغض النظر عن رواية السيد العلبي فإن إغفال العظم الكامل لزوجه الثانية دليل على أنه لم يكن سعيدا جدا بزواجه منها. ويبدو مؤكدا أن الزوجين عاشا فترة طويلة بشكل منفصل، حيث كان العظم يسكن معظم وقته في دارته في دمر. وفي رواية للعميد مطيع السمان الذي كام يرئس حرس رئاسةالوزراء في ذلك الوقت، إن صديق العم السيد فؤاد محاسن جاء العظم في سنة 1955، إبان المعركة الانتخابية الكبرى بينه وبين شكري القوتلي، وأخبره أن السوريين لايقبلون أن تكون السيدة السورية الأولى سيدة كالسيد ليلى، وافق الجميع على ضرورة الطلاق. ويروي السمان أن القاضي جاء بالفعل ولكن العظم، بما يحمله من نبل وسعة أخلاق، لم يقدم على أبغض الحلال.
كان ذلك هو خالد العظم، وتلك أخلاقه. ما كان قادرا على أن يظلم أحدا، وما كان يكره شيئا كرهه الظلم، والمحاباة والتملق. كان شديد الاستقامة إلى حد الضجر، ولم يعرف عنه أنه استفاد يوما من منصب تبوأ. بل إن أهله وأصحابه كانوا يعرفون إنه لن يقدم لهم أي خدمة، خاصة. وعندما كان وزيرا للعدل في حكومة نصوح البخاري رفض أن يصدر عفواعن ابن عم له. ومشكلته الكبيرة مع زوجته الثانية أنه كان يرفض وساطتها لتعيين أقاربها في ووظائف عامة. وكان يكره الظهور أمام الناس في المقام الأول، ويفضل ألا يكون محط الأنظار. وحتى في حملاته الانتخابية، لم تسمح له ثقافته وأخلاقه أن يريق ماء وجهه للناخبين ويغدق لهم الوعود فقط لينسى كل ذلك بعد أن يفوز بالنيابة. ومع ذلك فقد كان يفوز [أعلى نسبة من أصوات الدمشقيين، دون أن يكون له حزب يدعمه. وقد يظن الذي لا يعرفه أن في سلوكه ترفعا وتعاليا، دون أن يدرك أن ذلك خجل أكثر منه كبرياء.
هذه الشخصية الرفيعة جعلت من العظم رجلا ديموقراطيا بامتياز كما جعلت منه رجل دولة بامتياز. كان يؤمن بالتطور التدريجي أكثر من إيمانه بالثورة، ويربط الديموقراطية السياسية بالديموقراطية الاجتماعية، ويكره تدخل الجيش بالسياسة. وكان رجلا وسطا، يرى أنه ليس هناك “نظام هو المثل الأعلى، وليس هنالك نظام سيء من جميع الوجوه. فمن يندد بالشيوعية ويقذفها بأتعس الوصمات هو جائر، ومن يتهم الراسمالية بأنها سبب تعاسة البشر مبالغ. فالحقيقة هي بين اليمين واليسار، في نقطة وسط تقرب من هذا المحور أو ذاك بنسبة ما يحتويه كيان الأمة من عوامل” مختلفة ومتنوعة. وببهذه الآراء العميقة والموضوعية، يرسم خالد العظم سمات لشخصية سياسية لم يجد الزمان كثيرا بمثلها على سورية الجميلة.