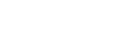*ميثاق: تقارير ومتابعات
ترجمة الميثاق-المصدر”New Lines Magazine“
في آذار/مارس 2020، وبعد حملة عسكرية مدمرة استمرت 10 أشهر، سيطرت الميليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري السابق – تحت غطاء جوي وتوجيه روسي – على العديد من المدن والبلدات والقرى في شمال غرب سوريا. أدى الهجوم إلى نزوح أكثر من مليون مدني سوري، تاركاً السكان المتبقين محشورين في شريط ضيق من الأرض أصبح نقطة محورية للدعاية الكاذبة من النظام وحلفائه.
وأثارت الحملة أزمة إنسانية حادة وواسعة النطاق، مع حاجة ماسة إلى السكن والمأوى مصحوبة بنقص في الغذاء ومياه الشرب وفرص العمل. وأدت التداعيات إلى موجات من الهجرة إلى البلدان المجاورة وأوروبا، مما أدى إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية القائمة على الدول المضيفة.
أدت سنوات من الصعوبات التي لا هوادة فيها، إلى جانب انهيار الأمل في حل سياسي من شأنه أن يخفف من المعاناة، إلى تصاعد الإحباط بين سكان شمال غرب سوريا. تحول هذا الإحباط إلى ضغط مكثف على الفصائل المحلية لبدء عمل عسكري لتحرير المناطق المحتلة والسماح للنازحين بالعودة. ونشأت حركات احتجاجية، هددت بزعزعة استقرار الإدارة في محافظة إدلب، وغذت شعوراً عاماً بخيبة الأمل بين الفصائل هناك.
في مواجهة هذا الاضطرابات، اختارت الفصائل في شمال غرب سوريا تنحية الخلافات السابقة جانباً، والتعلم من أخطاء حملة 2019، وتبني استراتيجيات جديدة وأكثر توحيداً. وكانت النتيجة إنشاء قيادة “عمليات الفتح المبين“، وهي تحالف من الفصائل النشطة التي تشكل بعد حملة 2019. وجد التحالف نفسه مقيداً بالجغرافيا والحدود الصعبة لشمال غرب سوريا وركز في البداية على التدابير الدفاعية للحفاظ على ما تبقى.
وجهت الحرب في أوكرانيا ضربة قوية للغطرسة الروسية، حيث عملت كرافعة غير متوقعة ساعدت على إخراج الثورة السورية من المستنقع الذي غرقت فيه. مع استمرار الحرب وتصاعد الخسائر الروسية، أثر الضغط على موسكو سلباً على قدرتها على إعادة تدريب وإعادة تأهيل فلول الجيش السوري البائد. وقد أدى ذلك إلى صراع بارد ولكن متصاعد بين إيران وروسيا حول السيطرة والنفوذ داخل الأجهزة العسكرية والأمنية المتبقية للنظام. أدى هذا الصراع الداخلي على السلطة إلى تآكل القدرات العسكرية للنظام، حيث أصبح متورطاً في ولاءات متنافسة وأجندات متضاربة.
العامل الثاني غير المتوقع الذي استفاد منه الثورة السورية هو تكثيف الضربات الإسرائيلية التي استهدفت القوات الإيرانية والميليشيات المتحالفة معها في سوريا. وقد أضعفت هذه الهجمات الهياكل العسكرية والأمنية الهشة أصلاً للنظام وكشفت عن التواطؤ بين بعض شخصيات النظام وإسرائيل ضد إيران. أدت هذه الديناميكية إلى تهميش الشخصيات البارزة، بما في ذلك الضباط الرئيسيين، مما خلق فراغاً في السلطة وتسريع تفكك النظام.
وجاءت نقطة التحول مع استهداف إسرائيل المباشر لحزب الله والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران، والتي تم دمجها أو التعاون معها. شكلت هذه الميليشيات العمود الفقري لقوات المشاة والوحدات العسكرية المتخصصة التابعة للنظام. وقد أدى تورطهم في تصاعد التوترات في لبنان إلى تحويل تركيزهم، مما أدى فعلياً إلى تحييد عنصر حاسم من القدرات العسكرية للنظام في لحظة حاسمة.
خضع الشعب السوري لتحول ملحوظ في فترة قصيرة، حيث انتقل من أعماق القمع–التي تميزت بخوف مرضي مشلول-إلى شعور بالإمكانية بدا فضفاضاً ومائعاً، وفي بعض الأحيان فوضويا. أصبحت هذه الفترة تجربة مكثفة، أقرب إلى التعلم من خلال التجربة والخطأ. وبينما استهلكت هذه العملية قدراً كبيراً من الوقت والموارد والفرص، فقد أثبتت أيضاً أنها لا تقدر بثمن في تصفية الأفكار غير الفعالة والتحقق من صحة النهج المنطقية والواقعية.
*مواد ذات صلة:
كان هذا التطور يشبه مراحل النمو البشري: طفولة بريئة، تليها مراهقة مضطربة، وفي النهاية مرحلة من النضج والتوازن. ويتضح هذا التقدم عند مقارنة الأداء العسكري والسياسي والسلوكي والأمني والإعلامي لفصائل النصر الواضح – التي أعيد تنظيمها لاحقاً لتصبح مديرية العمليات العسكرية – مع أداء قيادات العمليات السابقة. يؤكد التناقض الصارخ بين العقلية البراغماتية والمنضبطة اليوم وعقلية الماضي المفككة على الدروس المستفادة من المشقة والمثابرة.
في منتصف عام 2020، بدأت هيئة تحرير الشام، أقوى فصيل في العملية، تحولاً كبيراً في خطابها وسلوكها. أدى هذا التحول إلى انشقاق العديد من الكوادر والقوات، التي اتهمت هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع بالانحراف والخيانة. وعلى الرغم من رد الفعل العنيف، سعت هيئة تحرير الشام إلى التقارب مع الجماعات والشخصيات التي كانت معادية لها أو معارضة لها في السابق. وعملت على بناء تحالفات مع الفصائل العسكرية في ريف حلب الشمالي، مع تأكيد وجودها في المنطقة.
حافظت الحكومة التركية على سياسة واضحة تعطي الأولوية للقواعد العسكرية، على النقيض من نفوذ هيئة تحرير الشام المتزايد في ريف حلب الشمالي. بالإضافة إلى ذلك، كثفت الحكومة المدنية التي ساعدت هيئة تحرير الشام في تأسيسها في عام 2018 – حكومة الإنقاذ – أنشطتها. بدأت تقارير إعلامية في الظهور حول تعاون هيئة تحرير الشام مع الكيانات الغربية في قضايا مثل مكافحة الإرهاب (لا سيما ضد تنظيم الدولة الإسلامية) ومكافحة الجريمة المنظمة والتنسيق ضد الخصوم المشتركين.
بحلول أوائل عام 2023، عززت “الفتح المبين” اتصالاتها وتخطيطها الاستراتيجي، ودمجت فصائل ذات شعبية كبيرة وأهمية تاريخية، مثل أحرار الشام وجيش العزة. تم تحديد تحرير حلب، إلى جانب استعادة المناطق التي فقدتها في الحملة العسكرية الأخيرة، كهدف استراتيجي لعملية عسكرية واسعة النطاق قادمة. هدفت هذه العملية إلى وضع مرحلة جديدة في الثورة السورية.
خلال معركة التحرير، واجهت قوات النصر الواضح تحديات كبيرة، داخلية وخارجية. داخليًا، كانت إحدى أبرز الأزمات ما يسمى بـ “قضية العملاء” داخل هيئة تحرير الشام. بناءً على معلومات مضللة يُزعم أنها قدمتها وكالة استخبارات خارجية، اعتقلت أجهزة الأمن التابعة لهيئة تحرير الشام مئات من كوادرها العسكرية، متهمة إياهم بالتعاون مع روسيا والنظام السوري. ورافقت هذه الاعتقالات حالات اختفاء قسري وتعذيب شديد وترهيب واسع النطاق.
ومع استمرار القضية، ازداد عدد المتورطين، بمن فيهم شخصيات مؤثرة مثل “أبو ماريا القحطاني/ فيديو“، الرجل الثاني في التنظيم في ذلك الوقت. تصاعد الاستياء داخل الجناح العسكري، مع بقاء بعض الفصائل على شفا التمرد. وتفاقم الوضع عندما انشق أحد كبار القادة أبو أحمد زكور وهدد بفضح ما وصفه بجرائم قيادة هيئة تحرير الشام، بما في ذلك رئيس أمنها.

- في نهاية المطاف، تدخل زعيم التنظيم بشكل مباشر لحل الأزمة، والحد من انتهاكات قوات الأمن واستعادة درجة من التماسك. لعبت جاذبيته وثقة جنوده دوراً حاسماً في نزع فتيل التوترات وإعادة توجيه تركيز التنظيم نحو هدف تحرير حلب.
خارجياً، واجهت قيادة “الفتح المبين” مقاومة من تركيا، التي كانت حذرة من القوات العسكرية السورية التي تعمل بشكل مستقل عن نفوذها. نجحت تركيا في دمج العديد من فصائل الثورة السورية في ما يسمى بالجيش الوطني السوري، وتحويلها فعلياً إلى قوة أمنية خاصة تخدم أجندتها السياسية، بما في ذلك العمليات خارج الحدود السورية.
اقترنت هيمنة تركيا على الكثير من أسلحة الثورة السورية وسيطرتها على المؤسسات السياسية مثل الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة. شكل وجود النصر الواضح – وهي قوة عسكرية منضبطة ومنظمة لم تكن متحالفة بشكل مباشر مع تركيا – تحديا لاستراتيجية أنقرة لإدارة وجودها في سوريا. أدى ذلك إلى مواجهات علنية وسرية بين النصر الواضح والحكومة التركية.
بحلول أوائل أيلول/سبتمبر 2024، سيطرت معركة حلب على المناقشات في المنتديات الخاصة والعامة. كان السكان منقسمين بشكل حاد: أيدت أقلية المعركة، معتبرة أنها خطوة ضرورية نحو التحرير، بينما عارضتها الأغلبية، خوفاً من عواقب وخيمة إذا فشلت. وفي مقابلة هذا الأسبوع، قال الشرع، الرئيس السوري المؤقت حالياً، إن البعض يخشون إعادة تمثيل معاناة المدنيين في غزة.
كان المجتمع في حالة من القلق، مع تعطل العديد من الشركات وموجة من النزوح غير الرسمي من المدن والبلدات التي كان من المتوقع أن تصبح أهدافًا رئيسية. وزادت الضغوط المالية من التوتر، حيث تم فرض خصم يصل إلى 50٪ من الرواتب على الموظفين المدنيين والعسكريين في إدلب، مما أدى إلى تفاقم القلق بين السكان المحليين.
في البداية، رفض النظام السوري إمكانية المعركة بغطرسة وازدراء. ومع ذلك، مع تنامي التهديدات الإقليمية، وخاصة لحليفته إيران، أفسحت ثقة النظام المجال لارتفاع التوتر. كانت التحركات العسكرية بالقرب من خطوط النصر الواضح، والتي صنفها النظام على أنها خطيرة ومستمرة، بمثابة إشارة إلى تصعيد وشيك. لقد قدر النظام بشكل صحيح أن قواته وقاعدته الموالية ضعفت بشدة بسبب سنوات الحرب والخسائر المتزايدة.
إضافة إلى هذا الضغط كانت حالة من اليقظة العسكرية المستمرة، والتي كانت بمثابة حرب نفسية. كانت قوات النظام مرهقة ومحاصرة بمظالم داخلية ومضللة من خلال التقارير الاستخباراتية المتعلقة بتوقيت الهجوم الفعلي. نجح ذلك في خلق الارتباك وإضعاف معنويات قوات النظام.
وعلى الجبهة السياسية، لم تكن الحالة أقل تعقيداً. وجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية المهتمة بالقضية السورية، وأبرزها تركيا. في البداية، كانت تركيا حذرة من مثل هذه المعركة، بسبب العواقب الإنسانية والسياسية الوخيمة المحتملة التي يمكن أن تطلقها. يمكن لمثل هذه المعركة أن تؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين، مما يضع ضغطاً هائلاً على مواردها.
ومع ذلك، ومع اقتراب المعركة، تغير موقف تركيا، وأبلغت قيادة العمليات بأنها قد تتدخل عسكرياً أو سياسياً لفرض وقف لإطلاق النار إذا كان الميزان يميل بشكل حاسم لصالح النظام. كانت تركيا تخشى من أنه إذا كان النظام هو اليد العليا، فسوف ينتقم بوحشية من أولئك الذين بقوا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، مما أدى إلى نزوح جماعي آخر للاجئين إلى الأراضي التركية.

فجر يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت المعركة على الجبهات في الريف الغربي لمحافظة حلب. كان من المتوقع في البداية أن يستمر ما يقرب من عام، تقرر، بشكل ملحوظ، في غضون يومين فقط.
لعبت عمليتان خاصتان حاسمتان دوراً حاسماً في هذه النتيجة السريعة. تضمنت العملية الأولى تسلل فريق إلى أحد الخطوط الأمامية للعدو قبل يومين من الهجوم الرئيسي. في الساعة المحددة، ضربوا من الخلف، مما تسبب في اختراق سريع للدفاعات وإلحاق خسائر فادحة، بما في ذلك ضباط ميداني رفيعي المستوى ومستشارين روس.
استهدفت العملية الثانية قيادة النظام. تم إقناع قائد ميليشيا محلي، بدعم من إيران، سراً بالتعاون. وقد سهل تسلل أربعة من عناصر القوات الخاصة متنكرين في زي مرافقيه إلى اجتماع للجنة التنسيق الأمني والعسكري في حلب. في لحظة حرجة، انسحب القائد، مما سمح للعملاء بالقضاء على ضباط كبار من جيش النظام ومخابراته، بمن فيهم مستشار إيراني رفيع المستوى.
تسببت هاتان العمليتان في انهيار دراماتيكي في دفاعات النظام، مما أغرق صفوفه في حالة من الفوضى. مستغلة الفوضى، شنت قوات المعارضة هجوماً واسع النطاق، وفتحت جبهات طويلة ونشرت تعزيزات كبيرة. أثبت القصف الجوي الذي يشنه النظام، الذي كان يهدف إلى وقف التقدم، عدم فعاليته ضد الهجوم السريع والمنسق.
ألهمت سرعة وشدة العملية، المسماة “ردع العدوان“، مقاتليها، الذين صعدوا جهودهم وتقدموا بسرعة. بدأت قوات النظام، التي طغى عليها انهيار هيكل قيادتها، في الانهيار. فر الضباط من ساحة المعركة تاركين جنودهم وراءهم. وعندما شهد العديد من الجنود انسحاب قادتهم، تخلوا عن مواقعهم، وتخلصوا من زيهم الرسمي وأسلحتهم أثناء فرارهم بدورهم.
كان الجانب المحدد للمعركة هو الاستخدام الفعال للحرب النفسية من قبل مديرية العمليات العسكرية. قبل بدء المعركة بوقت طويل، تم إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، متنكرة في زي مؤيدي النظام. وقد اكتسبت هذه الحسابات، التي تسيطر عليها المديرية، ثقة جمهور النظام من خلال نشر أخبار ذات صلة بمخاوفهم، لا سيما تسليط الضوء على الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية. أدت هذه الاستراتيجية تدريجياً إلى تآكل ثقة جنود النظام في قيادتهم السياسية والعسكرية والأمنية.
مع بدء المعركة، أغرقت هذه الروايات جمهورها بأخبار محبطة تهدف إلى إضعاف عزيمة مؤيدي النظام ومقاتليه. في الوقت نفسه، حافظت المديرية على رقابة مشددة على مخرجات إعلامها لمنع العدو من استغلال أي معلومات. وبدلاً من ذلك، ركزت على بث رسائل تشجع جنود النظام على الاستسلام.
في غضون يومين فقط من المعارك الشرسة، حررت قوات ردع العدوان مناطق شاسعة محصنة بدفاعات كبيرة ومجهزة بالمعدات العسكرية. ترك انهيار هذه الخطوط الدفاعية الطريق إلى حلب مفتوحاً على مصراعيه. كانت استراتيجية قوات ردع العدوان واضحة: إبقاء الضغط المستمر على النظام، وعدم منحه أي فرصة لإعادة تجميع صفوفه أو إنشاء مواقع دفاعية جديدة.
بحلول ظهر يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني، دخلت طلائع قوات ردع العدوان حيي حلب الجديدة والحمدانية، وهما بوابتان رئيسيتان للمدينة من الجنوب الغربي. كانت هذه المناطق ذات أهمية استراتيجية، إذ تضم مراكز عسكرية وأمنية كبرى. كما كانت موطناً للعديد من ضباط النظام وقادة الميليشيات، ولم يتم تحريرها من قبل. كان خبر دخول قوات ردع العدوان إلى هذه الأحياء بمثابة صاعقة، حطمت معنويات ما تبقى من مقاتلي النظام وأنصاره.
كانت الأحياء الغربية من حلب، التي دخلتها قوات ردع العدوان أثناء تحرير المدينة، من أغنى مناطقها وأكثرها رقياً. خشي السكان في البداية من أن يعكس المقاتلون سلوك ميليشيات “الشبيحة” التابعة للنظام أو حتى ما يسمى بالجيش الوطني في ريف حلب، وكلاهما اشتهر بالانتهاكات والانتهاكات الواسعة النطاق. وأثارت هذه المخاوف المخاوف بشأن النهب أو النهب أو الغزوات الفوضوية المحتملة أثناء تحرير المدينة.
ثبت أن الواقع مختلف تماماً. إن الانضباط الأيديولوجي الذي غرس في ردع مقاتلي العدوان، إلى جانب الرقابة العسكرية المركزية القوية التي تمارسها قيادتهم، كفل عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات. أصبح تحرير غرب حلب دليلاً على التزامهم بالسلوك المبدئي، الذي كان بمثابة شكل قوي من أشكال الدعاية الأخلاقية. لم يطمئن هذا النجاح سكان حلب فحسب، بل شجع أيضاً على التعاون والدعم من السوريين في مدن أخرى، مما سهل التسليم السلمي لمناطق إضافية.
كانت القوات على دراية بذاكرة حلب الجماعية لتجاوزات وانتهاكات المعارضة خلال عام 2012، وعملت على ضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، وبالتالي ضمان تحقيق النصر المعنوي أيضاً.
كان تحرير حلب إنجازاً هائلاً على جميع المستويات، حيث أطلق سلسلة من ردود الفعل التي أشارت إلى الانهيار الحتمي للنظام. أصبح سقوط حلب أول حجر من الدومينو، وسرعان ما أعقبه تحرير حماة في 5 كانون الأول. أقنعت هذه الانتصارات السوريين بأن النظام كان سفينة غارقة، حيث كان الموالون يتدافعون للتخلي عنها.
تصاعد الزخم بسرعة مع انتفاض سكان حمص ودرعا وريف دمشق – المناطق التي عاد النظام إلى المناطق في العام 2018 – مما أدى إلى تسريع عملية التحرير الشاملة. وقد مهد ذلك الطريق لقوات ردع العدوان للتقدم السريع نحو دمشق. في غضون ذلك، تم تشكيل قيادات عمليات جديدة في جنوب وشرق سوريا، مما أدى إلى تشتيت جهود النظام في محاولاته اليائسة للدفاع عما تبقى من أراضيه.
في 8 كانون الأول/ديسمبر، تمت الإطاحة ببشار الأسد، وتحرير دمشق. دخلت قوات ردع العدوان العاصمة فجراً، وسلكت الطريق الصحراوي السوري بدلاً من انتظار الاقتراب من البوابة الشمالية عبر حمص، التي تم إعلان تحريرها في نفس اليوم.
في الأيام التي سبقت التحرير، فر مئات الآلاف من العلويين الموالين لقادة النظام من حمص ودمشق إلى الريف والمناطق الساحلية، لا سيما في اللاذقية وطرطوس. وفرت مديرية العمليات العسكرية ممراً آمناً لهذه المجموعات وأكدت لهم سلامتهم. تعاون العديد من العلويين، الذين أصيبوا بخيبة أمل من فساد النظام وقمعه، مع الجماعات المدنية ووجهاء محليين لجمع الأسلحة وتسليمها إلى المديرية، مما سهل الدخول السلمي للقوات إلى هذه المناطق.
قامت مديرية العمليات العسكرية بحماية السكان العلويين من الهجمات الانتقامية، وحافظت على الانضباط والحسم لمنع الانتهاكات. ساعد هذا النهج على استقرار الوضع، وبلغ ذروته بالإعلان عن حكومة تصريف أعمال تولت مهامها من رئيس الوزراء السابق. تم الاحتفال بانتصار الثورة في جميع أنحاء البلاد، حيث أظهر البث المباشر أهوال سجن صيدنايا والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السابق.
أظهر نجاح العملية التي أطاحت بالأسد نهجاً متطوراً في إدارة مؤسسات الدولة والتواصل داخلياً وخارجياً. ووجهت الحملة ضربة حاسمة للمحور الإيراني، حيث قطعت خط الإمداد الإيراني إلى حزب الله في لبنان وتركت طهران معزولة لمواجهة عواقب جهودها الإقليمية لزعزعة الاستقرار.
ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه المديرية والحكومة المشكلة حديثاً هائلة، لا سيما في إعادة بناء البلاد وتوفير الخدمات الأساسية. تشكل أزمة الطاقة والحاجة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع وانهيار الاقتصاد أعباء كبيرة تعقد الطريق إلى الأمام.
على الرغم من هذه التحديات، هناك فرص تلوح في الأفق. إن موقع سوريا الاستراتيجي كمفترق طرق حيوي للدول المجاورة يضعها كشريك محتمل في مشاريع التنمية الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مواردها البشرية الكبيرة – التي أثبتت فعاليتها العالية في المجالات الحيوية – توفر رصيداً قيماً لتعافي البلاد ونموها.
لم تكن عملية ردع العدوان نتيجة جهد قصير الأمد، بل كانت تتويجاً ل 13 سنة من النضال الدؤوب من قبل الشعب السوري، بدعم من المدافعين في جميع أنحاء العالم. ويمثل هذا الانتصار، الذي تحقق من خلال تضحيات عميقة، نقطة تحول. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الإنجاز والاستثمار فيه بشكل صحيح سيتطلب معركة جديدة متطلبة بنفس القدر – معركة لا تقل صعوبة.