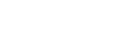*ميثاق: مقالات وآراء
*خاص- ترجمات الميثاق: المصدر”New Lines“
في صيف عام 2001، كان هناك انفتاح غير معهود في سيطرة حزب البعث الكاملة على السياسة السورية، بسبب وفاة حاكم البلاد لفترة طويلة، حافظ الأسد.
في هذه البيئة، عندما “تولى-وريثاً” بشار نجل حافظ مقاليد السلطة، بدأ المثقفون والمعارضون السوريون يجتمعون لمناقشة مستقبل البلاد من خلال منتديات مختلفة، غالباً ما يتم استضافتها في المنازل الخاصة.
وقد اجتذبت هذه الاجتماعات، التي عقدت بشكل رئيسي في دمشق، نشطاء سياسيين، وسجناء سياسيين سابقين، ومثقفين، وبالطبع بعثيين كانوا هناك لإثارة المشاكل، فضلاً عن مخبري النظام. عرفت هذه اللحظة من النشاط السياسي والفكري باسم “ربيع دمشق“.
وفي 5 آب/أغسطس 2001، ألقى رياض الترك (1930-2024) المتوفى حديثاً في أحد هذه المنتديات، أطلق عليه اسم منتدى الأتاسي، تكريماً للشخصية السياسية السورية الراحل جمال الأتاسي.
كان خطاب الترك، الذي حمل عنوان “مسار الديمقراطية وآفاقها في سوريا“، في بعض النواحي بمثابة ذروة ربيع دمشق، وهي اللحظة التي بدأت فيها التيارات الفكرية المختلفة تتجمع في أفكار سياسية أكثر تماسكاً. بدأ بالنظر إلى الوراء بدلاً من التطلع إلى الأمام، وهو قرار محير يمكن تفسيره بدولة سوريا في عام 2001. بحلول تلك المرحلة، كان الترك في ال70 من عمره وأمضى ما مجموعه حوالي عقدين في السجن، بما في ذلك ما يقرب من 18 عاماً في الحبس الانفرادي. لقد مر أكثر من 30 عاماً على الانقلاب الذي أطلق ديكتاتورية حافظ. لم يعرف معظم السوريين أي زعيم آخر، ولم يعرفوا أي برنامج سياسي آخر.
بالنسبة إلى الترك، وغيره من أمثاله، كان وضع التغييرات السياسية في البلاد في سياق معارضتهم الداخلية والمحلية أمراً حيوياً. وبخلاف ذلك، ربما رأى السوريون أفكارهم على أنها واردات أجنبية. وقال في بداية محاضرته: “إن سعينا لتحقيق الديمقراطية ليس وسيلة للتحايل الأجنبي”.
كان الترك يأمل في أن يسمح تغيير الحرس من حافظ إلى ابنه الأضعف ببدء “حقبة جديدة”: ليست حقبة تغيير سياسي واسع النطاق، بل حقبة قد يتيح فيها الاعتراف بوجود أزمة مجالا لوجهات نظر بديلة. كان متفائلاً. كان يعتقد أن الناس قد شعروا بإمكانية جديدة. كانت المحاضرة بأكملها مشبعة بالاعتقاد بأن التغيير، بشكل أو بآخر، كان قابلاً للتحقيق.
بالنسبة للقراء اليوم، المطلعين على الأحداث اللاحقة للربيع العربي، يمكن أن تبدو المحاضرة متقبلة بشكل مفاجئ لفكرة التغيير التدريجي. الكاتب المعارض “ياسين الحاج صالح” – الذي كان ينتمي سابقاً إلى نفس الحزب الشيوعي المنشق الذي ينتمي إليه الترك، وسجن هو نفسه لمدة 16 عاماً في نفس الوقت مع رفيقه – يصف ربيع دمشق بأنه لحظة “تفاؤل نسبي”. في تلك المرحلة، تصور المنشقون السوريون انتقالاً تدريجياً من الاستبداد إلى الديمقراطية.
في الجزء الأخير من محاضرة الترك، هناك تهديد ضمني في استحضار “الرايخ الثالث” لهتلر والاتحاد السوفيتي، وكلاهما انهار فجأة وبعنف – ـ تماماً كما حدث بعد عقد من الزمان تقريباً مع آل الأسد. هناك عنصر نبوءة في خطاب الترك.
التغيير الذي سعى إليه الترك وزملاؤه المنشقون الديمقراطيون لم يتحقق أبداً. في غضون شهر من المحاضرة، في سبتمبر/ أيلول 2001، انتهى ربيع دمشق. تم القبض على المثقفين والناشطين. بعد أن أطلق سراحه للتو من أكثر من 17 عاماً من السجن، سجن الترك مرة أخرى.

يرى الحاج صالح بذور انتفاضة 2011 في تلك اللحظة القصيرة من الأمل. ويقول لمجلة نيو لاينز: “بطريقة ما، يمكن النظر إلى الثورة السورية التي اندلعت بعد عقد من الزمان على أنها انتقام لربيع دمشق، ونوع من عودة المكبوتين”. “لقد نقلت ملكية السياسة من المنازل الخاصة إلى الأماكن العامة، ومن دمشق إلى كل مكان في البلاد، ومن النخبة إلى الشعب”.
كان هذا الافتتاح القصير، من بعض النواحي، تجربة. كان حافظ قد خصخص السياسة بشكل أساسي لمدة ثلاثة عقود. أما ابنه، الضعيف والمحتاج إلى الدعم في جميع أنحاء البلاد، فقد جسّ النبض من خلال تخفيف قبضة النظام الخانقة على التعبير السياسي. ولكن، كما يلاحظ الحاج صالح، “إن امتلاك السياسة يعني تحقيق المواطنة، وامتلاك الدولة نفسها، التي كانت (ولا تزال) ملكية خاصة لعائلة ورفاقها”.
- لم يكن بشار راغباً في نهاية المطاف في القيام بذلك، وبعد حملة أمنية في خريف عام 2001، عادت السياسة القمعية كالمعتاد إلى سوريا – حتى حاول الشعب السوري بعد عقد من الزمان السيطرة على سياسة البلاد. لكن هذه المرة، كما يشير الحاج صالح، قوبلوا ب “النار والدم”، وليس مجرد الاعتقال.
كان رياض الترك معروفاً بمودة باسم “ابن العم”. أخرج المخرج السوري محمد علي أتاسي فيلمين وثائقيين ركزاً على هذا اللقب، “ابن العم” (2001) و”ابن العم على الإنترنت” (2012). ظل الترك ملتزماً بالنضال الديمقراطي خلال الثورة والحرب اللاحقة، وعند هذه النقطة كان في عمره في 80 سنة. في عام 2018 غادر سوريا أخيراً. يقول الحاج صالح، الذي كتب تحية مؤثرة للترك من أجل الجمهورية، لنيو لاينز إن رفيقه السابق مات “على طول طريق النضال الطويل لاستعادة سوريا لشعبها”.
- فيما يلي محاضرة ألقاها الترك في دمشق عام 2001.
ينخرط عدد لا يحصى من السوريين، الذين ربما يصل عددهم إلى مئات الآلاف، في أشكال مختلفة من المعارضة الحقيقية في حياتهم اليومية خارج السجن، في انتظار اللحظة المناسبة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم الحقيقية. إن سعينا لتحقيق الديمقراطية هو جزء لا يتجزأ من تاريخنا وهويتنا في سوريا، وليس وسيلة للتحايل على الغربة.
وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن مناقشة الديمقراطية هي ضرورة سياسية أكثر من كونها نقاشاً نظرياً. ولذلك، سيتناول حديثي التحديات الحالية والإمكانيات المستقبلية على حد سواء، مستخلصاً الدروس من الفترة التي انقضت منذ استقلالنا. سأقسم هذه المناقشة إلى حقبتين: أولاً، من أربعينيات القرن العشرين إلى ستينيات القرن العشرين، وثانياً، من ستينيات القرن العشرين إلى الوقت الحاضر.

كان النظام السياسي الذي أنشئ في سوريا في أوائل أربعينيات القرن العشرين، وخاصة بعد الاستقلال، ديمقراطية برلمانية. لم يكن هذا القرار بتطبيق نظام برلماني على النمط الغربي نتيجة للاحتلال الفرنسي لسوريا بعد الحرب العالمية الأولى فقط. كما انبثقت عن الخيارات المتعمدة للمثقفين والسياسيين المتأثرين بالغرب في بلاد الشام. كان هذا واضحاً في المؤتمر السوري العام عام 1919، حيث دافعوا بقوة عن هذا النظام. أنشأ المؤتمر لجنة، بقيادة هاشم الأتاسي، لصياغة دستور للمملكة في عهد الملك فيصل، مع التركيز على دعم النظام البرلماني. والجدير بالذكر أن هذا الدستور، في العديد من الجوانب، كان أكثر تقدمية من نظرائه الغربيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة.
كانت القوة الأساسية التي تدعم النظام وتدعمه هي البرجوازية، التي شكلتها موروثات الإقطاع وتأثير ملاك الأراضي. من المهم أن ندرك أن شريحة من البرجوازية شاركت في الكفاح ضد المستعمرين إلى جانب الجماهير. ومع ذلك، خلال الحقبة المضطربة التي تلت ذلك، فشلت هذه المجموعات في الارتقاء إلى مستوى المناسبة، مما عزز الاستياء العام. وكما لاحظ المناضل الراحل من أجل الاستقلال عبد البر عيون آل سعود، اعتبرت البرجوازية الاستقلال هو الهدف النهائي وسعت على عجل لجني ثماره، متجاهلة نضال الشعب السوري الذي دام 25 عاماً.
- تم تقويض سلطة هذه القوى التقليدية من خلال ثلاثة عوامل رئيسية:
شكلية واحتكار العملية الديمقراطية، وهو الوضع الذي أدى إلى إضعاف وقمع جزئي للقوى الديمقراطية الناشئة.
- أظهر القادة السياسيون أداء ضعيفاً في كل من توطيد الاستقلال وفي التعامل مع القوى الخارجية التي كانت تتآمر ضدهم. لقد تبنوا نهج الاسترضاء والمراوغة بدلاً من المقاومة الحازمة. ساهم هذا الفشل في الوقوف ضد الاستراتيجيات الإمبريالية في ظهور “إسرائيل” في مركز العالم العربي.
- شكل ظهور الأحزاب الديمقراطية الوطنية ومختلف الجماعات الأخرى كقوى معارضة تحولاً كبيراً. دافعت هذه الجماعات عن أهداف قومية وديمقراطية كانت أكثر تماسكاً وراديكالية. وقد منح هذا النهج هذه الأحزاب نفوذاً كبيراً في الساحة السياسية.
خلال هذه الفترة، شهدت سوريا سلسلة من الانقلابات التي عطلت العملية الديمقراطية وأنتجت أنظمة استبدادية. كان أحد آثار الإطاحة بالنظام الدكتاتوري لأديب الشيشكلي (في عام 1954) هو ارتفاع أهمية المجموعات الاجتماعية والاقتصادية الأصغر، الحضرية والريفية على حد سواء، والتي استمرت في لعب دور رئيسي وحاسم إلى جانب البرجوازية، التي كانت لا تزال لاعباً رئيسياً وإن كان متراجعاً.
*مواد ذات صلة:
خلال تلك الحقبة، شهد السوريون عملية ديمقراطية ينظر إليها الآن بحنين إلى الماضي. وقد تميزت هذه الفترة بالالتزام بالحرية واحترام النتائج الانتخابية والنهوض بالمصالح الوطنية والوطنية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك تضامن سوريا مع مصر خلال العدوان الثلاثي والدعم الواسع للاتحاد مع مصر في ظل الجمهورية العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تقدم اجتماعي كبير، خاصة بالنسبة للعمال والمزارعين، على الرغم من هيمنة البرجوازية الرسمية في الحياة العامة. من عام 1955 إلى عام 1957، كانت العملية الديمقراطية متعددة الأوجه: فهي لم توفر الحرية للقوى السياسية والجماعات والمواطنين فحسب، بل أظهرت أيضا مفهوم “الشعب”، وسلطت الضوء على دورها ومصلحتها العامة. كما مكّن هذا المناخ الجماعات الدينية من الانخراط في السياسة كأصحاب مصلحة وطنيين.

ومع ذلك، كان لهذه القوى الجديدة ميول سياسية متميزة، مما أدى إلى اختلافات في أهدافها الاجتماعية والسياسية. وكان من بين هذه الجهات الفاعلة الكتلة العسكرية وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي السوري. في حين أن الطموحات السياسية الداخلية والخارجية للحزب الشيوعي السوري متشابهة هيكلياً، إلا أنها كانت أكثر انسجاماً مع المصالح السوفيتية بدلاً من أن تنبع من أهداف وطنية أو شعبية أوسع. كان هذا التوافق واضحاً في العديد من التطورات الرئيسية.
حددت هذه الكتل إلى حد كبير المشهد السياسي السوري في حقبة ما بعد الاستقلال حتى ستينيات القرن العشرين. كان هذا باستثناء فترة وجيزة من الحكومة الانفصالية، استعادت خلالها البرجوازية السلطة.
- تبرز عدة نقاط رئيسية في تحليل نقاط القوة والضعف في القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية في تلك الحقبة:
كانت الجمهورية العربية المتحدة إنجازاً مهماً، مما يعكس رغبة الأمة العربية في الوحدة القومية ويعمل كمضاد سياسي للتحالفات والعدوان الغربي.
كشف الانفصال عن نقاط ضعف الجمهورية العربية المتحدة. أدى حل الأحزاب وإنشاء المؤسسات البيروقراطية والأمنية إلى إضعاف أسسها. وقد أدى ذلك إلى علاقات مباشرة بين القائد والشعب، وتعزيز الفساد والديكتاتورية، كما رأينا في الحكم الشخصاني وتهميش دور السكان وتمثيلهم.
- بعد الانفصال، تحولت العلاقة بين القوى الوطنية والديمقراطية من التعاون إلى المنافسة والتآمر، مما قوض الثقة السياسية. نما العداء بين الشيوعيين والقوميين، حيث شوه كل جانب سمعة الآخر. عارض الحزب الشيوعي السوري الوحدة تحت ستار الموقف الديمقراطي الفريد لسوريا، مما يعكس المخاوف السوفيتية.
- بعد الانفصال، طغت المنافسة الشديدة على الهدف الأصلي المتمثل في التوحيد. وأدى ذلك إلى تقلص المجال السياسي والقضاء على التعددية.
- تحول المناخ السياسي بعيداً عن الحوار حول تنمية البلاد وتحسين الديمقراطية نحو صراع شرس على السلطة، وتوليد القبلية واختزال الأحزاب إلى مجرد واجهات.
قبل عام 1963، وتحديداً قبل تموز 1963، كان الصراع على السلطة بين مختلف الكيانات يسير وفقاً لقواعد وأنظمة مقبولة بشكل عام. اعترفت هذه المعايير بالاقتراع باعتباره العامل الحاسم، مما يسمح بالتعايش ومشاركة المجموعات السياسية المتنوعة. وقد عززت هذه البيئة التنوع وسمحت بالتعبير عن وجهات نظر سياسية مختلفة. وحتى خلال الانقلابات التي وقعت بين عامي 1949 و1954، لم يتمكن المجلس العسكري من القضاء على المنافسين السياسيين. ومع ذلك، تغير المشهد بشكل كبير بعد 8 آذار 1963، ومرة أخرى في يوليو/تموز 1963. وظهر مفهوم “الحزب القائد” في مفردات الدولة والمجتمع، مما يشير إلى الانتقال إلى الساحة السياسية التي يهيمن عليها حزب البعث حصرياً. ولم يترك هذا للمجموعات الأخرى خياراً سوى الانسحاب من السياسة. وأصبح العمل سراً أو الانخراط في “المؤامرة” محفوفاً بالمخاطر للغاية، خاصة في ظل حالة الطوارئ، التي أدت إلى تمكين الجهاز القمعي. ونتيجة لذلك، تغيرت معايير المشاركة السياسية، وظهرت نوعية مختلفة من اللاعبين السياسيين.
تطور آخر كان تهميش الناصريين عندما انتقل الصراع على السلطة إلى الجيش وداخل حزب البعث. أدى هذا التحول تدريجياً إلى تقليص دورهم، مما أدى إلى تهميشهم مع “الحركة التصحيحية” لعام 1970 وما بعدها. وكانت نتيجة هذا الصراع سلسلة من عمليات التطهير التي استهدفت شخصيات حزبية معينة، مصحوبة بإقالات واسعة النطاق داخل الجيش. وغالباً ما حملت هذه الإقالات دلالات طائفية أو قبلية أو جغرافية.
في المجال الاجتماعي، من الإنصاف الاعتراف بتوسع التأميم ليشمل المصانع المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعزيز قوانين الإصلاح الزراعي وغيرها من المبادرات. ومع ذلك، لم تخل هذه التدابير من الجدل داخل حزب البعث. وبلغ هذا الخلاف الداخلي ذروته في نهاية المطاف بالإطاحة بفصيل البعث اليساري، تلاه حزب البعث القومي في انقلاب شباط/فبراير 1966.
سياسياً، استمر الصراع مع الفصائل الناصرية التي تشكلت بعد الانفصال، ولا سيما الاتحاد الاشتراكي العربي، الذي أسسه الناشط البارز جمال الأتاسي عام 1964. (هنا، يجب أن أعرب عن إعجابي بالأتاسي، الذي حول هذا المنزل الذي نحن فيه إلى ملاذ للأصدقاء وأعضاء الحزب والرفاق وأي شخص مخلص لأمتهم. كان الأتاسي رجلاً ذا بصيرة وتواضع ودفء. اتسمت تفاعلاته بروح المقاتل الحقيقي، مع إعطاء الأولوية لوحدة ومستقبل أمته والديمقراطية قبل كل شيء. أتقدم بتحياتي لعائلة صديقنا الراحل، وأدعو الله أن ينعم الله على هذا البيت، وعلى بنات الأتاسي وأرملته وأحفاده). تكمن أهمية هذا الحزب في جهوده لغرس مبادئ الديمقراطية والعروبة في صلب الأيديولوجية القومية العربية الناصرية.

شهدت هذه الفترة أيضاً تحولاً كبيراً مع “الصراع العربي الإسرائيلي” الذي أثر بشكل كبير على الوضع الراهن الإقليمي. في حزيران 1967، استولى العدوان الإسرائيلي التوسعي على المزيد من الأراضي، مما وجه ضربة قاسية لمفهوم “الأنظمة الوطنية التقدمية”. وفي الوقت نفسه، برزت المقاومة الفلسطينية كلاعب رئيسي، في حين سعت مختلف القوى والأنظمة المشاركة في الصراع إلى إعادة تقييم نفسها وإعادة تموضعها.
وعلى الرغم من بسالة حرب تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أنها فشلت في وقف التدهور العام في العالم العربي، وهو اتجاه استمر بلا هوادة. لم تتمكن الانتفاضة الأولى، وكذلك الانتفاضة الثانية، التي نقدرها تقديراً عالياً، من عكس مسار هذه الدوامة دون تغييرات جوهرية في الظروف السائدة في العالم العربي.
مع صعود الرئيس حافظ الأسد إلى السلطة، خضع النظام للتحول إلى نظام رئاسي مصمم خصيصاً لقيادته. أدى هذا التحول إلى شخصنة النظام، الذي تجسد في شعار “القائد الفريد والملهم”، ليحل محل “الحزب الرائد للدولة والمجتمع”. أثر هذا الشعار على تصرفات مسؤولي الدولة والحزب والجبهة الوطنية التقدمية، وكلها تدور حول الشخصية المركزية للزعيم. تم قياس النفوذ السياسي من خلال القرب من الرئيس أكثر من الأفكار أو الشعبية أو الموقف، مما أدى إلى رفض أي نشاط سياسي لا يتماشى مع هذه القاعدة. ظهرت قواعد جديدة، تختلف عن النهج الجماعية أو شبه الجماعية لأقران الأسد العسكريين والمدنيين في المستويات العليا من السلطة.
في أوائل سبعينيات القرن العشرين، كان هناك خروج ملحوظ عن السنوات السابقة. تميزت هذه الحقبة بالجهود المبذولة لكسر العزلة المحلية والدولية، لا سيما من خلال إنشاء الجبهة الوطنية التقدمية، والهياكل الإدارية المحلية، ومجلس الشعب السوري، والدستور الدائم. في الوقت نفسه، كان هناك تركيز على “تحديث الجيش”، جنباً إلى جنب مع مصر وبمساعدة الاتحاد السوفيتي. مثلت حرب أكتوبر تحولاً كبيراً، مصحوباً بتدفق أموال النفط وتطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي السريع الذي أعاد تشكيل النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، أدى هذا التحول أيضاً إلى توحيد الثروة والفساد.
خلال هذه المرحلة، تمحور النظام بشكل متزايد حول الزعيم “المتفرد” والأجهزة الأمنية، وهمش الناس وحصرهم داخل حدود جديدة، بما في ذلك بنية حزبية متضخمة تهدف إلى إبعادهم عن السياسة. ومع اتضاح الطبيعة الشمولية للنظام وتبلور الحكم الشخصي (الفرداني)، بدأت القوى السياسية والاجتماعية، إلى جانب الشخصيات الديمقراطية المستقلة، تنأى بنفسها، خاصة مع شعورها بالتهميش بشكل متزايد.
- لجأ النظام إلى الترهيب والإغراء للامتثال، حيث لا يمكن لرواية واحدة أن تشمل تنوع التعبير السياسي. ظهرت ثقافة التظاهر والخوف، حيث يتماشى السلوك العام مع توقعات النظام، لكن المعتقدات الخاصة ظلت غير منطقية. وأدى ذلك إلى مشاركة واسعة النطاق في المظاهرات المؤيدة للنظام، مدفوعة باليأس والامتثال.
اتسم العقدان الأخيران من القرن بالركود في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت ذريعة “الاستقرار“. كان هذا الركود مدعوماً محلياً بالترهيب ودولياً بتوازنات الحرب الباردة. إن “انهيار الاتحاد السوڤيتي” ونهاية الحرب الباردة واندلاع حرب الخليج الثانية سلط الضوء على الحاجة إلى التغيير. ومع ذلك، أصبح النظام جامداً للغاية ومهتماً بمصالحه الذاتية، مما أدى إلى تهميش السكان وقمعهم واستغلالهم. وقد أدى مرض الرئيس الراحل، الذي غابت القيادة خلاله، إلى تفاقم هذا الركود. أدت هذه الفترة إلى تفاوتات اجتماعية حادة، وتركيز الثروة في أيدي عدد قليل بينما كانت الأغلبية تقبع بالقرب من المجاعة. وتنتشر الأزمات العميقة في جميع جوانب الحياة.
*مواد ذات صلة:
وأجبر تدفق النقد الأجنبي والنفوذ السياسي على حساب الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يشير إلى أزمة لا يمكن معالجتها إلا من خلال التغيير.
بعد وفاة حافظ الأسد، صعد بشار الأسد إلى الرئاسة، إيذاناً ببدء حقبة جديدة. كان التحول الملحوظ في هذه الحقبة هو تحول النظام الرئاسي الشخصي. أدى انتقال السلطة من الأب إلى الابن إلى نظام هجين، ليس جمهورياً بحتاً ولا ملكياً، ولكنه مزيج من الاثنين، وغالباً ما يطلق عليه “نظام جمهوري وراثي”.
كان صعود بشار الأسد إلى السلطة تتويجاً لثلاث إرادات متميزة، باستثناء التعبير عن الإرادة الشعبية: نية الرئيس الراحل، وطموحات شخصيات النظام المؤثرة، وتطلعات الابن نفسه. ينظر إلى ادعاءات الإجماع الاجتماعي في هذا التحول إلى حد كبير على أنها فارغة، وتخدم كدعاية أكثر من كونها حقيقة.
وقد نوقشت هذه القضية على نطاق واسع في وسائل الإعلام المنشقة والأوساط السياسية. وجاءت وجهة نظر انتقادية من التجمع الوطني الديمقراطي، الذي انتقد التعديل الدستوري ليناسب الفرد، بحجة أنه يتعارض مع المبادئ الديمقراطية ويخلق تصورا للخلافة الرئاسية الوراثية. وينظر إلى هذا على أنه متناقض ليس فقط مع النظام الجمهوري الذي أنشئ قبل حافظ الأسد ولكن أيضاً مع تقاليد الأحزاب السياسية مثل حزب البعث العربي الاشتراكي وحتى الأنظمة العقائدية والشمولية في القرن العشرين.

وعلى الرغم من الوضع الراهن الذي لم يتغير، فإننا ندرك اختلاف النبرة واللغة في حفل تنصيب بشار الأسد مقارنة بسلفه. ويشمل ذلك اعترافاً صريحاً بالأزمة، وهو أمر تم إنكاره منذ فترة طويلة، واعترافاً ضمنياً بالمعارضة السياسية من خلال الاعتراف بالآراء المعارضة. من خلال الاعتراف بعدم وجود “عصا سحرية” لحل الأزمة، يعترف النظام بشكل غير مباشر بعدم فعالية الهياكل الاستبدادية في إدارة الوضع بمفرده. وتشير هذه التصريحات إلى الحاجة إلى مزيد من الانفتاح والإصلاح السياسي، وهو أمر تم إنكاره وتجنبه في السابق.
الوضع الحالي معقد بسبب عدة عوامل خارجية. وتشمل هذه العلاقات الدولية للنظام الحاكم، والتوترات المكثفة مع إسرائيل خلال حكومتي “إيهود باراك” و”أرييل شارون“، والديناميكيات مع الدول العربية، لا سيما فيما يتعلق بالوجود السوري في لبنان بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب. وعلى الرغم من سحب بعض القوات من قبل النظام السوري، يعارض المجتمع اللبناني والقوى السياسية إلى حد كبير وجود سوريا وتدخلها في الشؤون الداخلية. هناك حاجة إلى إعادة تشكيل العلاقة السياسية والعسكرية السورية اللبنانية لدعم المقاومة ضد إسرائيل وحماية الجنوب مع احترام السيادة اللبنانية وتجنب التدخل السياسي، وخاصة من قبل الأجهزة الأمنية السورية.
كما أن التضامن مع الشعب العراقي أمر بالغ الأهمية، ويشمل معارضة قرارات مجلس الأمن غير العادلة، وإنهاء الحصار ومقاومة الضغوط الأمريكية لإلغاء الاتفاقات مع العراق. إن استئناف العلاقات مع العراق مفيد لكلا البلدين.
وتؤكد هذه التحديات الخارجية على ضرورة الانفتاح وتمكين السكان من لعب دور أكثر فعالية. ومع ذلك، غالباً ما يتم تجاهل هذه الدعوات، مع حفاظ الحرس القديم على أساليبه ومصالحه واستراتيجياته التقليدية. إنهم يحاولون التعامل مع هذه القضايا، ويسعون جاهدين لتحييد التأثيرات الخارجية للسيطرة على المشهد الداخلي.
ومن ناحية أخرى، هناك تطورات في ثلاثة مجالات محددة، وإن كانت طفيفة وأقل أهمية مما هو مطلوب.
- هناك ثلاث قضايا رئيسية تميز المناخ الاجتماعي والسياسي حالياً:
لقد أصبح الخوف متأصلاً بعمق في النسيج الاجتماعي والسياسي لبلدنا. غالبا ما يخفي الناس أفكارهم الحقيقية، حتى في السر، ويترددون في الانخراط في الشؤون العامة خوفاً من المراقبة والاحتجاز. في حين كان هناك انخفاض طفيف في الخوف، لا سيما بين النخبة الثقافية والسياسية، إلا أنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي ينشط الحياة العامة. هذا التحسن الطفيف في حرية التعبير، وإن كان ضئيلاً، مهم مقارنة بفترة القمع الطويلة.
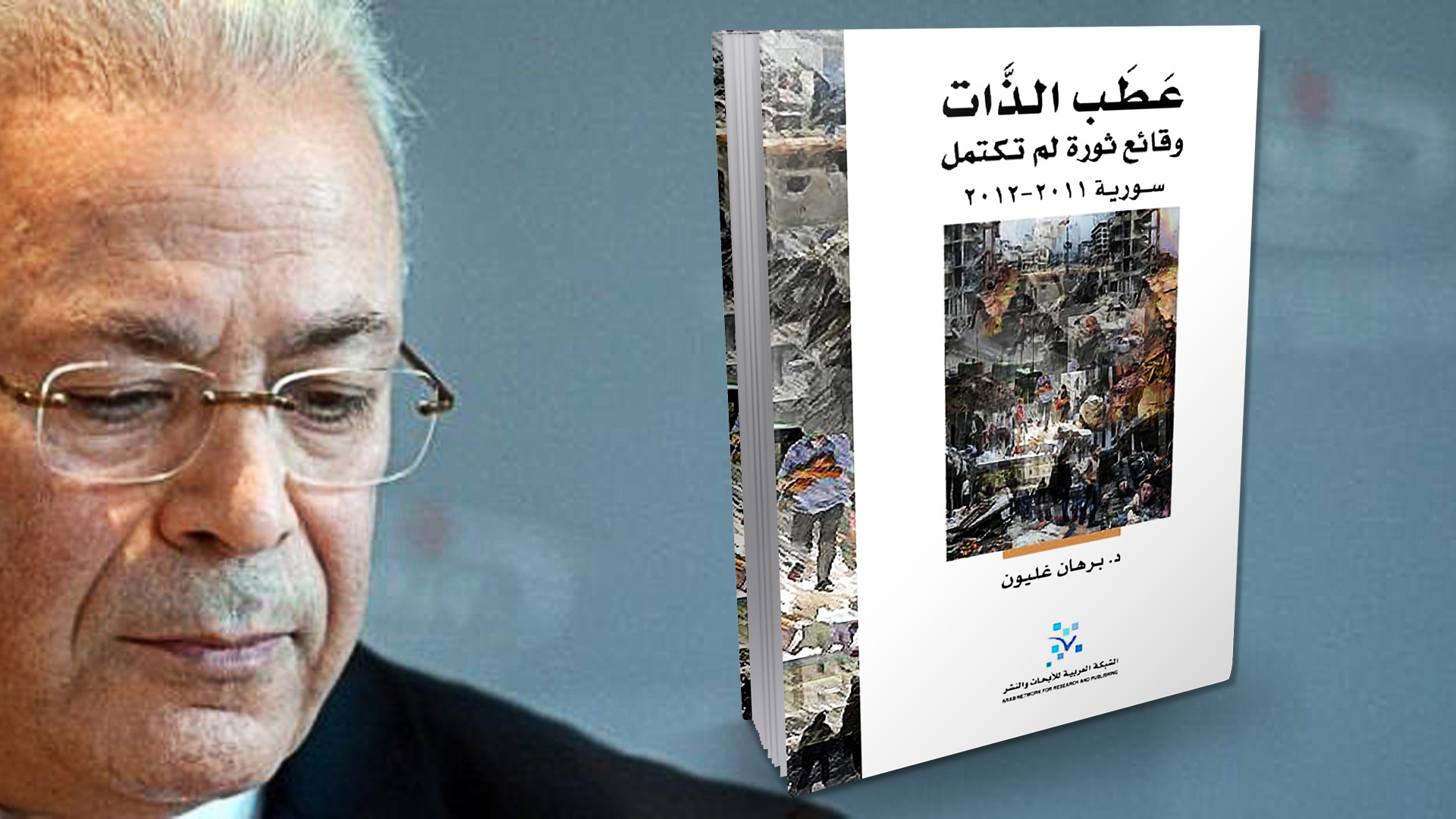
ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخوف، فقد حدث تحول في أساليب الأجهزة الأمنية. وقد استعيض إلى حد ما عن الاستخدام السائد للاعتقالات والحرمان من الحرية بالمراقبة المكثفة والاستجوابات والاستدعاءات. ولا يزال هذا النهج يمارس ضغوطاً نفسية على السكان، ويحافظ على حالة الاستعداد للعودة إلى تدابير أكثر قمعاً إذا لزم الأمر.
أعطى النظام الأولوية للإصلاحات الاقتصادية، وأرجأ الإصلاحات السياسية للتركيز على الاقتصاد وسبل عيش الناس. ومع ذلك، فإن عدم إحراز تقدم ملموس قد غذّى الشكوك. وفي حين أن هناك مؤشرات على الإصلاح الاقتصادي في المراسيم الجديدة، فإنها لم تتحول بعد إلى تغييرات قابلة للتنفيذ. إن مقاومة النظام للتغيير (سواء بشكل مباشر أو من خلال الجمود البيروقراطي) وعدم الكفاءة الإدارية والمصلحة الذاتية لمن هم في السلطة واضحة.
وعموماً، يمكن وصف الحالة بأنها أزمة ركود شاملة وعدم إحراز تقدم في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
غالباً ما يدافع النظام عن فترة الركود هذه كوسيلة للحفاظ على الاستقرار والاستمرارية، بما يتماشى مع مصالح السلطويين والمنتفعين الذين يقاومون التغيير خوفاً من النتائج غير المؤكدة. يتم الحفاظ بقوة على الوضع الراهن الراسخ.
وكثيراً ما يتم إخفاء التخلف في صورة تفرد ثقافي، حيث يتم التلاعب بالديمقراطية لتناسب احتياجات السلطة الحاكمة، مما يؤدي إلى زيادة القمع. الإصلاح الاقتصادي معطل بحجة الحفاظ على إنجازات الماضي، لكنه في الواقع يحمي مصالح المستفيدين من الفساد.
تتميز الأزمة بانعدام الآفاق والوصول إلى طريق مسدود. ويكافح الاقتصاد مع السيولة والاستثمار والبطالة، ويعوقه الفساد والبيروقراطية وعدم وجود نظام قانوني قوي. يفتقر القطاع العام إلى الإصلاح الجريء والكفء. من الناحية الاجتماعية، هناك غياب للنشاط والمشاركة العامة، يتسم بالتمييز والخوف. من الناحية السياسية، هناك نقص في توافق الآراء حول القضايا الوطنية وارتباك فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.
حزب البعث، بعضويته الواسعة، غير نشط إلى حد كبير، حيث ينظر إلى القادة على أنهم من بقايا الماضي. تفتقر أحزاب المعارضة إلى التوجيه وأصبحت راضية عن نفسها، وقبلت حالتها الضعيفة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك شعور متزايد بأن التغيير ممكن. وقد اقترحت بعض النخب طرقاً للخروج من الوضع الراهن، وأطلقت منتديات لمناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية. ومع ذلك، فإن قمع النظام لهذه المنتديات عزز الشكوك والخوف.
هناك نقص في القوى المؤثرة التي تلبي احتياجات البلاد بنشاط. لم تقترح أو تنظم القوى الرأسمالية ولا الإسلامية برامج قابلة للتطبيق بشكل فعال. كافح المنشقون الديمقراطيون للتعبئة بفعالية لتلبية احتياجات الناس وتطلعاتهم.
ومن الناحية السياسية، فإن الوضع هو “توازن ضعف”، حيث يكون كل من النظام والمعارضة ضعيفين. هذه الدولة تتطلب جهداً كبيراً لتغيير المواقف الجامدة وإيجاد حل لهذه المعضلة الكبرى.
- يطرح موفق نيربية (كاتب وناشط سوري) سؤالاً حاسماً: هل هذه الفترة بداية حقبة جديدة مختلفة، أم مجرد استمرار للعقود الماضية، تديم نفس التحديات التي تواجه السوري؟
إن التحدي المتمثل في الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية معقد. من الواضح أن الإصلاح والتغيير لا يمكن أن يعتمدا فقط على السلطة نفسها، ولا يمكن تحقيقهما من خلال ثورة من أعلى إلى أسفل أو “إصلاح رئاسي”. تفتقر القيادة الحالية والقوى المتحالفة مع النظام إلى القدرة أو الهيكل اللازم لدفع عملية إصلاح ذات مغزى. وتبرز ذلك تجربة العام الماضي وتعقيدات الأزمة الداخلية، التي تفاقمت بسبب التعقيدات الخارجية والمواجهة مع إسرائيل.
لبدء التغيير، من الضروري بناء الثقة وإلهام الأمل في الناس، لكن الظروف لهذا التحول لم تتهيأ بعد. يمكن أن يحدث التغيير السياسي بأشكال مختلفة:
- تغيير عنيف لإسقاط النظام الذي يفتقر حالياً إلى الشروط اللازمة والاستعداد للتضحية والقدرات اللوجستية.
التغيير من خلال البرلمان في بلد يتلاعب فيه النظام بالتمثيل. - التغيير الذاتي من قبل الحاكم ، ثورة “من أعلى إلى أسفل”، كما وصف “ماركس” في ألمانيا في القرن التاسع عشر.
- التغيير من خلال اتفاق بين النظام، والاعتراف بعجزه عن الاستمرار في الحكم وسط أزمة متفاقمة، والقوى الأخرى المستعدة للدخول في حوار وسن إصلاحات متفق عليها.
إن الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية هو صراع طويل وشاق ومعقد. وبالنظر إلى جميع السبل المحتملة للخروج من هذه المعضلة الهيكلية، يصبح السؤال الرئيسي هو توحيد المعارضة، وتركيز النشاط السياسي، والالتزام الراسخ بالإصلاح الديمقراطي الشامل.

في السياق التاريخي، كانت الدولة الاستبدادية في أوروبا علامة على الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، أو من السيادة المجزأة إلى الديمقراطية، مع شخصيات مثل لويس الرابع عشر وبسمارك مثالاً على هذه المرحلة. في أميركا اللاتينية، النماذج الاستبدادية شائعة، حيث يمارس الحكام السلطة باسم الشعب، ويؤسسون تسلسلاً هرمياً قائماً على قوانين ذاتية الصنع أو يتم تجاهلها. تهيمن الأوامر والتوجيهات على المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وغالباً ما تتحدى القرارات السياسية المنطق.
الدول الشمولية، كما رأينا في أمثلة موسوليني وهتلر والاتحاد السوفيتي، تدمج كل شيء في نطاق الدولة، ولا تترك مجالاً للمعارضة. ويتحقق ذلك من خلال حزب مهيمن يتصرف أحياناً مثل الميليشيا، أو من خلال “المنظمات الشعبية” التي تنظم الجميع تحت هيكل مهيمن.
وفي حين أن سوريا تظهر سمات هذه “الدول” المختلفة، إلا أنها لا تتوافق تماماً مع أي نموذج واحد، مما يشكل تحدياً فريداً في طريقها إلى الديمقراطية.
يمكن النظر إلى هذا الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية على أنه مرحلة طبيعية في تاريخ الدول، على الرغم من أنه تطور متأخر نسبياً في سياق التطور السياسي العالمي. غالباً ما يتم تبرير دعم النظام من خلال أيديولوجية “الاستبداد الخير”، حيث يؤمن المؤيدون بحسن نية النظام. ومع ذلك، لتحقيق تغيير حقيقي، يجب أن ننظر في إمكانية حدوث نوع رابع أكثر شمولاً من الانتقال، والذي قد يفضله الكثيرون بسبب الإرهاق. هناك خمس نقاط حاسمة للمناقشة:
- إن رفع المظالم ينطوي على استعادة الثقة والأمن من خلال الاعتذار وتعويض أولئك الذين ظلمهم النظام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح للمنفيين بالعودة، والكشف عن مصير المفقودين، وإلغاء قوانين الطوارئ وإصلاح قوات الأمن.
- من الضروري تحديد عناصر الحوار الوطني وإشراك جميع أصحاب المصلحة في المجال العام لإجراء مناقشات شفافة وصادقة دون أجندات خفية أو تكتيكات استبدادية.
- المصالحة الوطنية بين الشعب والنظام والمعارضة أمر بالغ الأهمية، لكنها تتطلب بناء الثقة من خلال خطوات ملموسة تفضل التسوية على العداء.
- يجب على جميع القوى السياسية، بما في ذلك حزب البعث وجماعات المعارضة والحركات الإسلامية، الاعتراف ببعضها البعض والالتزام بالإصلاح الذاتي وإعادة التنظيم.
- صياغة برنامج للتغيير الديمقراطي بنهج منظم وموقوت يتماشى مع المصالح الوطنية والتحديث. وينبغي أن تكون هذه عملية تدريجية، تؤدي إلى نظام ديمقراطي يدعمه دستور حديث.
إن دعم الإصلاح أمر حيوي، ولكنه يتطلب نية وعملاً حقيقيين. التغيير أمر لا مفر منه. التاريخ يتقدم، وأولئك الذين يقاومون أو يترددون سوف يتركون وراءهم. لذلك، لا بد من العمل من أجل تخفيف معاناة الشعب، الذي يتوق إلى مستقبل من الحرية والكرامة والأمن.