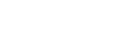*ميثاق: مقالات وآراء
ترجمات الميثاق ــ المصدر: «New Lines Magazine»
«في بلد يعاني من الصراع الطائفي والدكتاتورية، اختارت مدينة واحدة مسارًا مختلفًا»
بعد نصف عام من انتصار الثورة السورية، بدأت الانقسامات العميقة في المجتمع، التي خلّفتها خمسة عقود من الدكتاتورية، تتجلى بوضوح.
سادت أجواءٌ من الفرح العارم أعقبت الإطاحة بالديكتاتور بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. فبعد قرابة 14 عامًا من اندلاع أولى الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكمه، شهد النظام السوري انهيارًا مفاجئًا شنّته الجماعات الثائرة الرئيسية في سوريا – التي كانت محاصرة لسنوات في جيب إدلب الشمالي الغربي. سقطت حلب أولًا، ثم حماة، ثم دمشق. وامتلأت الشوارع فرحًا بالمواطنين مع إخلاء السجون، والتحرر أخيرًا من حكم عائلة الأسد الاستبدادي بعد 54 عامًا.
حملت الأشهر التي تلت ذلك أسبابًا للتفاؤل، أبرزها رفع بعض العقوبات الغربية وإمكانية التجمع في الشوارع دون التعرض للاعتقال أو التعذيب. لكنها جلبت أيضًا تذكيراً كئيباً بعمق المشاكل التي لا تزال سوريا تواجهها، مثل الطائفية، التي لطالما استخدمها نظام الأسد أداةً لتقسيم السلطة، والتي تفاقمت بعد عقد ونصف من الصراع. في أوائل مارس/آذار، أدى تمردٌ قاده عناصر موالية للأسد على الساحل السوري – موطن الأقلية العلوية في البلاد، التي تنحدر منها عائلة الأسد ومعظم النخبة العسكرية السابقة – إلى قيام مسلحين عرب “سنة” بارتكاب مجازر انتقامية وحشية ضد قرى علوية. بدأت بعد ذلك تحركات عسكرية مع عصيان ضد الحكومة الجديدة في محافظة السويداء الجنوبية، التي تهيمن عليها الأقلية الدرزية، والتي تمتعت بنوع من الحكم الذاتي بحكم الأمر الواقع منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. تطورت الاشتباكات بين الميليشيات الدرزية والقبائل البدوية السنية في منتصف يوليو/تموز إلى تدخل حكومي، وغارات جوية إسرائيلية مكثفة (على القوات الحكومية)، وإعدامات ميدانية من كلا الجانبين. في هذه الأثناء، كان الأكراد السوريون يراقبون ما يحدث من على حدة بقلق، رافضين تسليم أسلحتهم أو الحكم الذاتي في إشارة محتملة لصراع أقليات جديد.
ومع ذلك، يغيب عن الأذهان، وسط هذه العناوين الرئيسية اللافتة، التقدم البسيط والهادئ الذي تشهده مناطق عديدة من البلاد، حتى تلك التي تهيمن عليها الأقليات. وتبرز مدينة واحدة على وجه الخصوص: سلمية.
تقع سلمية على الحافة الغربية للصحراء السورية، وهي مدينة نائية وغير مميزة نسبيًا من نواحٍ عديدة. فهي لا تضاهي روعة ومعالم المراكز الحضرية الكبرى في البلاد، كما أنها لم تكن مسرحًا لأي من المعارك الضارية التي دفعت بالعديد من المدن المغمورة إلى الصدارة خلال الحرب. ولكن هذه الحقيقة الأخيرة تحديدًا، إلى جانب التركيبة الدينية والطائفية للمدينة، تجعل سلمية جديرة بالاهتمام.
تقول علا الجندي، ناشطة محلية تبلغ من العمر 51 عامًا: “كانت سلمية أول مدينة ذات أغلبية غير سنية تثور ضد الأسد، وأول مدينة تُحرر خلال الهجوم الأخير”. الجندي، كغيرها من أهالي سلمية، “إسماعيلية“، تنتمي إلى طائفة إسلامية انحرفت عن المذهب الشيعي السائد منذ أكثر من ألف عام. وقد اتخذ الإسماعيليون، المرتبطون بالخلافة الفاطمية و”جماعة الحشاشين“، سلمية موطنهم الرئيسي في سوريا منذ منتصف القرن التاسع عشر. واليوم، تُعد سلمية أكبر مركز للإسماعيليين في العالم العربي.
ومع ذلك، فهم ليسوا سكان المدينة الوحيدين. من بين 100,000 نسمة، يقدر السكان المحليون أن نصفهم فقط هم من الإسماعيليين: أما السكان الآخرون فهم منقسمون بالتساوي تقريبًا بين المسلمين السنة، والمجموعة المهيمنة في سوريا، والعلويين. على الرغم من ذلك، تجنبت المدينة المذابح الطائفية والصراع الواسع النطاق منذ بداية الحرب حتى الوقت الحاضر. لكن هذا لا يعني أنها تجنبت قمع الاحتجاجات المناهضة للأسد التي اندلعت ضد الحكومة في عام 2011. باعتبارها واحدة من أولى المدن التي تظاهرت ضد الأسد، كانت سلمية أيضًا واحدة من أولى المدن التي عانت من الأعمال الانتقامية.
تقول الجندي بفخر: “بدأت الاحتجاجات في السلمية في 25 آذار، وهو اليوم الذي بدأت فيه الثورة حقًا. رأينا أن دولًا أخرى في العالم العربي قد قامت، وكنّا نريد نفس الحقوق لأنفسنا. لكننا كنا نرغب في القيام بذلك بالطريقة الصحيحة. منذ البداية، كنت أُنسق لافتاتنا التي سنحضرها للاحتجاجات. كان يجب أن تكون محددة، مع مطالب سياسية فقط. لم يكن لدينا أي شعارات دينية أو طائفية.”
بعد عقود من الخوف، كان شعور الحرية في تلك الأيام الأولى ساحراً. تقول الجندي: “في المظاهرة الأولى، كنا لا نزال هادئين، خائفين”. “ثم في المظاهرة الثانية، بعد أن لم تعتقلنا المخابرات جميعًا، اكتسبنا بعض الشجاعة. في المظاهرة الثالثة، بدأتُ بالصراخ، مطالبةً بحق التحدث عن السياسة علانيةً في هذا البلد. كان ذلك في شارع لم نجرؤ حتى على التحدث فيه بهدوء من قبل. بعد ذلك، لم أُرِد أن أفقد هذا الشعور مرة أخرى”.
ردّ نظام الأسد بهدوء في البداية. نُظّمت بعض الاحتجاجات المضادة، حيث رفع المتظاهرون صور بشار الأسد ووالده حافظ. بحلول شهر أيار، كانت الاعتقالات الأولى قد بدأت، لكن الاحتجاجات استمرت في التزايد خلال الصيف. كان هذا الزخم المتزايد هو ما دفع النظام إلى اللجوء إلى أساليب أكثر صرامة.
تقول الجندي، في إشارة إلى الحملة العسكرية في تلك المدينة المجاورة، عاصمة المحافظة، في يوليو/تموز 2011: “هاجموا الاحتجاجات في حماة أولاً. ثم نشروا قواتهم هناك. وبدأوا باعتقال الجميع”.
في ذلك الوقت، بدأت أول مقاومة مسلحة منظمة للنظام بالظهور. وفي محاولة للحفاظ على الأقليات في البلاد إلى جانبها، لجأت الحكومة إلى الدعاية الطائفية.
تقول الجندي: “حاول النظام إقناعنا بأن الثوار جميعهم جهاديون. كان مخبريهم وعملاؤهم يخبروننا أن الإسلاميين السنة يريدون فرض الحجاب علينا، وإخراج بناتنا من المدارس. أرادوا أن نكون ضد بعضنا بعضاً، لا ضدهم”.
أُلقي القبض على الجندي نفسها لأول مرة في مارس/آذار 2012، واحتُجزت لمدة خمسة أيام قبل إطلاق سراحها. بعد اعتقالين آخرين في غضون شهرين، قررت الفرار من البلاد – من أجل أطفالها، أكثر من نفسها. ذهبت إلى لبنان، حيث بقيت هناك لمدة 12 عامًا.
*مواد ذات صلة:
مع تراجع قبضة نظام الأسد على البلاد، وجدت سلمية نفسها في موقع استراتيجي. سقطت أجزاء من الطريق السريع “إم -M5″، وهو الطريق السريع الحيوي الذي يربط العاصمة السورية دمشق بثاني أكبر مدن البلاد، حلب، في أيدي فصائل الجيش الحر الذي انشق عن جيش النظام. جعل هذا من سلمية النقطة الوحيدة التي تربط نصف مدينة حلب الخاضع لسيطرة النظام بالعاصمة والساحل، عبر طريق صحراوي ناءٍ. وباعتبارها شريان حياة رئيسي للنظام في معركة قد تُحسم الحرب، بدت المدينة مهيأة لأن تصبح هدفًا للثوار وساحة المعركة الحضرية التالية. إلا أن المعركة لم تبدأ، نتيجة، جزئيًا على الأقل، لجهود مقاتلي المعارضة المحليين لإبعاد المدينة عن قائمة الأهداف.
لم تكن سلمية مصدرًا رئيسيًا للقوى البشرية الثائرة مع نمو المعارضة المسلحة عام 2012، لكنها أنتجت مقاتلين. أبو حسن، وهو من مواليد قرية على أطراف المدينة، هو واحد منهم. (أبو حسن هو اسمه الحركي؛ وبصفته عضوًا في جهاز الأمن العام التابع للحكومة الجديدة، فهو غير مخول له بالتحدث إلى الصحفيين).
يقول أبو حسن، متحدثًا عن مجموعة صغيرة من الأصدقاء الذين انضم معهم إلى ثوار سوريا: “لم يكن هناك سوى 10 أو 15 منا في الأيام الأولى. كنا نختبئ في مزرعة، ولم يكن بيننا سوى بندقية واحدة في البداية. كنا نعتمد على طعام القرويين المحليين للبقاء على قيد الحياة”.
يقول إن أبو حسن ورفاقه سرعان ما انضموا إلى لواء الفاروق – وهي جماعة مسلحة تشكلت في وسط سوريا – ضمن “حوالي 200 شخص” من سلمية وضواحيها للانضمام إلى الثوار. كانت معركته الأولى في فبراير/شباط 2013، خلال الهجوم على مدينة الطبقة الخاضعة لسيطرة النظام.
يقول عن تلك التجربة الأولى للقتال: “كان الخوف لا يُطاق تقريبًا. خسرنا الكثير من الناس في تلك المعارك المبكرة، لكن من نجوا اكتسبوا الخبرة”. وسرعان ما شارك في حملات في أنحاء شمال غرب سوريا، أحد أعنف ساحات الحرب.
مع احتدام معركة حلب، حرضت بعض الجماعات المسلحة على شن هجوم على سلمية. يقول أبو حسن إنه وسكان محليون آخرون عارضوا مثل هذا الإجراء، ونجحوا في النهاية.
يقول: “كان هناك من أراد مهاجمة سلمية، لإسقاط النظام وقطع صلته” بحلب. كان أبو حسن، وهو من عائلة سنية إسماعيلية مختلطة، قلقًا بشأن بعض الجماعات الأخرى، بما في ذلك تلك التي تنحدر من خلفيات متطرفة في مناطق أخرى من البلاد، بالإضافة إلى المقاتلين الأجانب. ويضيف: “لم تكن جميع الفصائل متسامحة في آرائها. سلمية منطقة أقلية، ولم نكن نريد للفصائل المتطرفة الوصول إليها. تمكنا من إقناع إخواننا بتركها وشأنها”.
في هذه الأثناء، كان سكان محليون آخرون يمارسون نفوذهم على الجانب الآخر من الصراع، ساعيين قدر استطاعتهم لإبعاد جيش الأسد عن سلمية – وإبعاد سكان سلمية عن الجيش.
كما هو الحال في بقية أنحاء سوريا، كانوا خاضعين للخدمة العسكرية الإلزامية، وهي تجربة بغيضة ومهينة تُعلي من شأن الولاء للعائلة الحاكمة على أي فائدة عسكرية. كان زينو زينو في الرابعة والعشرين من عمره وفي منتصف خدمته العسكرية عندما اندلعت المظاهرات الأولى في دمشق، حيث كانت وحدته متمركزة.
يقول زينو عن الاحتجاجات: “كنتُ معارضًا للنظام بالفعل، لثلاث أو أربع سنوات آنذاك، لكنني لم أتخيل يومًا أننا سنشهد شيئًا كهذا. كان الأمر مذهلًا. أخذتُ إجازة في عطلة نهاية الأسبوع وشاركتُ في إحداها. في تلك اللحظة، كنتُ أعلم أنني سأبذل قصارى جهدي لإسقاط هذا النظام”.

- مع اتساع رقعة الثورة، خطط زينو للانشقاق حالما تسمح الظروف بذلك. وكان أحد أصدقائه يُشاطره الرأي، لكن بخطة أكثر جرأة. يقول زينو: “في تلك المرحلة، كان النظام يستخدم وحدة خاصة لقمع الاحتجاجات. كانوا يتنقلون من مدينة لأخرى، فقررنا نصب كمين. انتظرناهم على الطريق السريع من دير الزور إلى تدمر، في يوليو/تموز 2012. بمجرد اقترابهم، هاجمناهم. لم تكن لدينا سوى أسلحة خفيفة، لكننا مع ذلك ألحقنا بهم أضرارًا جسيمة”.
نفذ زينو وفريقه كمينين آخرين على قوات النظام خلال الصيف. في الكمين الثالث والأخير، فوجئوا هم أنفسهم بتعزيزات حكومية – وهو تطور أدى إلى مقتل صديقه.
يقول زينو: “اضطررت لدفنه بنفسي في الصحراء ثم إخبار والدته بما حدث”. كان أسوأ يوم في حياتي. بعد ذلك، ألقيتُ سلاحي جانبًا وقلتُ إنني لن أمسك به مجددًا، لأن غضبي ورغبتي في الانتقام ستدفعني إلى فعل أي شيء. لذلك، قررتُ أن أسخّر كل طاقتي وقوتي لدعم الثورة سلميًا.
بعد أن ترك زينو ساحة المعركة، عاد إلى سلمية، حيث عاش مختبئًا طوال 12 عامًا. غيّر مظهره واستخدم اسمًا مستعارًا، وبدأ يستخدم معارفه الذين ما زالوا في الجيش لمساعدة الآخرين على الانشقاق.
يقول زينو: “يعلم الجميع أن أي شيء وأي شخص قابل للشراء في سوريا الأسد، حتى في الجيش”. “لذلك، عندما كان أحدهم يتصل بي راغبًا في الانشقاق، كنت أجمع بعض المال لأرشي قائدًا في وحدته حتى يتمكن من الذهاب في إجازة. ثم كنا نتواصل مع أشخاص من المعارضة، ونخبرهم بقدوم منشق، حتى يتمكن من القيام بذلك بأمان. وحسب إحصائي، ساعدت 63 شخصًا على ترك الجيش بهذه الطريقة”.

تمكن زينو من تحقيق هذا التأثير على الرغم من كونه عسكرياً أدنى رتبة في الجيش. ومن بين الضباط الذين يرأسهم، كان هناك آخرون من سكان سلمية يبذلون جهودهم الخاصة.
قصي الجراكي، 57 عامًا، هو الآن عضو في المجلس الإسماعيلي في سلمية، وهو هيئة روحية وعلمانية مجتمعية قائمة في المدينة منذ عام 1920. قبل انضمامه إليه قبل بضع سنوات، كان عسكريًا محترفًا، يخدم في القوات الجوية، وهي نفس الجهة التي صعد منها حافظ الأسد إلى السلطة.
يقول الجراكي: “انضممت إلى الجيش لأول مرة عام 1988. في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى أن تكون ضابطًا على أنه منصب محترم. بالطبع، لم يكن هذا هو الحال في الواقع. كان الجيش فاسدًا للغاية، بشكل سيئ، وطائفيًا. لكنها كانت مهنتي، لذلك بقيت فيها”.
بحلول الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات عام 2011، كان الجراكي قد ارتقى إلى رتبة رائد، وكان مقره في بلدة قطنا التابعة لدمشق. وسرعان ما طُلب من وحدته المشاركة في تفريقها. لكن الجراكي امتنع، مُعرّضًا نفسه لمخاطر كبيرة.
يقول: “تذرّعتُ ببعض المسائل الإجرائية لفترة، قائلاً إنه “لا يوجد أمر مباشر باستخدام الذخيرة الحية” وما شابه. نجح الأمر لفترة، لكنني استُدعيتُ للاستجواب عدة مرات. بدأ النظام يشكّ في ولائي، لكنهم لم يعتقلوني، ربما لأنهم لم يرغبوا في عزل طائفتي” من الإسماعيليين.
ازداد الضغط على عائلته، وكذلك التهديدات المُبطّنة. في أحد الأيام، عاد الجراكي إلى منزله ليجد دبابة متوقفة بجانبه، تُخيف ابنتيه الصغيرتين. أعادهما للعيش مع أفراد آخرين من عائلته في السلمية، لكن النظام منع زوجته من مغادرة دمشق مع اشتداد العمليات العسكرية.
يقول الجراكي، متحدثًا عن القتال العنيف بين النظام وعناصر الجيش الحر المتحصنين في الضواحي الشرقية للعاصمة: “في تلك المرحلة، كان حصار الغوطة الشرقية مستمرًا. تمكنتُ من المساعدة في تهريب الأسلحة وتقديم العون للمعارضة هناك. كنتُ أعرف بعض جنود الحكومة الذين يديرون نقاط التفتيش”.
ونظرًا لشكوك حول ولائه، نُقل الجراكي في النهاية إلى منصب إداري. حاول الاستقالة من الجيش عدة مرات، لكن استقالته قُبلت أخيرًا عام 2022. عاد إلى مسقط رأسه، وانضم إلى المجلس الإسماعيلي، ولعب دورًا في نهاية حكم الأسد، مما أعاد إحياء قصته.
مع شنّ الفصائل المسلحة هجومهم الأخير في تشرين الثاني الماضي، اجتاحوا بسرعة دفاعات النظام، وسيطروا على حلب في غضون أيام، وتقدموا نحو مدينة حماة. وبينما كانوا يتقدمون عبر الصحراء، اقترب المقاتلون من السلمية.
لكن لن تكون هناك معركة هنا. المدينة تنتظرهم بالفعل. يقول الجراكي: “كنا على اتصال بالفعل عندما اقتربوا من المدينة”. “نسق المجلس الإسماعيلي كل شيء. أخبرناهم بموقع نقاط تفتيش النظام، حيث يمكنهم دخول المدينة. في تلك الليلة، 5 ديسمبر/كانون الأول، دخلوا تحت جنح الظلام. جنود النظام إما هربوا أو استسلموا – لم تكن هناك دماء”، كما يقول.
كان أبو حسن على الجانب الآخر. بحماس متزايد وشعور غريب بعدم التصديق، شاهد دفاعات النظام في شمال سوريا تنهار. شارك في محادثات التسليم السلمي للسلمية قبل أن يدخلها بنفسه في 6 ديسمبر/كانون الأول، بعد يوم واحد.
يقول أبو حسن: “خلال 10 سنوات، لم أشعر بالخوف حتى ذلك الأسبوع الأخير”. مع اقترابنا من السيطرة على حماة، كل ما كنت أفكر فيه هو: لا أستطيع الموت الآن، وقد اقتربنا كثيرًا. ثم سيطرنا على المدينة، وكنت عائدًا إلى سلمية، إلى منزل وعائلة لم أتوقع أن أراهما مجددًا. بكيت طوال طريق العودة.
لم يمضِ وقت طويل حتى عادت الجندي من منفاها. فبعد أيام قليلة من فرار الأسد من البلاد في 8 ديسمبر/كانون الأول، عبرت الحدود اللبنانية عائدةً إلى سلمية.
تقول الجندي: “قضيتُ كل هذه السنوات في شتورة، على بُعد كيلومترات قليلة من سوريا. لكنها كانت بعيدةً جدًا. ما زلتُ أشعرُ بغرابة عودتي إلى هنا. عليّ أن أذكر نفسي أنني لستُ في حلم”.
في الأشهر التي تلت سقوط النظام، لم يكتفِ سكان سلمية بذلك. فلطالما تمتع المجتمع المدني في المدينة بإرث عريق، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى مؤسسة الآغا خان، الذراع الخيرية للزعيم الروحي الإسماعيلي الثري، الآغا خان، الذي استثمر كثيراً في سلمية. وواصلت مجموعات أخرى، مثل المجلس الإسماعيلي، أنشطتها، بينما وُلدت مجموعات جديدة. وتُعقد بانتظام حلقات نقاش، حيث يمكن للسكان المحليين التعبير عن مخاوفهم وآمالهم، إلى جانب وجهاء محليين، يسافرون بعد ذلك إلى دمشق لإجراء محادثات مع السلطات الجديدة. ويُبذل جهد واعٍ لكسب تأييد جميع شرائح سكان سلمية، سواءً كانوا إسماعيليين أو سُنة أو علويين.
الأهم من ذلك كله، أن الحفاظ على تقاليد سلمية الراسخة في تجنب سفك الدماء والطائفية يبقى أمرًا بالغ الأهمية. إذا أُريد لسوريا الجديدة أن تكون قصة نجاح، فربما تكون سلمية مثال عليها.
تقول الجندي: “لم نسمح للنظام بتفريقنا طوال هذه السنوات. لقد انتهى الجزء الأصعب من الصراع، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنقوم به. يجب ألا نخسر كل ما كسبناه ونحن نبني البلد الذي لطالما تمنيناه”.