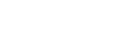أولاً: مقدمة
قد يكون محرجًا بعض الشيء أن يجري تناول الوضع السوري وسياسات النظام الحاكم الداخلية والخارجية، قبل تاريخ انطلاق الثورة السورية، من حيث إن الكلام في هذا السياق يصبح نافلاً بعد كل التغيرات التي حصلت في واقع هذا البلد وأحوال شعبه والبيئة الإقليمية والدولية المحيطة به.
وربما بدا أنّ بعض المعلومات في هذا الكتاب فات أوانها. لكنّ بعض الأبحاث المنشورة تقدم رؤية تسجيلية مهمة في تفسير ما حدث بعد آذار/مارس 2011، وبعضها الآخر يقدم رؤية استشرافية اكتشفناها واضحة خلال السنوات الأربع الأخيرة. فحاولت الفصول العشرة في هذا الكتاب كشف بعض الغموض والمفارقات التي تتصف بها الشؤون الداخلية والخارجية الخاصة بسورية وفقًا لما أتيح لكتابها من معلومات ومصادر، واستنادًا إلى نقاشات وحوارات ومقابلات أتيح لهم القيام بها. وعلى العموم تقدم هذه الأبحاث فهمًا أوسع للديناميات والمرتكزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة لا يزال يحكمها نظام يسير عكس منطق التاريخ.
سنحاول في هذه المقدمة ربط الماضي القريب الذي تتحدث عنه فصول الكتاب بالحاضر المكثف في السنوات الأخيرة ما بعد آذار/مارس 2011، في محاولة متواضعة لفهم الماضي والحاضر معًا. فعلى الرغم من أن الكتاب يكشف بفصوله العشرة جانبًا من الغموض في بنية النظام السوري وعلاقاته الاقتصادية وتحالفاته الخارجية ويتعرض لتاريخ المعارضة السورية خلال السنوات الثماني الأولى من حكم بشار الأسد، إلا أن السنوات الأخيرة كشفت الكثير مما كان يبدو غامضًا أو غير مفهوم آنذاك.
فمع الثورة السورية أصبح النظام السوري مكشوفًا بالكامل، بوصفه نظام طغمة مستعدة لفعل كل شيء في سبيل البقاء في الحكم، ونظامًا يعتاش على السطوة الأمنية واللعب على تناقضات العلاقات الخارجية. وربما يصدق القول إن كثيرًا من أطراف المعارضة كانت جاهلة بالنظام وعلاقاته، وبالمدى الذي يمكن أن يصل إليه في ممارساته، فضلاً عن قراءتها الخاطئة لتحالفاته الدولية، وللعلاقات الإقليمية والدولية بشكل عام، وهو الأمر الذي جعلها تقدم خطابًا سياسيًا انفعاليًّا وغير عقلانيٍّ، ومندرجًا في إطار تحالفات وهمية وغير منتجة.
ينتقد محرِّر الكتاب فريد اتش لاوسن (Fred H. Lawson) في مقدمته أولئك الذين يصفون الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية لسورية بـ «الغامضة»، «المربكة» أو «الغريبة»، على الرغم من إقراره بأن هذه التوصيفات تبدو صائبة في بعض الأحيان. ويبني نقده على أساس أن هناك من ينطلق أصلًا من فكرة عدم التعاطف مع النظام السوري، كما أن هناك من لا يريد أن يبذل الجهد في سبيل استكشاف هذا الغموض، وأخيرًا لا ينفي الكاتب دور النظام السوري ذاته ورغبته في إضفاء الغموض على سياساته، ربما طمعًا بالهيبة أو الأهمية[1].
ربما يكون ذلك صحيحًا في بعض الحالات، لكن بالعموم تعتبر سياسات النظام السوري غامضة بالفعل، وليس في ذلك غرابة، فتلك طبيعة الأنظمة الاستبدادية التي تحرِم باحثيها ومثقفيها، وشعبها كله، من مصادر المعلومات ووسائل المتابعة، وتبعد كافة الهيئات الحكومية والمدنية عن المشاركة في إبداء الرأي واتخاذ القرار، فالسياسة الخارجية السورية كانت لعدة عقود شأنًا خاصًا من شؤون رئيس الجمهورية، لا يفهمه حتى من هم في مراكز صنع القرار العليا.
ومن الجدير بالذكر أن الأبواب كانت مفتوحة نسبيًا للباحثين الأجانب إلى مصادر المعلومات للاطلاع والتحليل، فيما كانت موصدة على الدوام أمام السوريين. وهنا لا يُستغرب القول إن الغرباء أكثر اطلاعًا على أحوال البلد الاقتصادية وسياسات النظام الحاكم وعلاقاته من أهل البلد. ويُضاف إلى ذلك أن النظام السوري لا يمتلك مؤسسات حقيقية لصنع القرارات السياسية والاقتصادية، ويحصرها في أضيق نطاق ممكن. ولا وجود لإعلانات أو مواثيق رسمية توضح ثوابت السياسة السورية في الداخل والخارج، باستثناء الكلام العام والخطاب المكرّر حول القضايا العربية القومية وقضية فلسطين وممانعة الإمبريالية، فهي رهن الفرد الحاكم فحسب، ووظيفتها واحدة ومحدّدة، وهي ضمان استمرار نظام الحكم الاستبدادي. وهنا من المتوقع بدهيًا أن نشهد سياسات مبهمة وغامضة من حيث كونها متناقضة أيديولوجيًا وسياسيًا واقتصاديًا، لكن الواضح أن هدفها كان واحدًا على الدوام، وهو استمرار النظام الحاكم.
تدور فصول الكتاب العشرة في ثلاثة محاور رئيسة هي: النظام السوري، والمعارضة السورية، والعلاقات الخارجية. وسنقوم في المقدمة باستعراض أهم الأفكار الرئيسة في كل فصل، وتقديم نقد لبعض الأفكار الواردة من وجهة نظرنا، إضافة إلى استكمال قراءة هذه المحاور من خلال قراءة وقائع السنوات الأخيرة.
ثانيًا: بنية النظام السوري
1- أسس الشرعية الداخلية
لعل أفضل ما يمكن وسم نظام الأسد به – بحسب تعبير فولكر بيرتس (Volker Perthes) – هو أنه «نظام رئاسي تسلطي بملامح وراثية واضحة. فالنظام تسلطي بمعنى أن السلطة السياسية فيه متمركزة بشكل شديد، ويؤدي العسكريون والبيروقراطيون في هذا النظام دورًا طاغيًا، في حين إن مساحة التنافس التعددي والمجتمع المدني محدّدة تحديدًا ضيقًا، علاوة على أن المشاركة السياسية ما هي، في أحسن الأحوال، إلا هبّة اصطفائية. وإن الدور الذي تؤديه شخصية الرئيس، هو التوجه الملحّ لتأمين المصالح السياسية، فضلاً عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية لشبكات الاستزبان من الزبانية وهم الشرطة، وزبنه: دفعه […]، والأهمية الكبيرة المنوطة بالعلاقات والولاءات الشخصية، التي تكون تقليدية أو بدائية في أكثر الأحيان، تضفي كلها على النظام وجهه الوراثي»[2].
نظام الأسد هو نظام شديد التمركز، يحصر جميع السلطات السياسية والاقتصادية والقضائية في يد فرد واحد هو رئيس الجمهورية، لذا كان بدهيًا أن يبنى النظام برمته على فكرة تقديس هذا الفرد وعصمة. فضلاً عن ذلك، قامت ظاهرة عبادة الفرد بدور الآلية الرئيسة في إدارة النظام السياسي والاقتصادي، وتحديد وضبط سلوك الأفراد والفئات في المجتمع السوري. لذلك كانت ظاهرة تقديس الأسد بمثابة «إستراتيجية للسيطرة، قائمة على المطاوعة بدلاً من الشرعية. وينتج النظام تلك المطاوعة من خلال المشاركة الإجبارية في طقوس الامتثال الزائفة بجلاء، سواء لأولئك الذين يخترعون هذه المظاهر أو لأولئك الذين يستهلكونها»[3].
وبالتالي، كان من المتوقع لدى كثيرين أنه ليس من السهل، بعد نظام حكمٍ قام على تقديس حافظ الأسد، الانتقال إلى تقديس ابنه. فعبادة الشخصية التي بنيت حول حافظ الأسد على مدى عقود كانت، بحلول أجله «قد كسفت تمامًا الشخصيات الأخرى في السياسة السورية، بحيث تمت ترجمة وفاته على أنها مؤشر احتمالي إلى انحلال نظام الحكم بأكمله في سورية»[4]. لكنّ تلك الاحتمالات المتنبأ بها لم تحدث، إذ «لم يمض سوى أيام قليلة على وفاة حافظ الأسد حتى تحركت النواة الداخلية للنظام لاصطناع مشهد مهيب للخلافة، بغرض تكريس بشارًا رئيسًا على طراز يتمشى مع النظام الملكي أكثر من النظام الجمهوري»[5].
بعد وفاة حافظ الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، تحركت بالفعل النواة الصلبة للنظام، ورتبت الضرورات الدستورية لانتقال السلطة بسلاسة إلى ابنه بشار الأسد الذي جرى إعداده على مدى سنوات بعد وفاة شقيقه الأكبر باسل الأسد. وحاز بشار، رسمياً على الأقل، القدر نفسه من السلطة الذي كان لوالده، لكنّ «آثار الأقدام التي تركها والده كانت كبيرة عليه بعدة درجات، الأمر الذي ما كان ليختلف مع أي خلف آخر»[6]. لكن هذا الأمر أعطي الاهتمام الكافي في ما بعد، من أجل إعادة إنتاج ظاهرة تقديس الشخصية الضرورية لاستمرار نظام بني أصلاً على هذه الركيزة التي تحدِّد بالمحصلة المسموح والممنوع في المجتمع، وتعيد ترتيب وظائف أجهزة الدولة كافة، وأدوار الفئات الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على القوى السياسية.
كما طرح بشار الأسد شعارات عديدة خلال سنوات حكمه بهدف بناء «شرعيته» الناقصة بالضرورة، والتي اعتمدت فحسب على «شرعية» والده، وبدأها بشعار «الاستمرارية والتغيير»، ثم «التطوير والتحديث». إلا أن التوصيف الحقيقي لمشروعه برمته قد جاء على لسان رايموند هينبوش، إذ يمكن فهم مشروع بشار على أنه «عصرنة الاستبداد، أي تحسين عمل النظام بحيث يمكنه البقاء والاستمرار وتوليد التنمية الاقتصادية لضمان قاعدة النظام الاقتصادية»[7]. وهذا يعني أنه استمر ينهل من المصادر ذاتها التي بناها أو أسسها والده، سواء على مستوى الخطاب أو التحالفات، مع إجراء بعض التحسينات الشكلية التي توحي بحدوث تغيير في النظام.
ولعل أهم المصادر التي استمد منها النظام السوري شرعيته طوال أربعة عقود قد اعتمدت على: الخطاب المناصر للقضية الفلسطينية، الخطاب العروبي، «علمانية النظام»، حماية الأقليات الدينية، الأمن المحلي، التوازن الاجتماعي، وأضيف لها في عهد بشار الأسد الفوضى في العراق وما حملته من تعزيز وتحصين للنظام في وجه الخارج.
لقد قدم النظام السوري نفسه في عهدي الأسد الأب والابن على أنه الحامي للقضية الفلسطينية، فكان لا يكل من الادعاء بأن القضية الفلسطينية هي قضيته الخاصة، اعتقادًا منه أنه من السهل الفوز بتأييد الشعب من أجل هذه القضايا، وبالتالي إلهاؤه عن المشاكل السياسية والاقتصادية في البلاد. كما كانت قضية «الوحدة العربية» من القضايا الأساسية التي ارتكز عليها خطابه السياسي، خصوصًا أنه كان يحكم باسم حزب البعث، الحزب القائد للدولة والمجتمع، الذي جعل من هذه الوحدة هدفه الأول. وقد ظل رؤوس النظام يؤكدون على توجههم العروبي على الرغم من أن حزب البعث كان من الخاسرين الأساسيين في حصيلة نظامٍ حكم أكثر من أربعة عقود. فالحزب تعرض إلى تجريد تدريجي من قيادته الأيديولوجية والسياسية منذ انقلاب عام 1970، على الرغم من أن هلهلة الحزب لم تبدأ إلا في النصف الثاني من عقد الثمانينيات، إذ تكشفت على أوضح ما يكون بفشله في عقد مؤتمر قطري بعد مؤتمر عام 1985 إلى أن عقد المؤتمر القطري التاسع في دمشق من 17 إلى 21 حزيران/يونيو 2000.
وكان النظام السوري في محطات عديدة يشدِّد على «علمانيته» في مواجهة التيارات الإسلامية، وكنقطة فخر إزاء عدد من الدول العربية، إلى جانب الحصول على رضى الأوروبيين والأميركيين كلما فكروا بزعزعة نظامه. مع ذلك، دعّمت هذه الصورة شرعية النظام في الداخل، ولا سيّما في أوساط الأقليات الدينية في سورية، إذ كان «الخوف من الأسلمة بعد ثورة عنيفة (حوادث 1979-1982)، من المحتمل أن يمولها المتشددون السعوديون بدولارات النفط، يمثِّل ورقة رابحة في أيدي العلويين الحاكمين ومؤيديهم العلمانيين»[8]. وتبقى مسألة ما إذا كان هذا الخطر مبالغًا فيه، مسألة رأي، لكنه يظل مصدرًا قويًا لشرعية النظام.
تعزّزت هذه الصورة للنظام بعد الاحتلال الأميركي للعراق في نيسان/أبريل 2003، فكانت لفشل قوات الاحتلال الأميركي في كسب ثقة الشعب العراقي، والكارثة الأخلاقية الناتجة من صور سجن أبوغريب الذي يديره الأميركيون، والشك المتعاظم حول مستقبل العراق، أصداء تصب في مصلحة النظام السوري. لقد عزّزت الحرب فعليًا مواقع النظام السوري بعد أن غرق العراق في الفوضى والحرب الأهلية، و«أصبحت حقيقة أن سورية جاذبة للأقليات في المنطقة أكثر تأكيدًا بعد حرب العراق. إذ راح المسيحيون الذين يعيشون بين دجلة والفرات يتدفقون بالآلاف هربًا من العنف اليومي في العراق، ليستقروا في دمشق أو على ساحل المتوسط»[9].
وعلى الرغم من حرصه الشديد على صورته «العلمانية»، إلا أن النظام كان حريصًا بالمقابل على إحاطة نفسه برجال دين موالين، لما للدين الإسلامي من دور في كسب الشرعية لدى فئات اجتماعية واسعة في سورية. ففي الفصل الرابع من هذا الكتاب: «سياسة رجال الدين السُّنّة في مدن سورية البعثية»، يرى كاتبه توماس بيريه (Thomas Pierret)، أن النظام السوري قمع الناشطين الإسلاميين العلمانيين، لكنه سعى في سبيل الحصول على الشرعية إلى توسيع قاعدة دعمه من خلال إفساح الحرية بشكل أوسع لبعض الاتجاهات الدينية الموالية، إذ كانت إستراتيجية النظام المفضلة لإدارة النخبة السُّنية هي استقطاب الشخصيات البارزة التي تمتلك قاعدة اجتماعية حقيقية. لذا احتل بعض رجال الدين السُّنّة مكانة مهيمنة في الساحة السورية، على غرار المفتي السابق أحمد كفتارو، والمفتي الحالي أحمد حسون، والعلامة ذي الأصول الكردية محمد سعيد رمضان البوطي، الذي يُعتبر كبير الوسطاء بين النظام ورجال الدين السُّنّة، وتبوّأ بسبب ذلك منزلة «بابوية» من نوع ما. وقام البوطي بهذه الأدوار بشكلٍ رئيس مذ أعلن دعمه الصريح للنظام إبّان انتفاضة 1979-1982، وكان لدوره آنذاك أهمية كبيرة بسبب مكانته الشخصية. وتكرر دوره هذا في كل مرة كان النظام يواجه فيها أزمة ما، وآخرها التهديد الجدي لسلطة النظام بعد انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011.
ومن خلال تغييب النظام الإطار الوطني العام انقسم رجال الدين في سورية بحسب الهويات الإقليمية. كما يتضح من العداء الذي يُضرب به المثل بين دمشق وحلب، إذ لا يزال الشعور به حاضرًا بعمق في العلاقات بين النخب الدينية للمدينتين. كما تعامل النظام مع الشبكات الدينية القائمة التي كان رأسمالها الاجتماعي نتيجة آليات بعيدة في معظمها عن متناول الدولة. ولذلك «لم يكن من وسيلة للتعبير عن السياسية الدينية الرسمية سوى ما يتعلق بالاختيار: إذ جرت مكافأة الفاعلين المذعنين، ومسامحة أولئك المحايدين وقمع الاتجاهات المعادية»[10].
ومع مجيء بشار الأسد إلى السلطة، حافظ على العلاقات السابقة، وكان أكثر تساهلاً، فحاول تجاوز آثار حوادث 1979-1982 عندما بدأ بالتخلي تدريجًا وببطء عن السياق القمعي تجاه بعض الشخصيات الدينية، باستثناء حركة الإخوان المسلمين، فأفسح المجال لمزيد من حرية العمل في مجال التعليم، والأعمال الخيرية ووسائل الإعلام، كما سمح للقبيسيات بالعمل بهدف تحسين استقرار النظام وتوسيع قاعدته الاجتماعية. وتذكر سلوى إسماعيل في الفصل الأول من هذا الكتاب، عن أحد الصحافيين الذي تحقق من الظاهرة عن قرب، أن القبيسية تنشط في تجنيد زوجات وبنات كبار المسؤولين والتجار الأثرياء ورجال الأعمال. وتحضر المجندات المحتملات دروسًا منزلية لمريدات الشيخة منيرة القبيسي، وفي حال انضمامهن، يصبحن أعضاء في مجموعة تقوى في غاية التنظيم والصرامة[11].
يفاخر النظام ومناصروه أيضًا بحالة الاستقرار والأمن التي تنعم فيها سورية، على الرغم من أن هذه الحالة قد تكونت بفعل القمع وتعميم الخوف وسيطرة الأجهزة الأمنية على معظم مفاصل الحياة. فسورية دولة أمنية، ووفقًا لأحد التقديرات «هناك عنصر استخبارات لكل 153 سوريًا فوق سن الخامسة عشر، بحسب بيانات تعود إلى عام 2001»[12]. وصحيح أن الحضور العسكري الاستخباري قد عاد في زمن بشار الأسد خطوة إلى الوراء، وغاب عن الواجهة لمصلحة الحضور المدني، خصوصًا في سنوات حكمه الأولى، إلا أنه كان يعود ويطل برأسه في كل لحظة يتعرض فيها النظام للاهتزاز أو الخطر. ومرت محطات عديدة في عهده تؤكد هذا التوجه، فمثلاً عاد وتدخل عندما امتد ربيع دمشق وبدأ يتحول إلى ظاهرة مقلقة في عاميّ 2000-2001، وبعد حالة الحصار التي تعرض لها النظام بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكان آخرها حضوره الفج بعد انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011، إذ أطل على السوريين والعالم في أبشع حالاته، وكان عاريًا من جميع الشعارات التي كان يرتديها طوال نصف قرن.
ومن نقاط القوة التي دعمت شرعية النظام السوري واستمراريته محافظته نسبيًا على التوازن الاجتماعي وتأسيسه بالمقابل لتحالفات اقتصادية ضامنة له طوال عقود، فبقيت الهوة بين الفقراء والأغنياء مقبولة أو محتملة مقارنة بدول أخرى كمصر، لكن هذا التوازن بدأ يتعرض للاختلال تدريجًا مع سياسات التحرير الاقتصادي من دون شبكات أمان اجتماعية. ولا شك أن لهذا الاختلال دور في انضمام شرائح اجتماعية عديدة إلى الثورة السورية في آذار/مارس 2011. وسنتحدث في طبيعة هذا التوازن والتحالفات الاقتصادية وتبدلاتها وتخلخلها في الفقرة المقبلة من هذه المقدمة.
2- الاقتصاد السياسي السوري
أ- العلاقة بين النظام ومجتمع القطاع الخاص
تمتد جذور الإرث المرير بين الدولة ومجتمع الأعمال إلى كلٍّ من العوامل السياسية والاجتماعية الناجمة من نشوء وتطور نظام استبدادي شعبوي راديكالي. وقد تشكلت حالة من العدائية وسمت الاختلافات بين «البعثيين الأقلويين» الذين كانوا خاضعين تاريخيًا لـ «السادة» الذين ينتمون إلى النخبة السُّنية المدينية. واستمرت الحال على ذلك حتى انقلاب «الحركة التصحيحية» في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1970 الذي ضيَّق الانقسام بين القوى المحافظة المدينية والقوى الراديكالية الريفية.
في الفصل الثاني من هذا الكتاب: «موروثات باقية: سياسة تنمية القطاع الخاص في سورية»، يعرض بسام حداد (Bassam Haddad)، تاريخ العلاقة بين نظام البعث والقطاع الخاص، فيرى أنه ليس خفيًا أن صعود النظام ذاته بعد عام 1963 كان على حساب القطاع الخاص التقليدي أو ما يشار إليه بالبرجوازية «التقليدية» أو «القديمة». وعلى الرغم من تبدُّل إستراتيجية النظام نسبيًا في عام 1970، استمرت علاقة النظام بالقطاع الخاص برمته من خلال منظور أمني في أساسه، إذ أصبح النظام بعد «الحركة التصحيحية» في تشرين الثاني/نوفمبر 1970 أقل نزعة أيديولوجية، وأكثر براغماتية سياسيًا. كما أدرك نقاط ضعفه الاجتماعية والسياسية: فقد كان نظامًا راديكاليًا أقلويًا ريفيًا، معزولاً إلى حدٍّ بعيدٍ عن بقية المجتمع السوري، ووجد نفسه من جهة في حاجة إلى القطاع الخاص لتوليد العملة الصعبة وفرص العمل؛ لكنه من جهة ثانية كان غير راغب وغير قادر على مشاركة السلطة، وبالتالي، كان الحل الأمثل للنظام هو ترك القطاع الخاص ينمو بما يكفي لإنقاذ الاقتصاد، لكن ليس بما يكفي لتهديد احتكار السلطة. أي أن الإشكالية الأساسية بالنسبة إلى النظام كانت تكمن على الدوام في الاستفادة من الدور الاقتصادي للقطاع الخاص، لكن دون دفع ثمن سياسي[13].
وهذا يعني أن الاقتصاد السوري ظل محكومًا بالقرار السياسي لنظام الحكم، يحدّد دوره في كل مرحلة بما لا يسمح له بالتأثير في السياسة أو نمط الحكم. وكان من الواضح مقدار ارتباط أسلوب صنع السياسة الاقتصادية في سورية – ونتيجته إلى حدٍ كبيرٍ – بالبنية التسلطية للنظام، فعلى الرغم من تطوير هياكل معقدة للمؤسسات «فإن صنع السياسة الاقتصادية في سورية بقي مسألة مشخصنة إلى حدٍّ كبير. وتنطبق هذه السمة التي تعكس بوضوح بنية النظام السياسي الفاشية في سورية على كل مستويات الحكومة والقيادة. ومن العجب العجاب، مثلاً، عدم وجود فريق لتخطيط السياسة الاقتصادية، لا في الرئاسة ولا في مكتب رئيس مجلس الوزراء»[14].
في ظل حكم بشار الأسد، حدث تحول بسيط في التوجهات الأيديولوجية، مما سمح ببعض المرونة في موقف النظام في ما يتعلق باقتصادٍ يحركه السوق مقابل اقتصادٍ تسيطر عليه الدولة. ومع ذلك، لم تتغير مخاوف النظام الأمنية ومعادلته الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها. إذ وصل النظام إلى الإعلان عن «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وهو مصطلح يتناول ما يجب القيام به دون التخلي تمامًا عن ذرائع النظام الاجتماعية. وهكذا، في ظل حكم بشار الأسد، وبعد المؤتمر القطري العاشر الشهير لحزب البعث في حزيران/يونيو عام 2005، عندما تم توطيد سلطة القائد الجديد في كل من الحزب وأجهزة الأمن والجيش، نرى تكاثرًا في المصارف الخاصة، وتشريع التعامل بالعملة الصعبة، وتأسيس الشركات القابضة التي تمثل المصالح الخاصة «الجديدة».
في الفصل الأول: «تغيير البنية الاجتماعية، تغيير التحالفات الاستبدادية في سورية»، تذهب سلوى إسماعيل (Salwa Ismail) في بحثها نحو دراسة الأسس الهيكلية لنظام الاستبداد في سورية، والتحولات التي تخضع لها كنتيجة للتغيرات في القوى السياسية والاقتصادية، والتحالفات بينها، مع مرور الزمن، وبالتالي يحاول البحث أن يدرس سلوك النظام السوري في فتراته المتعاقبة باحثًا عن آلياته وتحالفاته بما يخدم هدفه الرئيس: استمرار نظام الحكم والإمساك بالقرارات السياسية والاقتصادية.
وقد رأى البحث أنه مع مجيء بشار الأسد إلى السلطة والسير خطوات في طريق التحرير الاقتصادي، بدأت في الوقت ذاته عملية إعادة اصطفاف جديدة للقوى الاجتماعية السياسية في سورية، فمن جهة يخضع التحالف التاريخي القائم بين النظام العسكري ذي الهيمنة العلوية وبين التجار السُّنّة لضغوطٍ متزايدةٍ، وقد يُصار إلى حلّه. ومن جهة أخرى، يجري إحياء تحالفات العصور السابقة، مثل التحالف بين الشيوخ والتجار الذي قد يساهم في مزيد من تفكك النظام.
وعلى الرغم من أن هناك بعض التغيير في بنية النظام وتحالفاته التي تجعله ممسكًا بالسلطة، إلا أن التحالفات الجديدة يمكن فهمها أنها تأتي في سياق تدعيم مواقعه في ظل بيئة متغيرة وليست على حساب التحالف التاريخي القديم، الذي ثبت أركان النظام في الحكم، بين ضباط الجيش «العلويين» وطبقة رجال الأعمال السُّنة من التجار، ولا سيّما المكوِّن الدمشقي، على الرغم من لجوء النظام إلى إجراء تعديلات في هذا التحالف، بقصد إبقائه على قيد الحياة مع تغير الأوضاع والأحوال. إذ إن طبيعة نظام الحكم لا تتوافق مع التغيرات السريعة في حقلي السياسة والاقتصاد بحكم خطورتهما بالنسبة إلى نظام فقير بالمؤسسات والبنى الشرعية التي تدعم وجوده، فالنظام كان مقتنعًا على الدوام بالتغييرات الطفيفة المحسوبة العواقب والمضبوطة، خصوصًا في ما يتعلق بالوضع الداخلي. وكان هذا التحالف أساسيًا لاستمرار النظام، ولا يستطيع المجازفة فيه حتى في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية في زمن بشار الأسد، إذ يمكن أن يقوم بتعديله بدلاً من إلغائه لمصلحة تحالفات جديدة غير موثوقة بعد.
تجلّى هذا التحالف في محطات عديدة على مدى العقود الثلاثة الماضية. إذ سعى النظام، مع ذهابه باتجاه التحرير النسبي للنظام الاقتصادي في عهد حافظ الأسد، إلى دمج بعض التجار المتوسطين مع استمراره في التنكُّر للعائلات «الأرستقراطية» المتبقية من الفترة العثمانية، وكانت عملية اختيارهم واستقطابهم محورية لتوطيد سلطة النظام، وكان الحدث الأبرز الذي عزز هذا التحالف في الثمانينيات عندما واجه النظام واحدة من أكثر أزماته خطورة، انتفاضة وطنية محتملة، وقف تجار حلب الكبار في طليعتها؛ ودعوا إلى إضراب شامل في البلاد، بما فيه إغلاق المحال والأسواق التجارية، وأظهر التجار معارضتهم العلنية للنظام واستعدادهم للالتحاق بالقوى الأخرى المناضلة ضده، وعلى رأسها الإخوان المسلمون والأحزاب اليسارية المحظورة. وكان من المتوقع أن ينضم التجار الدمشقيون إلى الإضراب، وكان يُعتقد بأن مشاركتهم ستؤدي إلى إسقاط النظام، لكن في حين أغلق تجار حلب محالهم التجارية، أبقى نظراؤهم الدمشقيون محالّهم مفتوحة. وإلى يومنا هذا، يعتقد العديد من المراقبين المحليين أن التجار الدمشقيين كان بإمكانهم إسقاط النظام إلا أنهم اختاروا ألا يفعلوا، ومنذ تلك اللحظة أصبح التجار الدمشقيون شركاء للنظام، واستمروا في التعبير عن ولائهم العلني[15]. فهذا التحالف التاريخي بين التجار الدمشقيين من السُّنة والنظام العسكري ذي القيادة العلوية هو أساس النظام السوري. ولكن ينبغي ألاّ يُفهم من هذا أن طبقة التجار قد انضمَّت إلى هذا التحالف بالجملة من دون استثناءات.
خلال عقد التسعينيات، وبدايات عهد بشار الأسد حصلت متغيرات مؤثرة، إذ صعد أبناء السلطة إلى واجهة العمل الاقتصادي، وهم الذين أثروا واستفادوا من مواقع السلطة والانفتاح الاقتصادي في آن معًا، لكن ذلك لم يؤثر على التحالف الرئيس مؤديًا إلى بدء انحلاله بحسب ما ترى كاتبة البحث، على الرغم من أن العائلات والعشائر المرتبطة بالنظام قد أصبحت من الفاعلين الاقتصاديين الكبار، وعلى الرغم من تضرّر بعض التجار الدمشقيين من أولاد السلطة كذلك.
وهكذا، فإن النظام في عهد بشار الأسد كان في سياق تعديل تحالفاته الإستراتيجية الرئيسة مع البرجوازية الوطنية وطبقة التجار التقليديين بحكم نشوء فئات جديدة أبرزها أولاد السلطة، ولم يسع إلى تقويض تحالفاته القديمة. لكن النظام في سياق تحرير الاقتصاد تخلى عن القاعدة الاجتماعية الواسعة دون تقويض الأطر الدولاتية (corporatist frames) القديمة، وهذا من شأنه أن يساهم في تقويض الأسس الهيكلية للاستبداد في سورية[16]، كما كان أحد الأسباب الرئيسة لتوسع رقعة الاحتجاجات التي بدأت في آذار/مارس 2011.
ب- تأثيرات التحرير الاقتصادي في عهد بشار الأسد
بعيدًا من «الطبقة الطفيلية» أو «المافياوية» أو أولاد السلطة، تبلورت تدريجًا مجموعتان من رجال الأعمال في عهد بشار الأسد. الأولى تتكون من التجار العريقين الذين تعود تقاليدهم إلى مئات خلت من السنين، ومن بينهم التجار في الأسواق القديمة، أما الثانية فتتكون من رجال الأعمال الجدد، ممن تلقى معظمهم تعليمه في الخارج أو أنهم يستجلبون رأسمالاً خارجيًا. هاتان المجموعتان كانتا تضغطتان بقوة في سبيل تحرير النظام الاقتصادي.
لقد تكونت مجموعة رجال الأعمال الجدد (المئة الكبار) تدريجًا في سياق إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، على أساس اقتصاد متوجه إلى الخارج وقابل للتعولم، وبحسب جمال باروت: «مثل مشروع الإصلاح المؤسسي، حين اختزل إلى تحرير اقتصادوي، الإطار السياساتي الذي أعيد فيه تكوين طبقة رجال الأعمال السورية، وبروز شريحة رجال الأعمال الجدد، الذين أسسوا (شركات قابضة) لقطف ثمار الاستثمارات الكبيرة المتدفقة على سورية في مرحلة الفوائض المالية الخليجية. وقد برزت فاعلية هذه الشريحة في قيادة التوسع في مجال القطاعات العقارية والسياحية والمالية الخدمية بدلاً من قطاعات الخدمات الإنتاجية، عبر (التحالف) مع رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية، وفق قاعدة مركز العجلة وأذرعها»[17].
عمل النظام السوري على اختزال الإصلاح الذي طرحه في بدايات حكم بشار الأسد إلى إصلاح اقتصادي فحسب، كي لا يضطر إلى دفع ضريبة سياسية تجبره على مشاركة الحكم، وهذا اختزل إلى إصلاح مؤسسي ثم إلى إصلاح إداري، لتصب سياساته في المآل في برنامج تحرير اقتصادوي تقليدي يهدف إلى جذب الاستثمارات بأي ثمن من أجل رفع معدل النمو الكمي. وهنا «ترك توزيع ثمار النمو لعمل اليد الخفية (ديناميات السوق)، وكان اهتمام السياسات برفع معدل النمو أكثر وأوضح من اهتمامها بعدالة التوزيع. وكان أقصى ما فعلته هو محاولة التدخل بمنهج (الإطفائي) لإصلاح ما يحدث من اختلالات توزيعية في مرحلة لاحقة، وعلى نطاق محدود»[18]، بينما كان من المعروف بدهيًا، حتى لدى واضعي السياسات أنفسهم، ومن قراءة تجارب بلدان أخرى، أن الفئات القوية (بشكل خاص رجال الأعمال)، هي التي تقطف عادة ثمار النمو في حالات التحول من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق، عندما لا يكون هناك نظام سياسي ديمقراطي يحدُّ من فوضى السوق ويأخذ في الاعتبار عدالة التوزيع.
يضاف إلى ذلك أن عمليات تحرير الاقتصاد السوري الجزئية كانت معزولة عن تحديث البنية القانونية في الحد الأدنى، بما يعني أن النظام لم يكن يريد من عناوين الإصلاح التي طرحها إلا جلب استثمارات جديدة، وذلك خوفًا من أن يترتب على أي عملية تغيير نتائج سياسية تنعكس على احتكاره القوة والسلطة.
وفي الفصل الثالث: «القانون المدني وجبروت الدولة السورية»، يؤكد الباحثون زهير غزال (Zohair Ghazzal)، وبودوان ديبريه (Baudouin Dupret) وسهيل بلحاج (Souhail Belhadj) على فكرتين أساسيتين، الأولى: أن القانون كان إحدى وسائل النظام في السيطرة السياسية والاقتصادية على الدولة والمجتمع، والثانية: هي تخلف القوانين التي استصدرها النظام ومؤسساته المختلفة بعد استيلائه على الحكم في عام 1963، مقارنة بالقوانين المدنية والجزائية التي صدرت في عام 1949.
ففي عام 1949، إبان فترة حكم حسني الزعيم القصيرة، صدرت القوانين المدنية والجزائية، وعلى الرغم من وجود حوادث سياسية مهمة خلال المدة ما بين عامي 1949 و1963، كالانقلابات العسكرية المختلفة والوحدة مع مصر في عام 1958 واستيلاء حزب البعث على السلطة في عام 1963، إلا أنه لم يكن لها تأثير يذكر على النظام القانوني والسلطة القضائية في سورية، إذ إنها لم تُغيِّر في بنية وشكل ومضمون القوانين التي أُنفذت في العام 1949 إلا قليلاً.
وبعد «الحركة التصحيحية» أُدخل عددٌ قليلٌ من التغييرات القانونية التي أثرت على وضع الملكية الخاصة حيز التنفيذ، ما شكل تهديدًا للنظام القانوني الصادر في عام 1949، وكانت القوانين التي صدرت خلال السبعينيات والثمانينيات في معظمها قوانين اقتصادية تميل إلى «تجريم» المعاملات الخاصة التي يُزعم أنها «تقاوم النظام الاشتراكي»، بما يشير إلى خوف النظام من القطاع الخاص، وسعيه إلى التحكم بالاقتصاد إلى جانب السياسة. وعلى الرغم من أن نصوص القانون المدني بحدِّ ذاتها لم تتغير، إلا أن المواطنين السوريين قد خسروا الكثير من حرياتهم المدنية، ليس في الميدان السياسي فحسب بل أيضًا في ما يتعلق بحق التبادل وتكوين الجمعيات بحرية، كما وضعها القانون المدني بالأصل[19].
أما في عهد بشار الأسد، ومع بدء عمليات تحرير الاقتصاد، فلم تصدر سوى قوانين اقتصادية جزئية من دون رؤية عامة لطبيعة الاقتصاد المنشود، وفي ظل غياب منظومة حقيقية للقانون والقضاء في البلد. كما لم يكن النظام مهتمًا بإعادة النظر في قوانين الجمعيات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني التي يمكن أن تخفف من وطأة الآثار السلبية المتوقعة لتحرير الاقتصاد، فضلاً عن غياب قانون حديث للأحزاب السياسية، وفي ظل قانون استبدادي ومتخلف لوسائل الإعلام. وهذه المسائل كانت جزءًا من الأسباب التي وقفت حائلاً دون وضع اتفاقية الشراكة الأوروبية السورية موضع التنفيذ.
وفي الفصل الثامن من هذا الكتاب: «الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: آمال، مخاطر، وتحديات للاقتصاد السوري»، تستعرض أنجا زوروب (Anja Zorob) العلاقات بين سورية والاتحاد الأوروبي التي لا تزال محكومة باتفاقية التعاون التي وُقِّعت في عام [20]1977. وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة الأوروبية السورية[21] في تشرين الأول/أكتوبر عام 2004، لكن التوقيع الرسمي على الاتفاقية ظلَّ معلقًا لأسبابٍ سياسيةٍ، وبسبب «الشروط المسبقة» التي طُلب من سورية إنجازها قبل أن يعطي المجلس الأوروبي موافقته النهائية[22].
ولا شك أن لاتفاقية الشراكة السورية الأوروبية بشكلها الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى آثارًا سلبية محتملة، لكن إيجابيات توقيع الاتفاقية تبقى أهم من سلبياتها بالنسبة إلى سورية، فالاقتصاد السوري بحاجة ملحة إلى موارد جديدة لتعزيز النمو والتنمية. وكان الأمل أن تعمل اتفاقية الشراكة، على الرغم من كثرة ثغراتها ومخاطرها وآثارها السلبية المحتملة، المتمثلة بتشجيع النظام السوري على الذهاب في طريق إصلاح متكامل وحقيقي.
وكان من المهم أن يقوم النظام بسلسلة من التدابير الإصلاحية، سواء في القواعد السياسية السائدة أم في مجال إدارة الاقتصاد الكلي، والتعديل الهيكلي في مجالاتٍ عديدة. وإضافة إلى ذلك، ولتقليل الآثار السلبية على الإنتاج والدخل والعمالة، كان ينبغي على الإدارة السورية أن تتخذ خطواتٍ لمساعدة الشركات المحلية لتهيئ نفسها لمنافسة الاتحاد الأوروبي، وخطواتٍ أخرى للتغلب على خسائر الدخل والعمالة من خلال إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي لفئات الدخل المتضرر[23]. لكن المشكلة الرئيسة هي أن النظام كان وما يزال يقارب أي استحقاقات اقتصادية من زاوية تأثيرها على استمراره في الحكم وضمان عدم تأثيرها على القواعد السياسية السائدة.
وعلى المستوى الإجمالي، ومقارنة مع تجارب أخرى قريبة، كانت حصيلة النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر الأولى من الألفية الثالثة إيجابية، إذا ما أخذنا بالاعتبار الأحوال والأوضاع العامة من حيث الضغوط السياسية التي تعرضت لها المنطقة بكليّتها، ومن حيث حالة الصقيع والجفاف التي سيطرت على المناخ خلال تلك الفترة. وصبَّت آثار هذا النمو في أيدي الفئات الاقتصادية-الاجتماعية القوية، ولا سيما رجال الأعمال، كما قلنا سابقًا.
وعمومًا، فقد «حصدت المدن المليونية (ثمار) النمو، بينما حصدت المدن المئة ألفية والصغيرة (أشواكه)»[24]. ومن البدهي أن يخلق مثل هذا الوضع ديناميات حادة جديدة على مستوى الاستقطاب الاجتماعي – السياسي، وهو الأمر الذي كان من الممكن تجنبه لمصلحة انتقال تدرجيّ وآمن لو أخذ الإصلاح المؤسسي مداه كدينامية رئيسة في التحول الديمقراطي، لكن للأسف، هُدرت هذه المحاولة لمصلحة تحرير اقتصادوي تسلطي تقليدي معروف الآثار سلفًا.
وأدت سياسة التحرير الاقتصادي الجزئي التي تعمقت في عهد بشار الأسد إلى ضرب الشرائح المتوسطة والفقيرة من الشعب السوري، واستمرت الفجوة بين الأغنياء والفقراء بالاتساع في السنوات الأخيرة من العشرية الأولى. وتشير التقديرات أن خمسة في المئة من السكان يملكون خمسين في المئة من الثروة الوطنية[25]، مع العلم أن 11 إلى 30 في المئة من السوريين أصبحوا تحت خط الفقر، ويعيش معظمهم في المناطق الريفية الأقل تطورًا الواقعة بالقرب من الحدود التركية والعراقية، وهذه الأرقام بحسب التقديرات الرسمية، نقلاً عن جريدة الحياة 17 تموز/يوليو [26]2005.
قام جمال باروت بتحليل هذه النسبة المتفاوتة من الواقعين تحت خط الفقر (ما بين 11-30 في المئة من السوريين)، إذ يشير إلى أن نسبة السكان الفقراء (ما تحت خط الفقر الأدنى) وفق خط الفقر الوطني، ارتفعت من 11.4 في المئة يمثلون 2.043 مليون نسمة عام 2004، إلى 12.3 في المئة عام 2007، يبلغون نحو 2.358 مليون نسمة من جملة السكان[27]. لكن هذا المعدل المسجل – بحسب باروت – «لا يمثل إلا الرأس الظاهر من «جبل الجليد» أو «البركان» فالفقر ظاهريًا، على مستوى المعدل الإجمالي، يبدو «ضحلاً»، ويخصُّ من يُصنفون «تحت خط الفقر الأدنى» الشديد أو المدقع، بينما يتمثل الجزء الثاني من القصة المؤسسية، في أن التحولات الهيكلية هدّدت بقذف نحو 22 في المئة من السكان، يصنفون «تحت خط الفقر الأعلى»، ويبلغون 4.218 ملايين نسمة وفق تقديرات عام 2007، أو ما يعادل 4.536 ملايين نسمة وفق تقديرات عام 2010، إلى ما تحت خط الفقر الأدنى، ورميهم في بيئة محفوفة بالمخاطر الشديدة، ومفعمة بالحرمان والقلق والاضطراب النفسي والسلوكي والثقافي والاجتماعي، ليغدو عدد من هم تحت خط الفقر نحو 7 ملايين نسمة، يمثلون 34.3 في المئة من سكان سورية»[28].
أما أسباب هذا الارتفاع في نسبة من هم تحت خط الفقر فهي: عمليات خفض الدعم التمويني، وخفض دعم المشتقات النفطية من 16 في المئة عام 2004 إلى 11 في المئة عام 2007، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والجفاف القاسي، وارتفاع معدل التضخم كنتيجة للأزمة المالية الدولية[29]. أما بالنسبة إلى معدل البطالة، فإنه تجاوز الـ 8.1 في المئة إلى 16.5 في المئة عام 2009 يمثلون على مستوى الحجم السكاني 3.4 ملايين عاطل من العمل، وذلك استنادًا إلى منظور واقعي للبطالة[30].
اتضحت الآثار السلبية لبرنامج التحرير الاقتصادي خلال الفترة من 2007 إلى 2010، بالتزامن مع الأزمة المالية الدولية، وآثار الجفاف الضارب في سورية من خلال: تزايد عدد الفقراء، وارتفاع نسبة البطالة الواقعية، وتشوهات واسعة في توزيع الداخل، واتساع نطاق الاختلال في التنمية المناطقية، وإفلاس مئات المصانع الصغيرة بفعل تحرير التجارة الخارجية، وتركز رأس المال السوري في قبضة «المئة الكبار»، وهجرة بيئية داخلية واسعة ناتجة من الجفاف، وارتفاع معدل الفساد الصغير والكبير في الدولة، وذلك بالتزامن مع ضعف البنية القانونية وهشاشة أجهزة العدالة في القبض على الفاسدين. كما طالت هذه الآثار على وجه الخصوص الشرائح والفئات المتوسطة والفقيرة، ولا سيما في الأرياف، مما ساعد في انضمامها إلى الثورة السورية عندما انطلقت كثورة حرية وكرامة بالدرجة الأولى في آذار/مارس 2011.
ثالثًا: المعارضة السورية والثورة
1- المعارضة السورية في بدايات عهد بشار الأسد
لم يكن في سورية معارضة متماسكة بالمعنى الحقيقي للكلمة، فنظام حافظ الأسد الذي حكم سورية بقبضة من حديد مدة ثلاثة عقود، لم يسمح بأي شكل من أشكال المعارضة المدنية والسياسية، وما كان موجودًا لا يعدو كونه مجرد جزر صغيرة ومعزولة عن المجتمع، وبعيدة من ممارسة السياسة الواقعية، وتحضر فيها الأيديولوجية بشكل مكثف على حساب الممارسة التفصيلية والبرامجية للسياسة.
ففي الفصل السابع: «المعارضة السورية: النضال من أجل الوحدة وأهميتها، 2003-2008»، يرى جو بيس (Joe Pace) وجوشوا لانديس (Joshua Landis)، أنه مع استلام بشار الأسد مقاليد السلطة تأمل السوريون في إمكانية البدء بإصلاح سياسي تدرجيّ، فكانت الأشهر القليلة الأولى من حكمه مبشرة بالخير، إذ انطلق ما عرف في ما بعد بـ «ربيع دمشق»، كما أغلق سجن المزة السياسي سيء الصيت، الذي كان رمزًا لوحشية النظام، وسرعان ما بدأ مثقفو سورية الذين كانوا يومًا مجمدين بإظهار علامات الحياة، وبدأت منظمات حقوق الإنسان ومنتديات النقاش تتكاثر على امتداد البلاد، ودخل عدد من الشخصيات البرلمانية ورجال الأعمال إلى الساحة الإصلاحية، ووقع أكثر من 1000 من ناشطي المجتمع المدني على بيان الألف في كانون الثاني/يناير 2001، الذي يدعو إلى إصلاحات سياسية شاملة. لكن هذه التطورات أثبتت أنها أكثر بكثير من أن يتحملها النظام.
وعلى الرغم من بعض النجاحات الطفيفة، إلاّ أن ربيع دمشق فشل في إنتاج كيان يشبه معارضة موحدة. ومع موافقة جميع مجموعات المعارضة تقريبًا على مجموعة المطالب الأساسية، إلا أن هذه التعهدات المشتركة أثبتت أنها واهية. إذ أدت الخلافات الأيديولوجية السطحية، والنزاعات الشخصية، وتدخل الأجهزة الأمنية إلى مضاعفة الخلافات الجوهرية حول كل شيء، كمسألة الحقوق الكردية ودور الخارج. فأنتجت هذه المشكلات معارضة مجزأة وغير فعالة تتكون غالبًا من جمعيات حقوق إنسان متنافسة، وأحزاب سياسية، ومنتديات ولجان مجتمع مدني، وناشطين ومثقفين مستقلين وجماعات إسلاموية سرية[31].
أدّت الضغوط الأمنية والقمع والاعتقالات في عهد حافظ الأسد إلى سحق الأحزاب المعارضة، لكنها استمرت كأحزاب هشة صغيرة تحالفت في إطار التجمع الوطني الديمقراطي. كما كانت هناك المعارضة الكردية التي اخترقتها الأجهزة الأمنية وشجعت بعض أحزابها على الانشقاق حتى أصبحت مؤلفة من عدد كبير من الأحزاب. ونظرًا إلى تفتت المجتمع السياسي السوري، أصبح المثقفون والناشطون المستقلون عماد المعارضة في فترة ما بعد ربيع دمشق.
ولم يكن هناك مؤشر على أن النظام سيصبح أكثر تسامحًا مع النشاط السياسي الإسلاموي. كما كانت ذكرى مجزرة حماه التي سحقت انتفاضة الإخوان المسلمين في شباط/فبراير عام 1982، والقانون رقم 49 الذي يعاقب العضوية في منظمة الإخوان المسلمين بالإعدام، يحولان دون ظهور وجود منظم داخل سورية من جديد.
2- انتفاضة السوريين الأكراد
جاءت الاحتجاجات الكردية في آذار 2004 لتجبر الناشطين العرب على الاعتراف بأن الأكراد قوة لم يعد من الممكن تجاهلها بعد أن خرجوا بمئات الآلاف، وكانت المعارضة العربية قبل ذلك قد تجاهلت القضية الكردية إلى حدٍّ بعيد.
وفي الفصل السادس من هذا الكتاب: «حوادث عام 2004 في القامشلي: هل اندلعت المسألة الكردية في سورية؟»، يناقش جولي غوتير (Julie Gauthier) حوادث مدينة القامشلي في آذار 2004 التي أنهت إبهام جماعة لم تكن قادرة، على الرغم من شعورها المتزايد بالهوية منذ السبعينيات، على تحويل ثقلها الديموغرافي (نحو مليوني مواطن، أو 10 في المئة من مجموع سكان سورية) إلى قوة سياسية جوهرية.
عقد الأكراد السوريون الآمال على «التحالف» الأميركي – الكردي في العراق، باعتباره فرصة لحمل قضايا مجتمعهم إلى الصدارة وتبني إستراتيجية معارضة أكثر حزمًا، وهذا دفع بدوره النظام السوري نحو التقارب مع العدو التقليدي، تركيا، مصالحة عززها طرد أوجلان من الأراضي السورية. وقد أسهمت زيارة بشار الأسد إلى أنقرة في شباط/فبراير 2004، والتسليم الروتيني لسجناء حزب العمال الكردستاني من سورية (سبعون سجينًا منذ عام 2003) في ترسيخ التحالف بين البلدين[32].
وتجلت الحوادث على مدى نحو عشرة أيام، من 11 وحتى 25 آذار/مارس 2004. حيث أطلقت السلطات النار في مواجهة الحشود والتظاهرات، وتسبب ذلك في مقتل عشرات الأشخاص واعتقال المئات؛ كانوا كلهم من الأكراد. وبدأت الشائعات حول المجزرة تنتشر. وامتدّت الاحتجاجات بسرعة إلى البلدات الأخرى ذات الأغلبية الكردية في شمال شرق سورية، إضافة إلى حلب ودمشق.
أُخذت الأحزاب الكردية على حين غرة بهذه الحوادث. ففي المقام الأول، رفض الأكراد لقاء الأجهزة الأمنية، مشترطين قبل إجراء أي مفاوضات، يجب وجوب تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولية عن أعمال العنف، كما طالبوا أيضًا بوضع حدٍّ للاعتقالات التعسفية والاعتداءات على الممتلكات الخاصة، فضلاً عن تعويض أُسر الضحايا. غير أن موقف الرفض هذا سرعان ما انهار. وبعد 13 آذار/مارس، اجتمع طرفا الجبهة والتحالف ثانية مع قادة حزب البعث، وبدلاً من صوغ سياسة احتجاج شعبي، وافق الطرفان على تهدئة الشارع (وبه انخفض نفوذهما بالفعل)، مهتمين برؤية النظام لهما بوصفهما وسيطين، أكثر من الاهتمام بشرعنة قاعدتهما. فالأحزاب التي فقدت بطريقة أخرى صدقيتها ظهرت محاورة للنظام على حساب الآخرين[33].
وأخذت التعبئة الجماهيرية للأكراد حول هويتهم العرقية، لأول مرة، شكل مواجهة مباشرة مع السلطة. ولأول مرة أيضًا، لامست حركة المقاومة الشعبية شبكة المناطق الكردية، بما فيها أكثر المناطق المعزولة مثل عين العرب (كوباني)، وبالتالي عززت الوحدة الرمزية للمساحة الكردية السورية. وفي الوقت نفسه، خلقت المواجهة مساحة من الثقة في ما يتعلق بكردستان التي أصبحت ملاذًا رمزيًا، إذ تخلى البرزاني عن تحفظه المعتاد حول مسألة الأكراد في سورية، وطالب بإيجاد حلٍّ للمشكلات التي تؤثر على «كردستان في سورية». وقد أغضبت هذه المصطلحات السوريين. وكان التفاعل الجديد الناشئ بين ساحتي الأكراد السوريين والأكراد العراقيين، لا يمكنه إلا أن يوقظ الوعي بخصوص الموقف الإستراتيجي غير المسبوق للأكراد في سورية، وبخصوص التحول في السلطة بينهم وبين الدولة السورية.
تعامل النظام السوري مع الانتفاضة الكردية من منظور أمني فحسب، ولم يسع إلى إعادة النظر في رؤيته القومية العنصرية أو في ممارساته التمييزية بحق السوريين الأكراد، ولم يدرك أنه «لا يمكن للأيديولوجية العروبية للبعث أن تقدم حلاً للأكراد السوريين، بل إنها جزء من المشكلة. إن فعل التوازن بين العروبية القومية – الإثنية وبين القومية السورية يبدو متناقضًا بشكل مطرد على خلفية الميل المتنامي إلى العودة إلى الأصول في المنطقة بعد الحرب في العراق»[34]، بل ظل مستمرًا بعدها في نهجه الأمني، معتبرًا أن ما حدث ليس أكثر من سحابة صيف.
كما أوضحت سلسلة حوادث آذار/مارس 2004 قدرة الأكراد على حشد العمل الشعبي حتى في قلب المجتمع السوري، كما رأينا في حلب ودمشق، بمساعدة الحركة الطلابية، وأظهرت أن الوضع الراهن بين النظام الحاكم والمجتمع الكردي آخذ في التحول، فطبيعة الصراع ستستمر على الرغم من القمع الشديد، ولن تكون يقظة الهوية الكردية في سورية بعد هذه الحوادث مسألة سياسية هامشية.
3- المعارضة السورية ما بعد اغتيال الحريري
في الفصل السابع من هذا الكتاب: «المعارضة السورية: النضال من أجل الوحدة وأهميتها، 2003-2008»، يتابع كلٌّ من جو بيس وجوشوا لانديس رصد أحوال المعارضة ونشاطها ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير من عام 2005.
إذ ازدادت الضغوط آنذاك على النظام السوري، وقضت المعارضة ربيع وصيف عام 2005 منشغلة بمحاولات توحيد قواها، لتسفر في 16 تشرين الأول/أكتوبر عام 2005، قبل خمسة أيام من موعد إصدار تقرير الأمم المتحدة الأول حول اغتيال الحريري، عن إعلان دمشق، من خلال وثيقة تؤسس لمنصة موحدة من أجل التغيير الديمقراطي. وكانت النتيجة إنشاء تحالفٍ على نطاقٍ واسعٍ مؤلف من أحزاب عربية وكردية وسريانية، إضافة إلى أحزاب علمانية من جميع التيارات، وحركة الإخوان المسلمين، ولجان إحياء المجتمع المدني، وعدد من المثقفين السوريين، فالجميع كانوا على استعداد للتوحد على منصة واحدة للتغيير الديمقراطي. وأدّى تشكيل الائتلاف إلى دق ناقوس الخطر بالنسبة إلى نظام كافح على مدى عقدين من الزمن لحرمان الإخوان المسلمين من موطئ قدم في المجتمع السوري، فشنَّ النظام هجومًا كبيرًا ضد الإعلان ومناصريه.
كما كثَّف النظام قمعه الناشطين خلال انسحاب عام 2005 من لبنان، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ شتاء دمشق. إذ بدأ باعتقال ومضايقة ناشطي المجتمع المدني، وسارع إلى حرمانهم من التعبير عن آرائهم في وسائل الإعلام. وفي أيار/مايو 2005، اعتقلت قوات الأمن اللجنة الإدارية لمنتدى جمال الأتاسي بأكملها، لقراءتها جهارًا رسالة من الإخوان المسلمين. ثم أطلق سراح جميع أعضاء اللجنة باستثناء واحد، وتم إغلاق المنتدى، وكان المنتدى الأخير الباقي. وازداد عدد الاعتقالات التعسفية والاستدعاءات الأمنية بشكلٍ كبيرٍ ومفاجئٍ. وبحلول منتصف فصل الصيف، كانت جميع التجمعات المعارضة محظورة.
إن القمع الذي بدأ في عام 2005، ثم ازدادت وتيرته بعد انشقاق عبد الحليم خدام، أصبح وحشيًا بعد إعلان دمشق – بيروت في أيار/مايو 2006 الذي وقَّعه نحو 300 من المثقفين السوريين واللبنانيين، ويدعو إلى تطبيع العلاقات بين لبنان وسورية. وثمة العديد من التطوّرات التي شجعت النظام على تكثيف حملته، إذ شعر النظام بأنه قد تفادى رصاصة عندما بدأ تحقيق الأمم المتحدة في اغتيال الحريري يواجه صعوباتٍ جديةً عُقب التقرير الأول والأكثر دراماتيكية الذي صدر خلال خريف عام 2005، والذي اتهم سورية بشكلٍ مباشرٍ بتدبير الاغتيال. كما أدَّى الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف عام 2006 إلى تعزيز سورية أكثر، حيث فشلت إسرائيل في تدمير حزب الله، الذي سرعان ما تسلح ثانية بمساعدة سورية، وأثبت بأنه قادرٌ على حماية المصالح السورية في لبنان[35]. واستمر النظام طوال عام 2007 في التخلص من جميع شخصيات المعارضة تقريبًا، فاعتقل في كانون الأول/ديسمبر 2007، وفي كانون الثاني/يناير 2008، مجموعة من كوادر إعلان دمشق ولجان إحياء المجتمع المدني، لتكون الفترة ما بين أوائل عام 2008 وحتى نهاية عام 2010 خالية من أي نشاط معارض، وتزامن ذلك مع خروج النظام من عزلته الدبلوماسية والسياسية خلال النصف الأخير من عام 2008، وظهر أن المعارضة السورية تحتاج إلى تغيير نفسها وطرائق عملها وإلى أفكار جديدة حول الوطنية السورية والتحول الاقتصادي والاجتماعي الجاري في سورية.
وعلى العموم يمكن وضع عدد من الانتقادات على مسيرة النشاط المدني والسياسي في سورية خلال مرحلة ما قبل الثورة، إذ على الرغم من الجهد المبذول من قبل جميع القوى السياسية والمدنية قياساً بالوضع الأمني والاستبداد السياسي، فإن هناك عددًا من العناصر السياسية والتنظيمية، عند المعارضة السورية، لعبت دورًا سلبيًا، وستستمر تلعب الدور ذاته خلال الثورة.
1- تعاني قوى المعارضة السياسية من كل ما تعانيه الحركات الاجتماعية التي تعمل في ظروف الاستبداد، وتحت ضغوط أمنية مستمرة، ولعل أبرز أزماتها هي أزمة الهوية التي بقيت موضوع سجال حاد، فضلاً عن خطابها الأيديولوجي غير الديمقراطي، واشتراكه في الكثير من عناصره مع خطاب السلطة.
2- افتقاد الحوار الحقيقي داخل جميع التشكيلات الحزبية، الأمر الذي أفسح المجال لبروز الخلافات الاستقطابية المعيقة، وهذا منع إلى حد ما تبلور خط عام توافقي لدى المعارضة السورية.
3- يقف على رأس بعض هذه القوى أفراد لا يمتلكون الكفاءات النظرية والسياسية، وصلوا إلى هذه المواقع مصادفةً أو بحكم دعم إعلامي خارجي أو نتيجة توازنات فرضتها أربعون سنة من الشلل السياسي.
4- افتقاد معظم القوى السياسية للإدارة الحديثة ولاستراتيجيات محدَّدة وبرامج وآليات عمل واضحة وغياب الحضور المؤثر للقانون والآليات الديمقراطية داخلها.
5- لا توجد علاقة تشبيك قوية بين هذه القوى والمجتمع السوري، ويلاحظ ذلك ببساطة من خلال غياب الشباب عن جميع هذه المؤسسات. وعلى العموم كان الشباب السوري يجد نفسه في حالة هو خارج عنها، حتى عندما كانت الحالة الأمنية تسنح لنشاط هذه القوى، ربما بسبب قصور خطابها السياسي لغة ومحتوى، وعدم وجود أشكال إبداعية جديدة من الممارسة السياسية.
ومع بداية الثورة السورية، كنا أمام معارضة محطمة بفعل الاستبداد وصغيرة الحجم داخل وخارج سورية، وتفتقد لأوليات الممارسة السياسية بحكم إبعادها عن الساحة زمنًا طويلًا. وفضلاً عن ذلك، تعاني المعارضة من إشكالات غير قليلة على صعيد الرؤية واللغة والخطاب، ومن تكلسات على صعيد الفكر والسياسة، إذ لا تزال المحركات الأيديولوجية التقليدية هي الأساس في نظرتها وخطابها ومواقفها، إضافة إلى البنى التنظيمية الضعيفة والمترهلة.
4- المعارضة في سياق الثورة السورية
على الرغم من حديثنا السابق عن الآثار السلبية لسياسات النظام الاقتصادية على الفئات المتوسطة والفقيرة بشكلٍ خاص من الشعب السوري، إلا أننا لا نستطيع القول إنها السبب أو المحرك الرئيس للثورة السورية التي انطلقت في آذار/مارس 2011 ولا تزال مفاعيلها وآثارها مستمرة إلى اليوم، حتى بعد اتخاذها مسارات معقدة وفوضوية. فهذه الآثار ساهمت في توسيع رقعة الاحتجاجات والتظاهرات وتكوين بيئة حاضنة للثورة بين تلك الفئات، لكن الأساس هو أن الثورة السورية جاءت في سياق مناخ عام من الثورات في المنطقة العربية، وأن السوريين قد تأثروا إلى حدٍّ بعيد بالثورتين التونسية والمصرية. وعلى حد تعبير عزمي بشارة، «كانت أسباب الثورة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمكن تعدادها قائمة منذ عقود، ومرت مراحل كان فيها النظام السوري أكثر ضعفًا، وأقل استقرارًا. لكن الثورة اندلعت في مرحلة بدا فيها النظام في أوج استقراره، وبدا فيها مرتاحًا مع كسر عزلته الدولية. إنه عامل المرحلة التاريخية وارتباط الشعب السوري الثقافي السياسي، وربما الوجداني، بما يجري في المنطقة العربية»[36].
وعليه يمكن القول إن أسباب الثورة في سورية تتشابه على العموم مع أسباب الثورات العربية الأخرى في كلٍّ من تونس ومصر، ولذلك كانت الشعارات الأساسية المسيطرة في الثورة هي الشعارات التي تطالب بتحقيق الحرية والكرامة، والفارق الرئيس في ثورة الشعب السوري يكمن في «خصوصيّة مجتمعه المركب دينيًا، وطائفيًا، وإثنيًا، والتي أعاقت تبلور هوية وطنية جامعة تسمح بفصل المجتمع عن النظام، وبالتالي أيضًا النظام عن الدولة»[37]. كما يكمن الفارق الثاني في «وضع سورية السياسي الجيوستراتيجي، لأنها جزء من محور دولي لا يؤيّد أي تحوّل ديمقراطي، في أي مكان في العالم، ولا سيما في الدول التابعة له. ويكمن الثالث في اغتراب النظام شبه الكامل عن المجتمع وتعامله معه باعتباره استعمارًا داخليًا، يسيطر عليه من خارجه. فهو قد يسخّر آليات التحالف مع قوى اجتماعية وطبقات تجارية واستثمارية من أجل السيطرة، ولكنه لا يرى نفسه جزءًا منها، ولا ممثلاً لها»[38].
ولا شك أن طبيعة النظام الاحتلالية للدولة والمجتمع، إلى جانب بنيته ذات النواة الصلبة والمغلقة، بما فيها الولاء الأعمى للأجهزة الأمنية، تفسِّران المستوى غير المسبوق من القسوة في قمع الاحتجاجات والتظاهرات، والوحشية في ممارسة التعذيب وانتهاك الأجساد، ومن ثم الإقدام على قصف مدنٍ بأكملها في مراحل متقدّمة من الثورة، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد البلدات المعارضة، وإلقاء البراميل المتفجرة على الأحياء والمناطق المكتظة بالمدنيين.
وفي اللحظة التي بدأت فيها الثورة، كان هناك في سورية عدد من الكتل السياسية المعارضة، وكل واحدة منها تضم عدداً من الأحزاب السياسية الصغيرة، وأحياناً لا يتجاوز عدد أعضاء بعضها حفنة من الأفراد، كما كان بعض هذه الأحزاب موجوداً في أكثر من كتلة سياسية. هذه الكتل السياسية هي: التجمع الوطني الديمقراطي، وإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي (وضمنه عدد من الأحزاب الكردية)، وتجمع اليسار الماركسي (تيم)، ومجموعة من الأحزاب الكردية خارج إعلان دمشق، والإخوان المسلمون (خارج سورية). ثم أُسِّست هيئة التنسيق الوطنية داخل سورية بتاريخ 30 حزيران يونيو 2011، إلا أنها بقيت مقتصرة على عدد من الأحزاب الكلاسيكية الصغيرة، وظلت فاعليتها هامشية في التأثير في مسار الثورة ومجريات الحوادث.
ومنذ بداية الثورة كانت هناك مبادرات عديدة من السوريين المقيمين خارج سورية، لإقامة هيئات ومجالس وطنية، تضامنًا مع أهلهم وإخوانهم، لكن المشكلة أن هذه المبادرات كانت تتم بمعزل عن بعضها. وقد أطلق الإخوان المسلمون، بعد تعثر محاولات عديدة، دعوة رسمية إلى لقاء في اسطنبول يعقد في 28 أيلول/سبتمبر 2011، وكانت الدعوة موجهة إلى جميع القوى والتيارات. وفي هذا اللقاء جرى الحوار بين القوى التالية: الإخوان المسلمون، وإعلان دمشق، ومجلس اسطنبول الذي تشكل في منتصف أيلول/سبتمبر 2011، ولجان التنسيق المحلية، والهيئة العامة للثورة السورية، والمجلس الثوري، ومجموعة المستقلين. ما حدث في استنبول عمليًا هو تفاوض ما بين مجموعة قوى انتهى إلى تشكيل ائتلاف سياسي أطلق عليه اسم «المجلس الوطني السوري»، ثم جرى ضم عدد متساو من أطراف هذا الائتلاف السابقة الذكر، باستثناء الهيئة العامة للثورة السورية وهيئة التنسيق الوطنية التي شُكِّلت داخل سورية في 30 حزيران/يونيو 2011، وتم الإعلان عن المجلس في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
وبالنسبة إلى القوى الكردية، كان ميل الأحزاب الكردية إلى العمل في الإطار الوطني السوري قد تغير مع بداية الثورة السورية، إذ اتجهت القيادات الحزبية الكردية إلى توحيد خطابها أمام النظام السوري والمعارضة السورية في آن معًا، وفشلت بعد الثورة جميع محاولات التوحد والتنسيق بين قوى المعارضة العربية والأحزاب الكردية. كما اقتصرت المشاركة الكردية في المجلس الوطني السوري على كتل صغيرة أو شخصيات سياسية كردية مستقلة لأسباب عدة، بعضها موضوعي والآخر مرتبط بأجندات حزبية كردية.
ورأت الأحزاب الكردية ضرورة إنضاج تكتل سياسي حقيقي ينهي حالة الانقسام بين الأحزاب الكردية، فكانت الدعوة إلى مؤتمر وطني كردي عقد في مدينة القامشلي بتاريخ 26-27 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وشاركت فيه أحزاب الحركة الوطنية الكردية وشخصيات سياسية كردية مستقلة ومجموعات شبابية، بينما قاطعه عدد من الأحزاب الكردية منها تيار المستقبل الكردي في سورية، وحزب الاتحاد الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الكرديّ (بارتي)، وجزء من التنسيقيات والمجموعات الشبابية التي تنظم التظاهرات المناوئة للنظام. وقد أقر بيان المؤتمر أن انضمام أي حزب إلى المؤتمر الوطني الكردي يعني تعليق عضويته في أي أطر أخرى. وعلى الرغم من التعاطي الكردي الإيجابي – إعلاميًا – مع البرنامج السياسي للمجلس الوطني السوري إلا أن الأحزاب الكردية كانت تَنشد استكمال تأطير نفسها في كيان سياسي موحد جرى تأسيسه – المؤتمر الوطني الكردي – وتوحيد خطابها أمام المعارضة السورية.
كما أسهم تعثر المفاوضات بين الأحزاب الكردية ومختلف فصائل المعارضة السورية، بسبب رفض الإقرار بمطالبها، في حدوث نقاشات ومراجعات ضمن الوسط السياسي الكردي، إذ رأت قيادت المجلس الوطني الكردي ضرورة التراجع المرحلي عن قضايا إشكالية مثل حق تقرير المصير، أو الفدرالية. وبناء على ذلك قام بصوغ برنامج سياسي جديد في 21 نيسان/أبريل عام 2012 أطلق عليه اسم «البرنامج السياسي المرحلي للمجلس الوطني الكردي»، مختلفًا عن برنامجه القديم، إذ لا يطالب صراحة بحق تقرير المصير للشعب الكردي ولا باللامركزية السياسية[39]. وفي الوقت الذي وجد فيه برنامج المجلس الوطني الكردي ارتياحًا نسبيًا لدى فصائل المعارضة السورية، تعرّض برنامجه لانتقادات كرديّة واسعة، اتهمت قيادات المجلس بالتراجع عن برنامج تأسيس المؤتمر الوطني الكردي.
كما تبنّت وثيقة العهد الوطني التي أُقرت في اجتماع المعارضة السورية بدعوة من جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 2 و3 تموز/يوليو 2012 البنود نفسها تقريبًا التي جاءت في البرنامج السياسي المرحلي للمجلس الوطني الكردي. وعلى الرغم من ذلك انسحب ممثلوه من المؤتمر. والجدير بالذكر أن سبب الانسحاب من مؤتمر المعارضة في القاهرة كان وفق المجلس الكردي هو رفض المؤتمرين تبني مصطلح «الشعب الكردي».
لكن آلية عمل المجلس الوطني القائمة على المحاصصة بين مكوناته المختلفة، عطَّلت انطلاقته، ومنعت من توسعته ليشمل أطياف المعارضة الأخرى والتجمعات الجديدة التي ظهرت خلال الثورة. كما أنّ تحديد دورة الرئاسة بثلاثة أشهر، قد عطَّلت استقراره وفاعليته، وسمحت باستشراء ظاهرة التنافس السلبي.
وتزايدت الضغوط الدولية والعربية والداخلية، عقب مؤتمر جنيف 1، على المعارضة السورية، بما فيها المجلس الوطني، لتوحيد صفوفها. فأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون صراحةً عن الضغوط الأميركية لتشكيل هيئة جديدة للمعارضة السورية تتجاوز المجلس الوطني، إذ قالت: «حان الوقت لتجاوز المجلس الوطني السوري وضم من يقفون في خطوط المواجهة يقاتلون ويموتون اليوم»[40].
استطاعت قوى المعارضة تأسيس الائتلاف الوطني السوري في اللقاء التشاوري الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وكان المجلس الوطني السوري أحد أركانه. كما ضمت الهيئة العامة للائتلاف معظم تكتلات المعارضة باستثناء هيئة التنسيق الوطنية. وكان المؤمَّل أن يمثِّل الائتلاف أوسع طيف لقوى الثورة والمعارضة، وأن يقدِّم رؤيةً واضحةً عن مستقبل سورية، وأن يُساعد السوريين في حاضرهم للتغلب على المشكلات الكبرى التي تواجههم، وأن يتحول إلى قيادة حقيقية للثورة في شتَّى مجالات نشاطها العسكري والمدني. لكن للأسف، تعثر الائتلاف وتخللته العيوب والمشكلات ذاتها التي أوصلت المجلس الوطني إلى طريق مسدود، على أننا لا ننكر بالطبع المسؤولية الأساسية للعرب والمجتمع الدولي في السماح للوضع السوري بالوصول إلى ما وصل إليه، فضلاً عن عرقلة المعارضة وشرذمتها بحكم التنافسات الإقليمية والدولية وتضارب الأجندات.
5- الخطاب السياسي للمعارضة في سياق الثورة
في مستوى الخطاب السياسي للمعارضة، يمكن القول إن الخطاب الذي ساد طوال ثلاث سنوات بعد الثورة كان شعبويًا في العموم، إذ لم يدرك أصحابه أن الشعب يقول كلمته دائمًا بالاستناد إلى معطيات معينة، وعندما تتغير المعطيات يتغير رأي الشعب. فأي قول للشعب هو قول غير نهائي، وأي تأييد من الشعب لفرد أو مجموعة هو غير نهائي.
وتعاملت المعارضة السوريّة مع القضايا والمهمات المطروحة عليها خلال فترة الثورة بإحدى طريقتين: «إما عبر أخلاقيّات تطهرية تتعفف عن التعامل مع المسائل المطروحة بجدية في الواقع السوري، أو من خلال براغماتية مغالية تصل إلى درجة مرعبة ومخيفة للكتلة الأكبر من السوريين. الأخلاقيّات التطهرية مصدرها وقاعها أيديولوجيان، والبراغماتية المفرطة مرتكزاتها في الغالب ذاتية ومصالح شخصيّة أو حزبيّة ضيقة. وتترتب على هاتين الطريقتين في التعاطي مع الأمور والقضايا السياسية أمراض وأخطاء خطرة، إما من فرط التطهر أو من ارتفاع منسوب القذارة»[41].
احتل موضوع توحيد المعارضة حيزًا كبيرًا من وقت الثورة والسوريين، ومساحة واسعة من خطابها السياسي. ليس المقصود بالطبع من وحدة المعارضة السعي نحو إيجاد شكل تنظيميّ واحد ونهج واحد وبرنامج سياسي واحد، إنما تعني هذه الوحدة التوافق على مبادئ وأساسيات عامة، وتوفير إطار تنظيمي يسمح بالحركة الحرة لأطرافها والمحافظة على برامجها الخاصة وهياكلها التنظيمية. والوحدة بهذا المعنى تسمح بتوزيع الأدوار والتكامل في ما بينها، وخصوصًا في ظل الثورة، لمصلحة تحقيق الأهداف الأساسية والتحدث بصوت واحد إلى الشعب السوري والعالم.
وكان إدراك هذه الضرورة ممكنًا لو توافر في المعارضة عقليات ذات حسابات سياسية إستراتيجية ترضى بأداء دور «الجسر الموقّت» بين الثورة والمستقبل، خصوصًا لجهة التكهن بما يمكن أن يكون عليه مسار الحوادث في سورية، في حال وجود عدّة كتل سياسية تتنازع على الشرعية وتتسبب بتشويش الحراك الشعبي برؤاها وتصريحات الشخصيات المنضوية في كل منها، انسجامًا مع البدهيّة التي ترى أن خطورة ثورة بلا رأس تكمن في أنها يمكن أن تتحوّل بعد نجاحها إلى ثورة بألف رأس.
أما بالنسبة إلى مسألة «التدخل الخارجي»، فقد نوقشت خلال السنوات الثلاث بعد الثورة بكلمات بسيطة لها علاقة بالقبول أو الرفض من دون مناقشة جدية للبيئة الداخلية والدولية والإقليمية، ومن دون الخوض عميقًا في بحث احتمالات وإمكانات هذا التدخل. فأي خيار سياسي يفترض أن يوضع في الحصيلة في ميزان الربح والخسارة من زاوية المصلحة الوطنية. أي تجب مناقشة تفاصيل هذا التدخل – إن كان مطروحًا – وآلياته ومراحله ووسائله وأطرافه ومدته وتأثيراته ونقاطه الإيجابية والسلبية والمكاسب والخسائر، من زاوية مصالح سورية والسوريين.
كذلك، اعتقد بعضهم واهمًا أن العالم ينتظر رأي بعض الشخصيات أو القوى المعارضة كي يتدخل عسكريًا في الوضع السوري أو لا يتدخل. في الحقيقة إن المطالبين بالتدخل ليسوا قادرين على إقناع العالم بالتدخل إن كان العالم لا يريد التدخل أصلاً، كما أن الرافضين للتدخل لا يستطيعون أيضًا إقناع العالم بعدم التدخل إن كان الأخير قد عقد العزم على التدخل، فهذا الـ «الخارج» ليس رهن إشارة أحد، وهو لا يتدخل إلاّ إن أراد هو أن يتدخل، وإن تدخل فإنما يتدخل انطلاقًا من رؤيته واستراتيجيته ومصالحه[42].
أما بالنسبة إلى الخلافات والنقاشات التي دارت حول عسكرة الثورة السورية، فيمكن القول إن خيار العسكرة هو خيار اضطراري دفاعي وليس خيارًا مبدئيًا للثورة السورية، اضطُر إليه الشعب السوري نتيجة إمعان النظام في عنفه وقتله وتدميره البلد وقهره أهلها. ولذلك يمكن القول اليوم إن أي رؤية لا تضع مسؤولية العسكرة بالدرجة الأولى على النظام السوري، إلى جانب المجتمع الدولي بالطبع، هي رؤية قاصرة. لكن بالمقابل، كان حريًا بالمعارضة السياسية تنظيم العسكرة وضبطها ووضع معايير ممكنة التطبيق لها، بدلاً من تركها تذهب بعيدًا في الفوضى، لتسيطر صبغة دينية متطرفة على العديد من مكوناتها[43].
ولكي تتحقّق هذه الاشتراطات فإن دور السياسيين أساسي في هذا المضمار، خصوصًا من حيث تأليف مظلة سياسية متماسكة وموثوقة، ومن خلال التأكيد الدائم على التزام العسكريين بالمعايير القانونية والمهنية والأخلاقية، ومحاولة إقناع المنشقين عن الجيش النظامي بالالتزام بها وتبيان مخاطر الابتعاد عنها. كذلك هناك دور رئيس للقادة العسكريين المنشقين في التأكيد على الالتزام بالمهنية العسكرية والأخلاقيات العسكريّة التي لا تتعرض للأسرى والمدنيين بالسوء مهما كان انتماؤهم وتوجهاتهم ودورهم وعدم تنصيب أنفسهم قضاة يحاكمون الناس ويتخذون القرارات في شأنهم دون محاكمات نزيهة عادلة من قبل جهات قضائية مستقلة ومعترف بها من جانب الشعب السوري، والأهم عدم الاندراج في خطاب طائفي مقيت يقدم للنظام السوري كل ما يحتاجه من مبرِّرات ومسوِّغات، ويسهم في تخويف السوريين من الثورة والمستقبل.
6- مؤتمر جنيف وما بعده
في 30 حزيران/يونيو 2012 اتفق وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف على العمل من أجل «جمع الطرفين المتصارعين في سورية على طاولة الحوار» لوقف النزاع الدموي، وكان بيان جنيف1. واكتسبت مبادرة كيري ولافروف زخمًا أكبر بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية شنته القوات النظامية السورية على بلداتٍ في ريف دمشق في 21 أغسطس/آب عام 2013، وأسفر عن مقتل مئات الأشخاص.
وفي السابع والعشرين من سبتمبر/أيلول تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2118 الذي طالب بتدمير، أو التخلص من، الترسانة السورية من الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف العام الجاري 2014. كما دعا القرار إلى «عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن لتطبيق بيان جنيف1 حول سورية»، وطالب الأطراف السورية كافة بالمشاركة الجادّة والبنّاءة، والالتزام بتسوية سياسية للوضع السوري من خلال تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، تضم أعضاءً من الحكومة السورية والمعارضة تُشكَّل على أساس القبول المتبادل من الطرفين. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2014 عقدت الجولة الأولى من مؤتمر جنيف 2 دون تحقيق نتائج مهمة في مسار التسوية السياسيّة للأزمة السوريّة. وحتى الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت في 10 شباط/فبراير 2014، وصلت كذلك إلى طريق مسدود.
وحاول الطرفان، النظام والمعارضة، تحقيق مكاسب إعلامية ودبلوماسية في ظل العجز عن تحقيق أي اختراق على صعيد القضايا السياسية الجوهرية، وحتى الإنسانية والإغاثية، ففي ظل الاستقطاب والفجوة الواسعة الموجودة بين النظام والمعارضة وانعدام أي قواسم مشتركة بينهما، لم يكن لدى أي من المشاركين في مؤتمر جنيف 2 أي أوهام بشأن ما يمكن أن يُنجز خلال جولتي التفاوض.
وعلى الرغم من الأزمة السياسية والاقتصادية والمجتمعية الحادة التي تعيشها سورية منذ انطلاق الثورة في آذار/مارس 2011، والتداعيات والآثار الإنسانية المأساوية للصراع المسلح الجاري فيها، أجرى النظام السوري في 3 حزيران/يونيو 2014 «انتخابات» رئاسية، روج لها، بالتعاون مع حلفائه الإقليميين والدوليين، باعتبارها أول «انتخابات تعددية» تُجرى في سورية منذ عقود. بينما رُفضت هذه الانتخابات من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وتركيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها، لأنها «تنسف الجهد الرامي إلى حلٍّ سياسيٍ في سورية»، فإجراؤها يعني تعميق الصراع واستمراره والقضاء على فرص حله سياسيًا. أما الائتلاف الوطني وبقية تكتلات المعارضة، فقد أجمعوا على رفض الانتخابات ومقاطعتها، ووصفوها بأنها «غير شرعية».
ومن المهم الإشارة إلى أن قوى الثورة السورية وأطياف المعارضة كافة لا تزال تواجه النظام دون خطة واضحة ومحدّدة، إذ على الرغم من معرفتها قبل فترة كافية بنيّة النظام إجراء الانتخابات الرئاسية، فإنها لم تقم بما يلزم من خطط ومبادرات لإحباط مساعيه والرد عليها. واليوم، وبعد الانتخابات، فإن المعارضة السورية ستكون في وضع صعب بحكم تشرذم صفوفها سياسيًا وعسكريًا، وعدم حصانتها من انشقاقات ممكنة بفعل مساعي النظام أو ضغط بعض الدول عليها، أو بحكم حالة الإحباط التي تسربت إلى بعض مكوناتها. هناك مهمات ضرورية يفترض بالمعارضة الاهتمام بها وإنجازها، كالقيام بدورٍ سياسي إعلامي عقلاني وناضج، وتقديم خطاب وطني سوري جامع، وإعطاء دفع جديد للقضية السورية في المجتمع الدولي باعتبارها قضية سياسية وطنية بالدرجة الأولى وليست مجرد عمليات إغاثة إنسانية.
أظهرت المحطات السياسية كافة، على مدى أربع سنوات، منذ انطلاقة الثورة السورية وحتى اليوم، أن المعارضة السياسية السورية لم تكن مؤهلة فكريًا وسياسيًا وإعلاميًا وتنظيميًا. كما ظهر جليًّا أن الانتصارات التي تحققت للثورة السورية، خصوصًا في سنتها الأولى، لم يكن فيها للمعارضة بتشكيلاتها السياسية كافة أي مساهمة جدية، إنما تحققت بفعل إصرار الثورة على الأرض، وبحكم الأداء السياسي والإعلامي الهزيل للنظام وأخطائه العديدة. وبالتالي، فإن المظلة السياسية التي يستحقها الشعب السوري، وبإمكانها أن تأخذ الثورة في اتجاه تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة، لم تولد بعد، وسيظل إيجادها أمرًا مشروعًا وضروريًا على الرغم من تعقد الوضع السوري وانفتاحه خلال السنوات الأخيرة على تدخلات خارجية عديدة.
رابعًا: السياسة الخارجية السورية وتحالفات النظام الإقليمية والدولية
1- مرتكزات السياسة الخارجية للنظام السوري
تسعى السياسة الخارجية في الدول الطبيعية إلى الحفاظ على السيادة والاستقلال والأمن القومي والمصالح الاقتصادية، وتأمين القدرة على الحركة وتوفير مستلزمات التأثير في المجال الحيوي للدولة، أي امتلاك وسائل ومقومات الفعل في المحيط الإقليمي والعلاقات الدولية. وهناك عوامل عديدة تؤثر في نهج ومرتكزات السياسة الخارجية للدولة، مثل تاريخ هذه الدولة ومساحتها وعدد سكانها وموقعها الجغرافي وجغرافيتها السياسية، لكن يبقى العامل الحاسم هو الوضع الداخلي وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي المهيمن فيها، على اعتبار أن السياسة الخارجية لدولة من الدول، بمعنى ما، هي امتداد للسياسة الداخلية. ففي الدول الطبيعية يكون صوغ القرارات والسياسات الخارجية نتيجة أو حصيلة ذلك التداخل الواضح بين الديناميات الداخلية والخارجية، خصوصًا في ظل المتغيرات العالمية التي جعلت إقامة حدود فاصلة بين ما يندرج ضمن السياسة الداخلية، وما يرتبط بالممارسة الخارجية للدولة، أمرًا صعبًا أو مستحيلاً.
لقد شكلت السياسة الخارجية السورية، على مدار عقود، أحد أهم مصادر الشرعية للنظام السياسي منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في 8 آذار/مارس 1963. لذلك تعتبر عملية مقاربة هذه السياسة، وإدراك مرتكزاتها وآلياتها وممارساتها وأهدافها، مسألة مهمة لفهم تحالفات النظام وقدرته على استثمار علاقاته في سبيل البقاء وتحصين نفسه، خصوصًا في فترة الثورة السورية التي أظهرت عمق تحالفاته الإقليمية والدولية وصلابتها.
إذ ترتكز السياسة الخارجية للنظام السوري في الخطاب العلني إلى عقيدة قومية هدفها التضامن العربي وتحقيق الوحدة بين أقطار الوطن العربي، وإلى العمل على استعادة الجولان المحتل ودعم القضية الفلسطينية في مواجهة العدو الإسرائيلي واعتبارها قضيتها المركزية، وإلى مواجهة «المشروع الأميركي» في المنطقة.
أما من حيث طابعها العام، فلم تكن السياسة الخارجية السورية معنية، على ما يبدو، بتحسين سمعتها وصورتها في المجتمع الدولي، وتبديد النظرة المليئة بالريبة تجاهها، إذ كانت تأخذ طابعًا متنقلاً وسريعًا ما بين اتجاهات متعارضة أو متناقضة، فتبدو أحيانًا كسياسة متهورة تفتقر إلى المعايير العقلانية والواقعية، وأحيانًا تلهث وراء كسب ود الآخرين بكافة السبل، وتارة تنتحل خطابًا حادًا ومعاديًا، ولا تترك وسيلة، شرعية أو غير شرعية، في التعبير واقعيًا عن نفسها، وتارة أخرى تذهب نحو الميلان بالزاوية التي يريدها الآخرون[44].
على أرضية هذه الأهداف المعلنة، قامت هذه السياسة خلال العقود الأخيرة بتوسيع دائرة نفوذها في المحيط الإقليمي، ومحاولة فرض مواقفها وسياساتها، عبر التدخل السياسي والعسكري في الشؤون الداخلية للبلدان العربية والإقليمية أو التأثير على نشاط وتوجهات الحركات والأحزاب والجماعات المختلفة في المنطقة، كالتدخل في النزاع العراقي – الإيراني، والنزاع الكردي – التركي، والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والصراع اللبناني – الإسرائيلي، والتدخل في علاقات القوى والجماعات ببعضها بعضًا كما هو عليه الحال في لبنان.
وتعامل النظام السوري طوال عقود مع منظورٍ ضيقٍ للمصلحة الوطنية السورية، واختزلها إلى السعي الدائم إلى القيام بدور فاعل في المحيط الإقليمي، واللعب في ساحات الآخرين، الأمر الذي يؤهله على الدوام لدفع الضغوط الخارجية عنه من أي لون ومصدر، وكف يد الآخرين عن التأثير في الأوضاع الداخلية في سورية. وقد نجح النظام في محطات عديدة سابقة في تخفيف الضغوط الخارجية عليه باستخدامه عناصر الضغط التي يملكها في الملفات الإقليمية كافة، في لبنان والعراق وفلسطين، وساعده في ذلك وضع سورية التاريخي والجغرافي بوصفه بلدًا أساسيًا في المنطقة ومرتبطًا بجميع أزماتها وملفاتها، كما ساعده أيضاً فشل الحسابات الأميركية في المنطقة، وعجزها عن تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الأمني في العراق.
اعتمدت السياسة الخارجية السورية على المحاولة الدائمة لاحتواء النضال الفلسطيني كلية، ودخلت في مواجهات مسلحة مع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وبسبب عدم قدرتها على الاحتواء عملت على تفكيك الصف الفلسطيني، وانحازت بشكل صريح إلى القوى الفلسطينية المعارضة لياسر عرفات ومحمود عباس، ورعت التنسيق بينها، وحولتها إلى أوراق تضغط بها على خصومها السياسيين، مما أعطاها هامش مناورة كبيرًا في العلاقات الإقليمية والدولية، لكنه لم ينعكس إيجابًا على القضية الفلسطينية[45].
في الحقيقة لم يكن البعد القومي إلا غطاءً لسياسة خارجية محركها الفعلي هو خدمة النظام وتأمين دفاعاته ومصالحه، حتى لو كان ذلك على حساب المصالح الوطنية السورية أو المصلحة القومية العربية، وليس من الصعب اكتشاف أن تنقلات هذه السياسة ما بين «الممانعة» المتطرفة والبراغماتية البحت غير المستندة إلى مبادئ حقيقية للمصالح الوطنية، ولا تهدف في الحصيلة سوى إلى تثبيت نظام الحكم.
وطوال عقود افتخر النظام السوري وإعلامه بنجاحات سياسته الخارجية، على الرغم من أن انعكاس هذه «النجاحات» في المستوى العربي كان على العموم سلبيًا، ولا أحد يستطيع الادعاء بأن علاقات سورية كانت على ما يرام مع أشقائها العرب، كما أنها ازدادت سوءًا بعد انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011، كما إن هذه «النجاحات» المعلنة لم تؤدِّ إلى رفع سوية المناعة الوطنية أمام الاعتداءات الخارجية، فالطائرات الإسرائيلية لم تجد أي حرج أو صعوبة في دخول الأجواء السورية وانتهاك السيادة الوطنية، وضرب ما تريد أن تضربه من مواقع في مرات عديدة. ومن جانب آخر، لم تنعكس تلك «النجاحات» المعلنة إيجابًا على الداخل السوري، فالسوريون لم يتلمسوا، كالعادة، هذه «النجاحات»، لأنها بداهة لم تثمر تنمية اقتصادية وتحسنًا في أوضاعهم المعيشية، أو توسيعًا لمشاركتهم في الشأن العام، أو نقلاً لأوضاع بلدهم من حالة التردي والترهل إلى حالة صالحة لاستيعاب أبسط حقوقهم الآدمية[46].
وجعلت السياسة الخارجية السورية النظام قويًا في المحيط الإقليمي، ومؤثرًا في العلاقات الدولية، وقادراً على المناورة وتجنب الضغوط الخارجية، وحققت شكلاً من أشكال الاستقرار الداخلي في نظام الحكم بعد تجارب من الانقلابات العسكرية، لكنه استقرار سلبي، قائم على نظام استبدادي، وعلى المحافظة على ركود الحياة السياسية والاقتصادية، وشلل الحياة العامة. إنه استقرار غير منتج للتقدم في أي مستوى، ويضع البلاد في مخاطر عديدة على الدوام، داخلية وخارجية، لأن قوة الأوطان لا تحققها المناورات والتكتيكات الجزئية للسياسة الخارجية، بل تنبع أساسًا من وجود بناء داخلي راسخ، يعكس نفسه في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، وخير دليل على ذلك أن سورية أصبحت بعد آذار/مارس 2011 دولة تتدخل فيها جميع دول العالم.
إن عدم سعي النظام طوال عقود إلى الإصلاح الداخلي لم يبعث على الطمأنينة إزاء سياسته الخارجية، وولّد حالة من عدم الثقة بها، داخل سورية وخارجها، لدى الأصدقاء والأعداء على السواء، لأن هذه السياسة لا ترتكز إلى توافق وطني في الداخل، بل تنطلق من متطلبات وحاجات ومصالح فئة ضيقة. لذلك، فإن وجود دولة وطنية ديمقراطية حديثة شرط ضروري لبناء سياسة خارجية وطنية، والدولة الوطنية هي الدولة التي تتوافر فيها السمة العمومية وتكون مؤسساتها، التشريعية والقضائية، مستقلة عن السلطة الحاكمة، وتنطلق من، وتهدف إلى، مصالح الكل الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان والمواطن.
2- العلاقات السورية – اللبنانية
في الفصل التاسع من الكتاب: «إزالة الغموض في السياسة الخارجية في عهد بشار الأسد»، يرى باسل فوزي صلوخ (Bassel F. Salloukh) أن تأثير سورية الإقليمي في عهد الرئيس حافظ الأسد يرجع إلى حدٍّ كبيرٍ إلى نجاح دمشق في إخضاع لبنان وتوظيفه في خدمة الأهداف الجيوسياسية لسورية، ولا سيّما سعي الرئيس الدائم ليثبت لواشنطن وتل أبيب أهمية سورية التي لا غنى عنها في أي عملية للسلام قابلة للديمومة. إذ افترض حافظ، ومن بعده بشار الأسد، أن هناك علاقة سببية بين ثقل دور سورية في محيطها المباشر واستقرار النظام البعثي. وبهذا الصدد، خدم لبنان باعتباره أداة لتقدم السياسة الإقليمية السورية، وبوصفه منطقة عازلة تواجه تهديدات استقرار النظام، لا سيما أن دمشق كانت تقلق بشكلٍ خاصٍّ من دور لبنان كرأس جسر لزعزعة استقرار النظام.
وارتسمت في لبنان شخصية الدولة السورية من خلال سياستها الخارجية هناك، شخصية مافيوية، قائمة على حكم ضيق ومغلق، ويستند إلى أدوات استخبارية محضة في الفعل والتأثير، الأمر الذي حول لبنان على مدار ثلاثين عامًا إلى مجرد ملف على جدول الأجهزة الأمنية[47]. وقدم لبنان للنظام السوري، على الدوام، مجالاً واسعًا لحل أزماته السياسية والاقتصادية، فمن جهة كانت أرضه ساحة حرب مباشرة أو غير مباشرة في محطات عديدة بين إسرائيل وسورية، ومن جهة أخرى كان نافذة اقتصادية مفتوحة على الدوام أمام الأزمة الاقتصادية المستعصية في سورية.
أسئلة كثيرة تطرح حول الوجود السوري في لبنان، الذي ما كان من الممكن أن يستمر ثلاثة عقود دون موافقة أميركية. كذلك ما كان النظام ليتمكن من القضاء على «تمرد» الجنرال ميشيل عون، لولا استثماره لمناخ حرب الخليج الثانية، كما استثمر مناخ ما بعد الحادي عشر من أيلول 2001، عن طريق التلويح بالتطرف الإسلامي وحزب الله، لتخويف أميركا والغرب عمومًا، وتبرير سياسة البقاء في لبنان.
لم تبن العلاقات السورية – اللبنانية على أسس سليمة ومتوازنة، وبسبب ذلك تعرضت هذه العلاقات بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى هزة عنيفة، وشهد النظام في دمشق أكثر ساعاته حلكة عُقب ذلك، وكان بعض من أعضائه مقتنعًا بأنه بات قاب قوسين أو أدنى من السقوط، كما ظهرت إلى العلن حالة من العدائية بين قطاعات واسعة من الشعبين السوري واللبناني نتيجة بروز «وطنية» سورية بالمعنى السلبي كردة فعل على خروج الجيش السوري من لبنان مجبرًا.
تخلص النظام السوري من الحريري، مباشرة أو عبر وكلائه في لبنان، بسبب التهديد الذي كان يشكله، ليس على مكانته في لبنان فحسب بل على أمن النظام السوري أيضًا. وكان المقصود من الاغتيال تحييد التهديد المتشابك الداخلي والخارجي لأمن النظام: فقد كان الحريري ينظِّم تحالفًا لبنانيًا قويًا عابرًا للطوائف، مدعومًا بتحالف إقليمي ودولي، ويهدف إلى تخليص لبنان من قبضة سورية[48].
وبعد انسحاب القوات السورية من لبنان في 25 نيسان/أبريل 2005 أصبحت المعركة على لبنان هي ما سيحدِّد نتيجة صراعات السياسة الخارجية الإقليمية والدولية لسورية. فقد فتح انسحاب القوات السورية الباب لمرحلة جديدة في علاقات سورية مع لبنان، إذ أصبح لبنان، إضافة إلى العراق والضفة الغربية وغزة، ساحة رئيسية لمعركة جيوسياسية كبرى، وضعت الولايات المتحدة، وفرنسا، وما يسمى بدول «الاعتدال» العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في مواجهة ضد سورية، وإيران، وحزب الله، وحماس والجهاد الإسلامي.
لم يكن خروج القوات والاستخبارات السورية من لبنان نهاية المطاف، بل استمرت الهيمنة بأشكال أخرى من خلال حزب الله وحركة أمل ومجموعات سياسية أخرى محسوبة على النظام السوري. وجاء اتفاق الدوحة في 21 أيار/مايو عام 2008 لينهي المواجهة السياسية في لبنان بطريقة مواتية لحلفاء سورية، ثم التأليف اللاحق في 11 تموز/يوليو 2008 لحكومة وحدة وطنية حصلت فيها المعارضة على حق النقض، وهذا كله أغلق فصلاً صعبًا في السياسة الخارجية السورية آنذاك.
ويمكن القول إن مستقبل العلاقات بين البلدين رهن بخروج لبنان معافى من أزمته السياسية المستمرة، وخصوصًا الانقسام الحاصل في المجتمع اللبناني، والانتصار لمنطق الدولة في لبنان، لكن العامل الأهم يتعلق بتطورات الوضع الداخلي في سورية، لا سيما في ما يتعلق بالصراع الدائر اليوم في سورية والهيمنة الإيرانية والتدخلات الدولية ومفاعيل الثورة السورية بعد آذار/مارس 2011، إذ إن احتمال حدوث تطور إيجابي بين البلدين نحو علاقات طبيعية خالية من عناصر الهيمنة والتدخل في الشأن اللبناني، يتوقف على رحيل النظام السوري والمحافظة على وحدة سورية وحدوث تغيير ديمقراطي، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة.
-3 العلاقات السورية – التركية
في الفصل العاشر من الكتاب: «بداية صداقة حسنة: العلاقات السورية التركية منذ العام 1998»، يناقش فريد اتش لاوسن (Fred H. Lawson) التغيرات التي طرأت على العلاقات بين النظام السوري وتركيا حتى عام 2010. فقد تحسنت هذه العلاقات بشكلٍ كبيرٍ خلال العقد الماضي، مع العلم أنه كان من الممكن للدولتين اللجوء إلى القوة المفرطة في تشرين الأول/أكتوبر عام 1998، في ضوء التوترات طويلة الأمد، وانعدام الثقة المتبادل الذي كان يعكس الخلافات المستمرة حول توزيع مياه نهر الفرات، والادعاءات التركية المتواصلة بأن السلطات السورية كانت تقدم الدعم المادي والمعنوي لحزب العمال الكردستاني المتطرف (PKK).
ومع حلول خريف عام 2008، أصبح تكرار هذا النوع من المواجهة العسكرية من المستحيل تصوُّره تقريبًا، ويمكن القول إنه خلال العقد الماضي تحسنت علاقات سورية مع تركيا بشكلٍ كبيرٍ، فقد ازدهرت المعاملات الاقتصادية، وتوسع التعاون الحكومي، وتعززت العلاقات العسكرية والأمنية، وحتى مشكلة توزيع المياه العصيبة بدأت تبدو وكأنها ممكنة الحل.
ويشير محلِّلون – بحسب فريد اتش لاوسن (Fred H. Lawson) – إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والعسكرية لتفسير هذا التغيّر، وينقل عن كلٍّ من مصطفى آيدين ودملا آراس قولهما إن دفء العلاقات حدث بعد أن «اختارت أنقرة سياسة نمو موجهة نحو التصدير بدلاً من سياسة إحلال الواردات التي كانت مفضلة لوقتٍ طويلٍ». لكنهما أشارا أيضًا إلى أن كبار القادة الأتراك، وليس المُصنعين والتجار، هم من أشرفوا على الحملة الكاملة لتحسين العلاقات مع سورية. ولم يكن هذا التحسن إلا بعد أن وافقت دمشق على قطع كل صلاتها بحزب العمال الكردستاني، ومن ثم تم اتخاذ مجموعة من التدابير المتنوعة لتشجيع التوسع التجاري[49]. وهناك أسباب أخرى لهذا التغير، إذ أصبح لسورية أهمية كبيرة في السياسة الخارجية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، ففرضت المشكلات الأمنية الناجمة من احتلال العراق، والمشكلة الكردية، مزيدًا من التنسيق والتقارب بين الطرفين، إلى درجة ظلت فيها تركيا البوابة الوحيدة للنظام السوري إبان العزلة الدولية المفروضة عليه بعد اغتيال الحريري في عام 2005. ويمكن تلمّس ذلك من خلال دلائل عدة أبرزها: «الدور التركي في المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل عام 2008، وتأسيس مجلس تعاون إستراتيجي مشترك في 16 أيلول/سبتمبر 2009، والمناورات العسكرية المشتركة بين البلدين في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009»[50].
ومع بداية الثورة السورية في آذار/مارس 2011 اتخذت تركيا موقفًا ناقدًا للنظام ودعته إلى الإصلاح، ثم ما لبثت أن بدأت تلعب دورًا فعالاً. وكانت تركيّا الدولة الوحيدة من بين الدول الجارة الأربع لسورية (العراق، لبنان، الأردن، تركيا) التي دعمت الثورة السورية بشكلٍ واضح.
ويمكن تقسيم الموقف التركي تجاه النظام والثورة السوريّة – بحسب ما يذكر عزمي بشارة[51] – إلى مرحلتين: الأولى، دعم فكرة الإصلاح بقيادة النظام لتجنب معضلة شبيهة بما واجهته تركيا في ليبيا، وتمتد هذه المرحلة منذ انطلاق الاحتجاجات في درعا 18 آذار/مارس 2011 وحتى زيارة وزير الخارجية التركي إلى دمشق 9 آب/أغسطس 2011. فقد حاولت تركيا ما أمكن الضغط على حليفها (النظام) لاحتواء الحركة الاحتجاجية من خلال إصلاحات جدية لتجنب خسارة هذا الحليف على غرار ما حصل مع نظام معمر القذافي، ومن أجل المحافظة على مصالحها الجيوستراتيجية.
وفي المرحلة الثانية: ظهر أن محاولات تركيا في إقناع الأسد الأخذ بنصائحها في ما يتعلق بعملية الإصلاح لم تنفع، إذ ادعى النظام أن الحراك الشعبي في سورية ليس أكثر من حراك أقلية مجتمعية تدفعه دول خارجية، وأن علاقاته الدولية والإقليمية، إلى جانب ضمانه لولاء الجيش والمؤسسة الأمنية (خلافًا لحالتي مبارك وزين العابدين) يمكنه من القضاء عليها، وبعدها يقوم بتطبيق «الإصلاحات» التي تناسبه. ونتيجة لذلك اتبعت تركيا نهجًا جديدًا يقوم على تصعيد اللهجة السياسية ضد النظام، والانفتاح على قوى المعارضة السورية ومنحها التسهيلات لعقد اجتماعاتها على الأراضي التركية. لكن تركيا لم تنجح في تغيير أساليب النظام ودفعه إلى القيام بإصلاح سياسي حقيقي يوقف تقدم الوضع باتجاه كارثي، خاصة مع بدء عسكرة الثورة آنذاك. ومع تقدم الثورة باتجاه العمل العسكري قامت تركيا بدعمه ومنحه التسهيلات الممكنة، كما قامت بدور مهم على صعيد العمل الإغاثي.
وثمة عوامل عديدة أفشلت المساعي التركية، وكان أهمها امتناع الولايات المتحدة من لعب دور فاعل في الأزمة السورية، إلى جانب موقف روسيا، وإيران التي جعلت من حماية النظام السوري قضيتها، وبالتالي لم تشأ تركيا إحداث أزمة في العلاقات مع إيران بعد أن تطوّرت خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في الحيز الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك رفض المؤسسة العسكرية التركية أي تدخل عسكري أو إنشاء منطقة عازلة على الحدود السورية، فالجيش التركي ظل أحد أبرز الفاعلين الأساسيين في تركيا من حيث رسم الإستراتيجية التركية في قضايا الحرب والسلم على الرغم من نجاح حزب العدالة والتنمية في الحد من دوره السياسي.
وكذلك، لا يمكن التغاضي عن الرأي العام التركي الرافض التدخل العسكري في سورية على الرغم من وجود أغلبية شعبية مؤيدة للثورة السورية، إذ أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام التركي الذي أجرته مؤسسة «مارشال» الأميركية في شهر أيلول/سبتمبر عام 2012 أن نسبة 76 في المئة من الشعب التركي ترفض التدخل العسكري في سورية، وأن نسبة 18 في المئة فقط تؤيد مثل هذا التدخل[52].
كما كان هناك تأثير للمسألة الكردية على الدور التركي في سورية، حيث التقت مصالح بعض القوى الكردية السورية مع النظام السوري ضد تركيا، ولا سيما حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي يتبع قيادة حزب العمال الكردستاني المركزية في تركيا. كما ظهرت معارضة للدور التركي من جانب جزء كبير من المواطنين العلويين الذين يشكلون ثلث سكان تركيا تقريبًا[53].
وأسهم تضافر العوامل السابقة في الحد من قدرة حكومة العدالة والتنمية على القيام بدورٍ مؤثّرٍ وحقيقي على النظام السوري، من شأنه أن يغير إيجابيًا في مسار الثورة السورية.
4- العلاقات السورية – الإيرانية
تطورت العلاقات بين سورية وإيران كثيرًا منذ الثورة الخمينية في عام 1979 على الرغم من التناقض الأيديولوجي بين النظامين الحاكمين، واستمرت في التطور حتى بعد دخول النظام السوري في مفاوضات السلام مع إسرائيل برعاية أميركية في بداية التسعينيات. وأفسح النظام السوري المجال واسعًا لإيران حتى أصبحت رقمًا فاعلاً ومؤثرًا في جميع الساحات، في العراق ولبنان وفلسطين، وكان من الطبيعي أن يكون فعلها وتأثيرها مستندًا إلى المصالح الإيرانية، لا إلى المصالح الوطنية لتلك البلدان.
وانعكس التحالف مع إيران طوال ثلاثة عقود إيجابًا على ثبات النظام ورسوخه، ودفع الكثيرين إلى إعادة حساباتهم تجاهه، ومقايضته في مسائل عديدة، لكن هذا التحالف سمح لإيران بالدخول إلى عمق النسيج العربي والتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان عربية عديدة، واستخدامها كأوراق في صراعها مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الهيمنة على سورية بعد آذار/مارس 2011.
وفي الفصل الخامس من هذا الكتاب: «الأضرحة الشيعية في الرقة: التبشير الإيراني والدلالات المحلية»، تلقي ميريام عبابسة (Myriam Ababsa) الضوء على المحاولات المبكرة لإيران في توسيع سيطرتها وهيمنها في المنطقة من خلال إحياء ما تعتبره مراكز شيعية في سورية، وبدأت باكرًا في استخدام أضرحة الرقة برعاية النظام السوري. ففي عام 1988، حصلت الرقة على أكبر الأضرحة الشيعية في البلاد، والتي بنتها إيران، وتتألف من مبنيين متناظرين مخصصين لـ «عمار بن ياسر» و«أويس القرني»، صحابة النبي محمد اللذين لقيا حتفهما في معركة صفين عام 657م (37 هجري). وقد وضعت المباني الجديدة الرقة من بين مجموعة مواقع الحج التي حلَّت محل الأماكن المقدسة العراقية، النجف وكرباء، والتي كانت مغلقة أمام الحجاج الإيرانيين لعقدين من الزمن بعد عام 1980. وتشمل المواقع البديلة في سورية أيضًا ضريح السيدة زينب، جنوبي دمشق، وضريح السيدة رُقيَّة، بالقرب من المسجد الأموي في العاصمة.
وكانت أضرحة الرقة المُرممة في منزلة مناورة سياسية من إيران والنظام السوري، واستخدمت المدينة لعقد مؤتمرات عديدة عكست موقفًا انفتاحيًا تجاه المذهب الشيعي في سورية، والذي تم قبوله أكثر وأكثر من جانب السكان، إذ قُدمت الشيعية باعتبارها مرتبطة بصراع حزب الله ضد قوات الجيش الإسرائيلي. ومع بداية انتفاضة الأقصى، أصبحت المناسبات الثقافية التي يجري تنظيمها في الأضرحة أكبر وأكثر تسييسًا بكثير. وبالتالي، وفي عُقب «المجازر» التي ارتكبت في مخيم جنين في نيسان/أبريل عام 2002، تم تنظيم تجمعٍ كبيرٍ في يوم الجمعة السادس عشر من ذلك الشهر من جانب السفارة الإيرانية وحزب البعث المحليّ في ضريحي عمار وأويس، تحت اسم «احتفالية تضامن مع الانتفاضة»[54].
وقد شهد مطلع العام 2004 الإعلان الرسمي لمشروع بناء جديد يخص المواقع الشيعية في سورية، وهو «موكب السبايا». ويتألف من المواقع كافة التي يُقال إن رأس الحسين المقطوع قد مرَّ بها خلال رحلته من كربلاء إلى دمشق عام 680، بأمرٍ من الخليفة يزيد. فإيران ترغب في تعليم ورسم الطريق بأكمله من كربلاء إلى دمشق بنُصبٍ تذكارية لهذا الحدث العظيم من سير الشهداء الشيعة وبذلك تعطي فرصة أكبر للحجاج للمناجاة في سورية باتباع خطوات أبناء عليِّ. وفي هذا السياق، تشكل أضرحة الرقة المرحلة الأولى من الطريق الجنائزي[55].
كما دفع احتلال أميركا للعراق في عام 2003 الدول الإقليمية إلى إعادة النظر في تموضعها في المنطقة، وبالتالي شكّل احتلال العراق فرصة ملائمة لإيران للتمدد في الساحة العراقية مستغلَّة التقاطعات المذهبية مع جزء من الشعب العراقي، والتي تحولت إلى تقاطعات مذهبية سياسية مع الشيعية السياسية العراقية، وهي نزعة «تراهن على تحويل التنوع الطائفي العربي إلى ولاءاتٍ سياسية لدول غير عربية»[56]، فقد دعمت إيران عملية تركيز الحكم في العراق في يد سلطة مدنيّة – أمنية تملك نهجًا طائفيًا وإقصائيًا في الداخل العراقي.
وفي سورية، اتخذ النظام الإيراني موقفًا داعمًا للنظام السوري في مواجهة الثورة التي انطلقت في آذار/مارس 2011. إذ تبنى منذ البداية رواية النظام السوري للحوادث؛ ووصف الثورة السورية بالمؤامرة الأجنبية التي تستهدف صمود ومقاومة سورية، كما رأت إيران في الثورة محاولة لتقويض دورها في المنطقة بما يضر بالمصلحة القومية للدولة الإيرانية. وفي الحقيقة لا يمكن فهم استمرار النظام السوري وتماسكه النسبي في وجه ثورة عارمة لفترة طويلة من دون الدعم الإيراني للنظام سياسيًا وماليًا وعسكريًا. وهو موقف كثفه رجل الدين الإيراني مهدي طائب، رئيس مقر «عمار الإستراتيجي» لمكافحة الحرب الناعمة الموجهة ضد إيران في 15 شباط/فبراير 2013 بالقول: «لو خسرنا سورية لا يمكن أن نحتفظ بطهران، ولكن لو خسرنا إقليم خوزستانا (الأهواز) سنستعيده ما دمنا نحتفظ بسورية»[57]. كما أوضحه رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية فيروز أبادي في 8 آذار/مارس 2013 عندما قال: «سندافع عن سورية بكل وجودنا»[58].
لقد رفضت إيران سقوط النظام السوري بحكم خشيتها من طبيعة النظام المقبل في سورية، فقد رأى المسؤولون الإيرانيون أنه في حال سقوط الأسد سيكون النظام المقبل أقرب إلى تركيا، لذلك تعاملت إيران مع سورية وكأنها ولاية من ولاياتها، كما خشيت من أن سقوط النظام السوري قد يؤدي إلى تشجيع المعارضة الإيرانية على التمرد وإطلاق عملية التغيير في إيران ذاتها.
بالتأكيد يندرج موقف إيران من النظام السوري والثورة في إطار سياسة خارجية إيرانية كبرى ترتكز على خمسة أسس رئيسة هي[59]: 1: مصلحة إيران القومية كدولة. 2: تعزيز قوة إيران وتأثيرها الإقليمي. 3: السيطرة والتأثير في المعابر المائية في الخليج. 4: الشيعية السياسية كأيديولوجية دولة، وكأداة في العلاقات مع الطوائف الشيعية المحيطة بإيران، إضافة إلى الشعور القومي الإيراني بمقومات دور دولة إقليمية عظمى من حيث الثروة والحجم والعراقة الحضارية. 5: العداء للسياسة الأميركية منذ نجاح الثورة الإسلامية 1979. فإيران لا تنظر إلى سورية من منظار تصدير الثورة الإسلامية، أو التشييع، أو الروابط المذهبية بين مذهب إيران الرسمي «الاثني عشري»، ومذهب بشار الأسد الذي أصبح يعتبر بإرادة سياسية «جعفريًا»، وإنما من منظور المصلحة القومية الإيرانية بشكل رئيس، على الرغم من أهمية المحدّد المذهبي في سياستها الخارجية.
وخلال سنوات الثورة السورية، ظهر أن الارتباط بين النظام السوري وإيران قد تجاوز مستوى التحالف إلى التبعية الكاملة. إذ أن استمرار الثورة أدى إلى استنزاف النظام السوري عسكريًا واقتصاديًا حتى أصبح معتمدًا على الدعم الإيراني في فرص بقائه واستمراريّته، وأصبحت إيران تتعامل مع الصراع في سورية باعتباره «أزمة داخلية إيرانية» مرتبطة بشكلٍ وثيقٍ بأمنها القومي، وهذا هو معنى طلبها من مجموعة (5+1) في 12 شباط/فبراير 2013 ضم ملفي سورية والبحرين إلى مفاوضات الملف النووي الإيراني[60]، وهو ما شكل تعبيرًا صريحًا وفجًا عن طموح النظام الإيراني التوسعي من خلال اهتمامه بتحديد مناطق التأثير والنفوذ، وأكد بالمقابل تبعية النظام السوري.
5- الموقف الأميركي من النظام السوري والثورة
في الفصل التاسع من هذا الكتاب: «إزالة الغموض في السياسة الخارجية في عهد بشار الأسد»، يحاول باسل فوزي صلوخ (Bassel F. Salloukh) تقديم تصور للعلاقات الخارجية السورية، ومن ضمنها ما يتعلق بالعلاقات السورية الأميركية، خصوصًا ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق في نيسان/أبريل 2003. فقد رأى بشار آنذاك أن حماية النظام تستلزم تخريب الاحتلال الأميركي للعراق بأي طريقة، وتحويل البلاد إلى فيتنام أخرى. وبناء على ذلك عمل على تمرير المقاتلين، العرب والأجانب، والأسلحة عبر الحدود السورية العراقية كردة فعل على التهديدات التي شكلها احتلال العراق بقيادة أميركية لنظامه.
وفي طريق موازٍ قام بتقديم عرض للتوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول عددٍ من المصالح المشتركة. ولعل مقالة العميد بهجت سليمان المدهشة في صحيفة السفير هي أفضل ما يمثل هذا الخط من التفكير. فقد اقترح سليمان، الذي كان آنذاك رئيسًا للفرع الداخلي في إدارة الاستخبارات العامة وشخصية نافذة داخل المؤسسة الأمنية، بشكلٍ غير مباشر أن سورية قد تساعد في السيطرة على حزب الله، والجماعات الفلسطينية المسلحة والجهاديين والسلفيين في لبنان، قد تعالج مسألة المكاتب الفلسطينية في دمشق، وتساهم في تحقيق استقرار العراق مقابل ضمانات الولايات المتحدة في ما يتعلق بأمن النظام وإعادة إدماج سورية في عملية السلام. ولكن، مقالة سليمان لم تخلُ من التهديدات. فالفشل في التوصل إلى اتفاق والإصرار بدلاً من ذلك على استهداف استقرار النظام أو السيطرة السورية على لبنان، كما أوحت المقالة، قد يُطلق العنان لعدد من المجموعات الإسلاموية التي كانت حتى الآن تلجمها شبكات الاستخبارات السورية، وهي حزب الله، وحماس والجهاد الإسلامي، لتعمل ضد المصالح الإقليمية لإسرائيل والولايات المتحدة[61].
ومع ذلك، فإن صورة بشار الأسد وهو يحضر قمة الاتحاد من أجل المتوسط في باريس في 13 تموز/يوليو 2008، واستضافة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إياه في 3 آب/أغسطس 2008، ومن ثم اجتماع قيادات كلٍّ من فرنسا، وقطر، وتركيا في دمشق في 4 أيلول/سبتمبر عام 2008، أكدت نهاية عزلة النظام الإقليمية والدولية آنذاك.
ومع مجيء إدارة أوباما في مطلع عام 2009 إلى الحكم، ظهر بوضوح الانكفاء الأميركي النسبي، والعزوف عن التدخل المباشر في مناطق مختلفة من العالم، كما مالت الولايات المتحدة باتجاه استخدام أدوات «القوة الناعمة» في العالم فحسب، وفي هذا السياق يأتي سعيها إلى تأمين انسحاب آمن للقوات الأميركيّة من العراق وأفغانستان.
كما يأتي موقف أميركا من الثورات في المنطقة العربية، ومنها سورية، في سياق هذه الإستراتيجية المستندة إلى عدم التدخل المباشر، لكن بروز الرأي العام الشعبي، بوصفه عنصرًا فاعلًا في البلدان التي انطلقت فيها الاحتجاجات أرغم الولايات المتحدة على الترحيب بها، ودعمها نسبيًا، إلى جانب محاولة احتواء تأثيراتها على عناصر إستراتيجيّتها في المنطقة (ضمان إمدادات النفط، أمن إسرائيل، مكافحة الإرهاب) من دون الاضطرار إلى التدخل عسكريًا.
وفي سورية، لم يتغير الموقف الأميركي جوهريًا منذ البداية وحتى اليوم، إذ على الرغم من مطالبتها الأسد بالاستجابة لمطالب المحتجين في بدايات الثورة، ثم مطالبتها برحيله، وفرضها عقوبات اقتصادية عليه، فإنها لم تعمل على إسقاطه حتى بعد استخدامه السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية في آب/أغسطس 2013، واكتفت بعد ذلك بمساعدة المعارضة بشكل محدود، والدفع باتجاه إيجاد حل سياسي.
والواقع أن عوامل عديدة حكمت الموقف الأميركي[62]، من أبرزها: 1- عدم امتلاك أميركا أدوات تأثير أو تحكم في سورية، بما فيها ضعف التبادل التجاري والاقتصادي، وهذا يضعف من قدرتها على التأثير في الوضع الداخلي وموازين القوى فيه. 2- التركيبة الطائفية والإثنية المعقدة في المجتمع السوري المشابهة للوضع في العراق، والاحتمالات العالية المتوقعة من الفوضى. 3- تعقيد النظام السوري بحكم ما يملكه من تأثير في ملفات عديدة في الشرق الأوسط كلبنان وفلسطين والعراق، وارتباطه الوثيق بإيران وما يمثله ملفها النووي من تهديد. 4- التأثير على إسرائيل، فأميركا معنية بما يمكن أن يخلقه سقوط النظام السوري من تأثيرات على إسرائيل. 5- ضعف تكوين المعارضة السياسية في سورية، وعدم نضجها، وهشاشة انغراسها في المجتمع السوري بحكم حداثة سنها. 6- التخوف من الطابع العقائدي للجماعات المقاتلة، بعد أن انتقلت الثورة إلى طورها المسلح، على الرغم من أن ذلك حدث بسبب امتناع أميركا وغيرها من تسليح «الجيش الحر».
وفي العموم، لم تكن الولايات المتحدة مناصرًا حقيقيًا للثورة السورية. وتبيّن أن هناك بونًا واسعًا بين تصريحات المسؤولين الأميركيين خلال الثورة والموقف الحقيقي للإدارة الأميركية وسلوكها الفعلي، ولعل هذا هو العامل الذي حكم جميع العناصر الأخرى في معادلة الواقع الراهن للثورة السورية.
خامسًا: كلمة أخيرة
سورية اليوم على مفترق طرق، ولا أحد يستطيع التكهن بالمستقبل الذي ينتظرها، فالبلد مفتوحة على مصراعيها لتدخلات عديدة، ومعارضتها لا تزال ممزقة وضعيفة ولم تستطع حتى الآن تقديم البديل المناسب، وثمة أزمة إنسانية كبيرة، ملايين المشردين داخل وخارج البلد، وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى على يد النظام وجيشه وأجهزته الأمنية و«دفاعه الوطني» وشبيحته، إضافة إلى المجموعات والجماعات التي استجلبها من الخارج (حزب الله والميليشيات العراقية)، فضلاً عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمختفين، وتدمير العديد من المدن والقرى، إضافةً إلى دخول جماعات متطرفة (كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة) على الخط من كل حدب وصوب، تنتحل خطابًا طائفيًا، وتمارس بدورها القتل والتعذيب وفرض معتقداتها على الآخرين.
وفي الوقت ذاته لا يزال النظام مصرًا على البقاء، وعلى نهجه العسكري – الأمني، فيما المجتمع الدولي يبدو غير مستعجل لإيجاد حلول حقيقية لما أصبح يسمى اليوم «الأزمة السورية»، إذ كان هاجسه الأساس بعد نهاية مؤتمر جنيف في شباط/فبراير 2014 عدم السماح للوضع السوري بالانتقال إلى البلدان المجاورة أو التأثير على أوروبا والولايات المتحدة.
ولا تزال فرص الحل السياسي غير متوافرة. فهذا الحل في ظل وجود نظام حكمٍ تعامل مع بلده وشعبه كمحتلٍ، غير ممكن دون وجود توازن في القوى بين الأطراف، وهو الذي يعني توصل الأطراف إلى الاعتراف بأن توازن قواها يمنع أي حسمٍ لأي طرفٍ من جهة، وأن استمرار الوضع فيه خسارة للجميع من جهةٍ أخرى. وغير ذلك فإن الحل السياسي هو مجرد مناظرات فكرية وحقوقية بالنسبة إلى النظام السوري، الذي لا يزال مقتنعًا بقدرته على الحسم بسبب رجحان ميزان القوى لمصلحته.
أما مفهوم توازن القوى فإنه يشمل جميع الحيزات والمستويات في الحالة السورية الراهنة، ولا يقتصر فحسب على الجانب العسكري. إنه يشمل جميع عناصر القوة: الإعلام، الخطاب السياسي الوطني، التنظيم، الخبرة التفاوضية، الرصيد الشعبي، والمصالح الإقليمية والدولية التي تكاد تكون العامل الحاسم اليوم بعد أن أصبحت الحالة السورية عرضة لجميع أنواع التدخل.
لا تزال المعارضة العسكرية غير مؤهلة للحسم، أو تحقيق توازن في القوى مع النظام، وهذا ناجم عن أسباب عديدة، أولها: تقطيع النظام أوصال سورية بما يجعل من الصعوبة حدوث تواصل حقيقي بين السوريين، الأمر الذي يجعلنا نقف بشكل دائم أمام اصطفافات وتحالفات جديدة، وثانيها: الدعم الإقليمي عسكريًا وماليًا للنظام من جانب إيران وحزب الله والميليشيات العراقية، والعمل الاستخباري للنظام السوري وإيران في تشتيت القوى العسكرية المعارضة، وثالثها: وجود عدة مصادر للدعم العسكري والمالي لهذه القوى المعارضة من دول إقليمية، وهو ما يجعلها رهينة توافقات أو خلافات هذه الدول، ورابعها: طبيعة القوى العسكرية المعارضة وممارساتها وتوجهاتها الدينية، الأمر الذي جعلها تفقد الحاضنة الشعبية تدريجًا من جهة، وزيادة تردد المجتمع الدولي في دعمها، وخامسها: عدم وجود قرار أميركي واضح وجاد في دعم المعارضة العسكرية، انسجامًا مع المصلحة الأميركية في استمرار الوضع الراهن في سورية، وسادسها: عدم وجود مظلة سياسية واحدة معترف بها من جانب هذه القوى العسكرية، بحيث تكون الأولوية للسياسة ولما تقرره، وليس للعسكر وإنجازاتهم وما بأيديهم من عناصر قوة.
جميع العناصر السابقة تجعل من المستحيل أن تحقق القوى العسكرية المقاتلة نصرًا عسكريًا على النظام أو توازنًا في القوى لمصلحتها. وفي ظل الحالة الراهنة، واستمرار عناصرها المحدِّدة لها، فإن حصيلة المعارك العسكرية ستكون صفرية، بمعنى أن ما يحدث على أرض الواقع هو كسب معارك صغيرة هنا وهناك سواء من جانب القوى العسكرية المعارضة أو من جانب النظام، وهذه الحالة يمكن أن تطول ولا يربح فيها أحد، وسيكون عنوانها هو المزيد من القتل والكوارث والتفسخ المجتمعي ودمار المدن والبنى التحتية.
هناك ضريبة أكيدة ستدفعها الثورة السورية، ويمكن فهمها واقعيًا وتاريخيًا، خصوصًا بعدما ظهر أن النظام غير مستعد أبدًا لتغيير نهجه في التعامل مع الوضع الداخلي والاحتجاجات. إذ من الطبيعي أن يكون هناك فوضى، وأن يظهر على السطح العفن المتراكم طوال نصف قرن من الحكم الاستبدادي، وأن يحدث تطرف وتشدد ديني في توجهات بعض السوريين، وتصعد إلى السطح ظواهر طائفية عند البعض الآخر، وهذا كله يندرج في إطار فاتورة طويلة سيدفعها السوريون بحكم حالة العطالة المزمنة في ظل الاستبداد، على الرغم من أن المجتمع الدولي، وكذلك المعارضة السورية، كان بإمكانهما تخفيف تلك الفاتورة.
وعلى الرغم من الحالة البائسة اليوم، إلا أنه يمكن القول إن سورية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل آذار/مارس 2011، ولعل أهم فضيلة للثورة أنها أعادت الروح إلى الشعب السوري الذي بدأ معها باسترجاع وعيه وإرادته وثقته بنفسه بعد زمن طويل على رزوحه في ساحة الصمت والتهميش. فالسوريون اليوم يتحدثون في السياسة، وعلى الرغم من فوضى الحوار الحاصل إلا أنه يمكن له أن يثمر في المآل تطورًا سياسيًا، وتلك مهمة النخب الفكرية والسياسية.
كما أن تغيرًا كبيرًا حدث في رؤية السوريين إلى قضايا تعاملوا معها في السابق بشكل بدهي، إذ ظهرت هشاشة البناء الذي أنجزه النظام طوال نصف قرن، وسقطت مقولاته في «الممانعة» و«المقاومة» بالطريقة التي نادى بها ومارسها، وأصبحت هناك حاجة كبيرة إلى إعادة تموضع سورية المستقبلية في العلاقات الإقليمية والدولية، في حال ظلت موحدة وانكسرت دعوات وأفعال التقسيم التي يهمس بها بعضهم اليوم في الداخل والخارج. كما أعادت الثورة طرح القضايا الفكرية الإشكالية كافة، كالعروبة والإسلام، وهوية الدولة، والعلاقة بين الدين والدولة، وإشكالية الداخل والخارج، والعلاقة بين القوميات، وقضايا الأقليات القومية والدينية، وإشكالية العلاقة بين العرب والغرب…إلخ، وهي الإشكاليات التي واجهت المنطقة برمتها ولم تجد بعد حلاً مقبولاً لها طوال مئة عام. فنحن أمام ثورة لم تنتصر بعد، وأمام أزمة لا يلوح في الأفق حلٌّ لها، لكنهما معًا – أي الثورة والأزمة – قامتا بنبش كل شيء، على مستوى الفكر والسياسة الداخلية والمجتمع والاقتصاد والعلاقات الإقليمية والدولية.

تحميل البحث
⇓
مراجع المقدمة
باروت، محمد جمال. العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012.
بشارة، عزمي. سورية: درب الآلام نحو الحرية (محاولة في التاريخ الراهن). بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013.
_____ «العرب وإيران ملاحظات عامة». في: عزمي بشارة ومحجوب الزويري (محرران). العرب وإيران: مراجعة في التاريخ والسياسة (بيروت؛ الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012).
بيرتس، فولكر. الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم حافظ الأسد. ترجمة عبد الكريم محفوض وحازم نهار. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2012.
نهار، حازم. مسارات السلطة والمعارضة في سورية: نقد الرؤى والممارسات (2000-2008). القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2009.
_____ لؤي الصافي. المعارضة السورية. تونس: الدار المتوسطية للنشر، 2013.
هايدمان، ستيفن. التسلطية في سورية: صراع المجتمع والدولة. ترجمة عباس عباس. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2011.
هينبوش، رايموند. سورية: ثورة من فوق. ترجمة حازم نهار. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2011.
وادين، ليزا. السيطرة الغامضة: السياسة والخطاب والرموز في سورية المعاصرة. ترجمة نجيب الغضبان. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2010.
ويلاند، كاريستين. سورية: الاقتراع أم الرصاص (الديمقراطية والإسلامية والعلمانية في المشرق). ترجمة حازم نهار. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2011.
[1] انظر مقدمة محرر هذا الكتاب (كشف الغموض عن سورية): فريد اتش لاوسن Fred H. Lawson.
[2] فولكر بيرتس، الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم حافظ الأسد، ترجمة عبد الكريم محفوض وحازم نهار (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2012)، ص 249 -250.
[3] ليزا وادين، السيطرة الغامضة: السياسة والخطاب والرموز في سورية المعاصرة، ترجمة نجيب الغضبان (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2010)، ص 45.
[4] ستيفن هايدمان، التسلطية في سورية: صراع المجتمع والدولة، ترجمة عباس عباس (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2011)، ص 14.
[5] المصدر نفسه، ص 14.
[6] كاريستين ويلاند، سورية: الاقتراع أم الرصاص (الديمقراطية والإسلامية والعلمانية في المشرق)، ترجمة حازم نهار (بيروت: رياض الريس للكتب والنش، 2011)، ص 53.
[7] رايموند هينبوش، سورية: ثورة من فوق، ترجمة حازم نهار (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 2011)، ص 31.
[8] ويلاند، المصدر نفسه، ص 87.
[9] المصدر نفسه، ص 87.
[10] انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب.
[11] انظر الفصل الأول من هذا الكتاب.
[12] ويلاند، المصدر نفسه، ص 93.
[13] انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.
[14] بيرتس، الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم حافظ الأسد، ص 410.
[15] انظر الفصل الأول من هذا الكتاب.
[16] انظر الفصل الأول من هذا الكتاب.
[17] محمد جمال باروت، العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012)، ص 87.
[18] المصدر نفسه، ص 95.
[19] انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب.
[20] في إطار هذه الاتفاقية، تُمنح الصادرات السورية من السلع الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي إعفاء من الرسوم الجمركية على أساس غير متبادل. وعلى الأغلب، ومنذ السبعينيات، كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس لسورية. وفي ذروتها، شكلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من ثلثي الصادرات السورية إلى العالم، بينما شكلت الواردات من الاتحاد الأوروبي بين 30 إلى 40 في المئة من إجمالي واردات سورية. راجع الفصل الثامن من هذا الكتاب.
[21] تنتمي سورية إلى دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط التي أطلقت، إلى جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي، مبادرة الشراكة الأوروبية المتوسطية (EMP) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1995، والتي تُعرف أيضًا باسم عملية برشلونة. وسورية هي الدولة الأخيرة من الدول المتوسطية الشريكة (MPCs) التي لم تبرم بعد الشراكة الكاملة أو اتفاقية الشراكة (AA) مع الاتحاد الأوروبي. راجع الفصل الثامن من هذا الكتاب.
[22] على الرغم من مشاركة رئيس النظام في الإطلاق الرسمي للاتحاد من أجل المتوسط (UMed) في تموز/يوليو 2008 في باريس، بعد ذوبان جليد العلاقات السورية الفرنسية، وعودة توقيع اتفاقية الشراكة ليكون على الأجندة، إلا أن النظام لم يتقدم أي خطوات جدية على صعيد الإصلاح في الداخل.
[23] انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب.
[24] باروت، العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح، ص 136.
[25] ويلاند، سورية: الاقتراع أم الرصاص (الديمقراطية والإسلامية والعلمانية في المشرق)،
ص 135.
[26] المصدر نفسه، ص 135.
[27] باروت، المصدر نفسه، ص 95.
[28] المصدر نفسه، ص 96.
[29] المصدر نفسه، ص 96.
[30] المصدر نفسه، ص 107.
[31] انظر الفصل السابع من هذا الكتاب.
[32] انظر الفصل السادس من هذا الكتاب.
[33] انظر الفصل السادس من هذا الكتاب.
[34] ويلاند، سورية: الاقتراع أم الرصاص (الديمقراطية والإسلامية والعلمانية في المشرق)،
ص 122.
[35] انظر الفصل السابع من هذا الكتاب.
[36] عزمي بشارة، سورية: درب الآلام نحو الحرية (محاولة في التاريخ الراهن) (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013)، ص 23.
[37] المصدر نفسه، ص 31.
[38] المصدر نفسه، ص 32.
[39] «المجلس الوطني الكردي يتخلى مرحليًا عن حق تقرير المصير،» موقع أخبار الشرق، 25 نيسان
/أبريل 2012، <http://www.levantnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11689:-qq-q-q-q-q-&catid=66:syria-politics&Itemid=118>.
[40] «كلينتون: كيان جديد للمعارضة السورية يتجاوز المجلس الوطني.. وتريد أسماء محددة!،» موقع أخبار الشرق، على الرابط: <http://www.levantnews.com/archives/19406>.
[41] حازم نهار ولؤي الصافي، المعارضة السورية (تونس: الدار المتوسطية للنشر، 2013)،
ص 114.
[42] المصدر نفسه، ص 139.
[43] للاطلاع على تلك المعايير، انظر: المصدر نفسه، ص 144-149.
[44] حازم نهار، مسارات السلطة والمعارضة في سورية: نقد الرؤى والممارسات (2000-2008) (القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2009)، ص 96.
[45] المصدر نفسه، ص 93.
[46] المصدر نفسه، ص 94.
[47] المصدر نفسه، ص 91.
[48] انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب.
[49] انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب.
[50] بشارة، سورية: درب الآلام نحو الحرية (محاولة في التاريخ الراهن)، ص 495.
[51] المصدر نفسه، ص 495-511.
[52] محمد نور الدين، «استطلاع رأي: أغلبية الأتراك يرفضون تدخلاً عسكريًا في سورية»، السفير، 14/9/2012.
[53] يوسف الجمهاني، العلويون في تركيا (بيروت: دار الكنوز الأدبية، 2003)، ص 75. المرجع مذكور في: بشارة، سورية: درب الآلام نحو الحرية (محاولة في التاريخ الراهن)، ص 504.
[54] انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب.
[55] انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب.
[56] بشارة، المصدر نفسه، ص 519.
[57] برهان غليون، «في معنى أن تكون سورية محافظة إيرانية،» الجزيرة نت، 24 شباط/فبراير 2013، على الرابط: <http://www.aljazeera.net/home/print/7dcab3c3-3422-4c8b-b091-049383f5dada/2020288b-8598-41e5-b8fe-2fa1ddce72c7>.
[58] «الجيش الإيراني: موقفنا من الأوضاع التي تمر بها سورية «دفاعي» فقط وسندافع عنها بكل وجودنا،» موقع سيريا نيوز، 8 آذار/مارس 2013: <http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=157562>.
[59] عزمي بشارة، «العرب وإيران ملاحظات عامة،» في: عزمي بشارة ومحجوب الزويري، محرران، العرب وإيران: مراجعة في التاريخ والسياسة (بيروت؛ الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012)، ص 10-11.
[60] «إيران تقترح ضم أزمتي سورية والبحرين إلى المفاوضات النووية مع الـ 5+1،» موقع دي برس، 13 شباط/فبراير 2013: <http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=140029>.
[61] انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب.
[62] بشارة، سورية: درب الآلام نحو الحرية (محاولة في التاريخ الراهن)، ص 474-480.