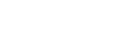*ميثاق: المصدر- تلفزيون سوريا | حسان الأسود
لم تتفاجأ الغالبية العظمى من السوريين بإطلالة بشار الأسد المسرحية في أحياء حلب المدمّرة، فالأمر بات معروفًا حتى لدى أنصاره ومؤيديه، وليس فقط في أوساط معارضيه والثائرين عليه، إنّه مريضٌ نفسيّ يشعرُ بالدونيّة واحتقار الذات، لذلك تراه يبالغ في إظهار الحكمة والعظمة والثقة بالنفس، كما تراه يحاول جاهدًا إحاطة نفسه بالمطبّلين والمزمّرين ليقنع ذاته المهزوزة بالتفوّق والسيادة. لا يدخل أيضًا في باب الشتيمة وصفه بما يستحق من ألفاظٍ عندما خرج ضاحكًا على أنقاض البيوت التي دمرها جيشه من قبل، أو عندما استعرض فوق الجثث المطمورة تحت الأنقاض تأييد محبيه وشبّيحته، ممن جمعهم له حرسُه بعناية فائقة وفحصٍ أمني صارم، والذين لم يكن أكبر همّهم سوى التقاط الصور معه، فهذا أبعد من الشتيمة، إنّه حكمُ قيمة أخلاقيّ على تصرّفِ شخصٍ تجرّد من كل خُلقٍ ومن كل قيمةٍ ومن كلّ فضيلة، بل تجرّد من كل النوازع الإنسانية.
في مقارنةٍ بين إطلالة الرئيس التركي أردوغان عند زيارته بعض المناطق المنكوبة، أو في مواساة الرئيس الفرنسي لهدّاف منتخبه الوطني لكرة القدم، كيليان مبابي، عندما خسر نهائي كأس العالم في الدوحة قبل أقل من شهرين، أو في إطلالات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أمام عدسات الكاميرات أو أمام مواطنيه وجنوده، وهؤلاء جميعًا يعتصرهم الألم والحزن، ويظهرون أكبر قدرٍ من المواساة والإحساس بالمسؤولية، ويحاولون التبسّط أمام أحزان مواطنيهم، بسلوك بشار الأسد خلال سنوات الحرب التي شنها على الشعب وخلال كارثة الزلزال، فإنّ المرء لا يجد سوى حالةِ نشوةٍ وحبورٍ تخفي شماتةً وحقدًا لا مثيل لهما في التاريخ. لم يمرّ على البشرية من يستمتع بتدمير مدن البلد التي يحكمها أبدًا، وحتى تلك الشائعات المتداولة عن قيام نيرون بحرق روما هي محض افتراء. قد يكون الوحيد الذي يشبه الأسد في بعض جوانب سلوكه هو القائد النازي هتلر، الذي أمر بحرق بيوت اليهود ومتاجرهم ثم أمر بتصفيتهم وحرقهم في أفران الغاز الشهيرة، ورغم ذلك لم يكن يظهر مبتسمًا أبدًا، فحتى هذا المجرم كان لديه بعض التقدير والاحترام لجلالة الموت ورهبته.

ثمّة حلقة مفقودة في مأساة السوريين المقيمة منذ عقدٍ ونيّف، إنها حلقة التضامن الإنساني، وهذه الحلقة أكثر ما يفتقدها المرء عند الأشقاء العرب، فلم يصادف أن خرج المواطنون في أيّ دولة عربية للتظاهر تضامنًا مع أشقائهم السوريين، ولم يعتصم حتى الناشطون منهم أمام سفارات نظام الأسد أو روسيا أو إيران احتجاجًا على استخدام العنف المفرط الذي وصل حدّ استخدام الأسلحة الكيماوية عشرات المرّات ضدّ المدنيين. في البحث عن هذه الحلقة المفقودة يجد المرء قصورًا واضحًا في الفهم، وعجزًا كبيرًا عن إيجاد الحقيقة، واستسلامًا رخيصًا لترّهات بروباغاندا حلف المقاومة والممانعة للإمبريالية والصهيونية. ثمّة عماء سياسي عند الأحزاب القومية العربية، وثمّة استرخاصٌ للدم السوري عند النخب العربية التي تدّعي الثقافة والانحياز لقضايا الأمّة، ثمة تخاذلٌ وتخلٍّ عن أبسط واجبات هذه النخب تجاه الشعوب، فلم تكلّف نفسها عناء الغوص في بنية نظام الحكم الديكتاتوري الطائفي القائم في سوريا لتكشفه وتعرّيه، بل اكتفت بشعارات خُلّبية زائفة لتواري سوأتها أمام ذاتها وأمام الجمهور الذي يأخذ عنها.
لا تعويل بطبيعة الحال على مواقف أنظمة الحكم، فهذه كانت تخشى انتصار النموذج الشعبي الثوري في التغيير السياسي والمجتمعي، أي كسر حلقة الاستبداد بإرادةٍ جمعيةٍ من خارج الحلقات المسيطرة على السلطة، أو بتعبيرٍ آخر باستخدام أدواتٍ غير الانقلابات التي كانت تغيّر الوجوه دون مساسٍ بالجوهر. وجزءٌ منها، أي الأنظمة، سواءٌ تلك التي دعمت ثورات شعوب الربيع العربي أو التي وقفت ضدّها، كانت لها مصالح خاصّة دفعتها للانحياز للحكام أو للمحكومين الثائرين. فحتى تلك التي وقفت مع الشعوب الثائرة لم تستطع أن تفهم جوهر ثوراتها حقًّا، فاستخدمت إمكانياتها لدعم تياراتٍ أو أحزابًا من ميلٍ عقديٍّ معين يتناسب وهواها، فلم تستطع أن تدرك طبيعة هذه الثورات التي سعى أهلها لامتلاك فضائهم العمومي، من خلال تأميم السياسة وتأميم بلادهم التي خصخصتها أنظمة الحكم وحوّلتها مزارع لفئات محدودة من المستفيدين، وحمت سلطتها بالحديد والنار.
فاقم هذا كلّه حالةً الاستقطاب الداخلي في المجتمع السوري، فلم يكن السوريون بأي يومٍ من الأيام موحدين خلف هُويّةٍ تجمعهم، أو مؤمنين بأمّة واحدة ينتمون إليها، ولم تسنح لهم مئة عامٍ ونيّفٍ من الاستقلال عن فكرة التبعيّة للإمبراطورية العثمانية بخلق كيانٍ رمزي يجمعهم. لقد عجز السوريون عن بناء الدولة الحديثة التي هي الوعاء الأوّل لتشكيل الأمّة، فجزءٌ منهم ما زال يحنّ لفكرة الخلافة، ويعتقدُ بأنّه لا قيامة للسوريين إلا من خلال أمّة إسلامية كبيرة جامعة. وجزءٌ آخر منهم لا يزال مؤمنًا بالقوميّة العربية بتعريفها الإيديولوجي، وينظر للأمّة السورية على أنها تقسيم للأمّة الكبرى المنشودة. وهذا كلّه جعل من الطبيعي أن تتفتح التطلّعات القوميّة عند الأكراد السوريين، وربّما يلحقهم في ذلك التركمان السوريين وغيرهم أيضًا. أمّا الطامّة الكبرى فكانت في الانشقاق الطائفي الذي تعزز مع سلوك النظام هذا النهج للحفاظ على سلطته، فاستقدام العون من إيران والتعويل كثيرًا على حزب الله، بكل ما حمله هذا من حمولات طائفية لم يُخفِ أصحابها مضامينها، جعل الحال السوريّة بركانًا دائم الثوران وإن خمد برهة هنا وهنيهة هناك.
بدأت مأساةُ السوريين منذ مئة عامٍ بتحطيم حلمهم ببناء الأمّة السورية على يد الفرنسيين، هؤلاء هم الذين حطموا سوريا الكبرى، وهدموا معها حلمًا راود أهلها ردحًا من الزمن. ثم تتالت فصول الكارثة مع فشل الديمقراطية بالنموّ في أجواءٍ محمومةٍ من انقلابات العسكر، وتأكّدت مع استيلاء حافظ الأسد على السلطة بشكل نهائي، حيث استطاع قضم الدولة ودمجها بالنظام ثم بشخصه. وأتت حرب وريثه لتهدم ما تبقى من أسس المجتمع الأهلي الذي حاول النجاة من قبضة السلطة، فكان الدمارُ بالبنى المجتمعية أخطر من دمار المدن بكثير. وما نراه الآن من رقصٍ على جثث السوريين العالقين تحت أنقاض ما دمّره الزلزال، ليس أكثر من فصلٍ جديد من فصول المأساة المتجددة المتكررة، ولن تنكسر حلقاتها الصلبة إلا بالتغيير السياسي، وهذا ما يبدو حتى الآن صعب المنال لعدم توفر شروط تحققه، وتبقى مأساة السوريين وتتمدّد، بينما يمرح الأسد بملهاته السوداء ويتجدد.