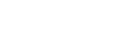*ميثاق: مقالات وآراء
المصدر” تلفزيون سوريا” مالك داغستاني
قبل أيام قليلة، تصادف لي أن اطلعت، عبر صديق، على “مجموعة خاصة” في وسائل التواصل لأفراد إسرائيليين. فتاة في تلك المجموعة، سألتْ أصدقاءها، كيف عليها أن تتصرف وهي عائدة من إسرائيل إلى برلين، حيث تقوم بتدريس مادة التطوير الصوتي في إحدى الأكاديميات، ولديها في الصف طالبة عربية! كانت تخشى إن كانت تلك الطالبة تعرف أنها قادمة من إسرائيل، وتتساءل أو تطلب النصيحة، هل عليها أن تسأل المدير الوجود معها في الصف عند وصولها بسبب أن لديها خوفا وجوديا من تلك الطالبة، حسب تعبيرها حرفياً. أخيراً تقترح على النساء الإسرائيليات الموجودات في برلين أن يلتقين على تطبيق “زوم” لتبادل الخبرات حول مخاوفهن من العرب.
صيف عام 2011، شاهدت بنفسي، في مدينتي حمص، عشرات الشبّان يحملون العصي الغليظة، وما تيسّر لهم من أدوات، ويقفون على مدخل “شارع الحضارة”، بهدف حماية أحيائهم، بعد أن سرت شائعة تفيد بأن أهالي حي بابا عمرو سوف يهاجمون أحياء العلويين. انتظر هؤلاء الشبان المستنفرون حتى المساء، دون أن يساورهم الشك بأن العدوان حاصل لا محالة. انتظروا عدواً لم يأتِ ولن يأتي. تكرر الأمر بعدها كثيراً، وفي كل مرة كانت تلك الاستنفارات تحصل عقب تحذيرٍ، مصدره أمني كما سيعلم الجميع فيما بعد، يقول إن “الإرهابيين” قادمون لقتلكم واغتصاب نسائكم. وفي كل تلك المرات تصادف أن العدو المنتظر لم يحضر.
لا أعرف بالطبع كيف سارت الأمور مع الفتاة الإسرائيلية فيما بعد، ولكني أكاد أجزم أنها دخلت الصف وأعطت درسها، وكانت الطالبة العربية كغيرها من الزملاء تصغي باهتمام، وتدوّن الملاحظات على دفترها. وأعرف أكثر، أن خوف تلك المدرّسة كان يشبه إلى حد كبير حال الشبان الذين انتظروا هجوماً من بابا عمر ولم يحدث. المثالان في الحالتين، كما يسهل الاستنتاج، كانا نتيجة تعبئة مسبقة مشغول عليها، ترسم صورة نمطية عن الآخر العدو، بل عن مجاميع بشرية من الأعداء، الذين يتحضّرون لقتلكَ في اللحظة التالية، ولا هدف لهم في الحياة سوى فعل ذلك.

يحتاج أي نظام إباديّ إلى دبِّ الرعب في قلوب وعقول من يعتبرهم مجموعته البشرية، غالباً رعبٌ محمول على سوابق تاريخية حدثت خلال اعتداءات فعلية. رعبٌ سيساعد في تشكيل منظومة من أفرادٍ يهجسون بالدفاع عن وجودهم، فيتحول جزء منهم إلى قتلة مرتاحي الضمير، بحسب تركيبةٍ نفسية نمت معهم منذ النشأة الأولى، ويستسيغ البقية، ممن لن يشاركوا مباشرة بالإبادة، قتلَ المختلفين الدفاعي حسب قناعتهم باعتباره يهدف للحفاظ على الوجود. قلائل هم من ينجون، فينأون بأنفسهم عن الوقوع في هذا الفخّ المريع إنسانياً.
من تابع حسابات الموالين لنظام الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ عام 2011، بدايات الثورة السورية، لا بدّ لاحظَ كمية الخوف التي كانت تنِزُّ من تعابيرهم. بدا الأمر وكأنه ينطوي على خوف أصيل من الآخر المختلف طائفياً. الآخر الذي ينتظر اللحظة المؤاتية لينقض عليهم ويقتلهم، بل ويبيدهم عن آخرهم. من هنا تماماً تبدأ الحرب المزعومة للدفاع عن النفس، التي تبيح انتهاك أية أعراف ومعايير. تبيح القتل والتدمير، بل وتذهب بتلك المجموعات البشرية لأن تطلب المزيد منه، باعتباره غير كافٍ للحفاظ على الوجود المهدَّد.
*مواد ذات صلة:
شاب إسرائيلي يعرض قضيته، فيخبر الأصدقاء أنه قادم إلى ألمانيا قريباً، ويتساءل هل هناك مشكلة مع السائقين الأجانب (طبعاً يقصد العرب أو المسلمين) على تطبيق “أوبر”؟. “هل من الأفضل أخذ سائق أعرفه شخصياً حتى أشعر بالأمان؟”. سيدة إسرائيلية لديها مشكلة أكثر هولاً: “أعيش في إسرائيل، ومن المفترض أن أصل إلى برلين نهاية شهر نوفمبر، لحضور حفلة مادونا. إنني مرتبكة للغاية بسبب تحذيرات السفر إلى جميع أنحاء العالم، المنشورة في إسرائيل. لدي جواز سفر بولندي. بافتراض أنني بالطبع لن أسير في الشارع والعلم الإسرائيلي على ظهري ولن أتحدث العبرية. ما مدى خطورة التجول هناك؟ خصوصاً أن معي أطفالا لا أريد تركهم في البلاد خلال الأوضاع الحالية”.
وددتُ لو أني استطعت التعليق على ما جاء في منشور تلك السيدة، بل ورغبت أكثر لو استطعت الإجابة على الشاب الإسرائيلي بورا شاماي الذي تساءل “كيف سمحت أوروبا لهذا العدد الكبير من البدائيين الهمج من العالم الثالث بتدميرها من الداخل؟”. في سوريا أيضاً كان هناك من يتحدث عن مواطنين متحضرين مرعوبين، يوالون الأسد ويؤيدون قصفه بالبراميل والكيماوي للهمج المتخلفين في غوطة دمشق وإدلب وعشرات المناطق الأخرى. مع مرور السنوات اكتشف مئات الآلاف من هؤلاء، في فترات متفاوتة، أن الأسد كان يتاجر برعبهم ويغذّيه، فعادوا إلى حياتهم الفقيرة، لتأمين حياة الكفاف لأسرهم. لكن بالتأكيد كان من ضمن هؤلاء من سيُعرَفون تحت مسمى “الشبيحة” الذين اشتركوا مع الأسد، كلٌّ من موقعه، في كامل جريمة الإبادة.
ربطاً بما سبق، فإن ما يحدث في غزّة اليوم يؤكد أن منظومة الرعب المشغولة بإتقان هي التي تحرك المجتمع الإسرائيلي لتجعله، بأغلبيته، موافقاً على الإبادة التي تطحن القطاع في كل لحظة. وحتى لا أقفز من فوق الوقائع، فإنَّ حَدَثَ السابع من أكتوبر، وقتل حماس لعشرات الإسرائيليين، وأخذ الكثيرين منهم رهائن، ليس المحرك الأساسي لهذا الرعب. هو ساهم فقط في زيادة حدّته، لأنه رعب مشغولٌ عليه تاريخياً، وما كان من حماس، بفعلتها المغامِرة تلك، إلا أن دفعت به إلى الواجهة، وعلى الفور استلمت الحكومة المتطرفة في تل أبيب الدفَّة لتغذيته.
البيئة الاستعصائية التي يولّدها الظلم، هي المكان الأمثل لولادة التطرف المقابل. ما يستتبع أن الطرف الآخر يقدّم، عبر ممارساته المتطرفة، مادةً مثالية لتغذية الرعب المحلي والعالمي. حدث هذا في سوريا عبر الجهاديين الذين تقاطروا إليها من كل أطراف الأرض، ومارسوا كل ما ساهم بوسم الثورة السورية في الإعلام الدولي، بأنها ثورة متطرفين، ليتم إجهاض كل تضحيات السوريين، ولتصبح المقارنة بين نظام إجرامي وجماعات جهادية راديكالية. اليوم يشتغل الإعلام الدولي على ذات المنوال، للمقارنة بين إسرائيل وحماس، فيصف الأخيرة على أنها داعش، ويشبِّه ما حدث في غلاف غزّة بعملية الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، متجاهلاً إلى حدٍّ كبير عدالة القضية الفلسطينية.
استذكار بعض القادة الإسرائيليين اليوم لجرائم الأسد ليس أمراً نافلاً، حين يقولون إنهم لم يفعلوا أكثر مما فعله الأسد بالسوريين. وهذا يدلل أكثر على التشابه في آلية تضخيم الرعب واللعب عليه، الذي يؤدي إلى ذات النتائج من استسهال القتل والتدمير، بما فيه تفجير المدارس والمستشفيات وقتل الأطفال والنساء، كما استمر في الحدوث في سوريا خلال أكثر من عقد، وكما يحدث في قطاع غزّة منذ أكثر من شهر.
يبدو لي، أن التواطؤ البشري مع الجريمة يرافقه، بالعمق وربما باللاشعور لدى صاحبه، الإحساس بأنه قد حصل على ما ليس من حقه. دولةٌ عل حساب حرمان السكان الأصليين من دولتهم وأراضيهم وبيوتهم في حالة إسرائيل. واحتكار السلطة ومنافعها، ولو كانت فتاتاً، في حالة السوريين الموالين. يعرف كل إسرائيلي أن أصحاب الأرض الأصليين يتوازعون مشارق الأرض ومغاربها، لاجئين بعد أن شردهم الاحتلال. كما يعرف الموالون السوريون لنظام الأسد الإباديّ أن ملايين السوريين قد هُجِّروا قسراً من بلادهم، بعد قتل مئات الآلاف منهم، وأكثر من ذلك يعلم الطرفان، أن أصحاب الحق، لا المتطرفين، هم المرعبون ولا بدَّ من إبادتهم.