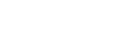*ميثاق: مقالات وآراء
ترجمة الميثاق: المصدر”New Lines Magazine”
«لطالما حولت مؤسسة النخبة في سانت بطرسبرغ طلابها إلى خدم للوطن الأم في الخارج، مع عواقب مدمرة بشكل متزايد»
منذ حوالي عقد من الزمان، دعاني ممثل روسي لمناقشة فكرته عن فيلم إثارة تدور أحداثه في سوريا. كان بطل الفيلم، وهو جاسوس روسي، في مأزق بين محاربة تنظيم الدولة (داعش) والحنين إلى عائلته في موسكو. كان بحاجة إلى كاتب، وحصلت على الوظيفة على الفور. لكن هذا لم يكن بسبب خبرتي في كتابة سيناريوهات البرامج التلفزيونية الروسية، التي كان لدي الكثير منها، ولكن لأنني تخرجت من جامعة روسية تشتهر بخبرتها في الشرق الأوسط. حقيقة أنني تمكنت من التوصل إلى حوار وشخصيات ذات صلة إلى حد ما كانت مجرد تتويج.
على عكس عدوها اللدود في واشنطن، تفتخر روسيا منذ فترة طويلة بفهم “المنطقة”، وهو مصطلح الشرق الأوسط الذي استخدمه أعضاء هيئة التدريس في جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، والتي كانت تتكون في الغالب من جواسيس متقاعدين ودبلوماسيين وأساتذة في الثمانينيات من العمر.. لقد جاءوا من وقت كانت فيه بلادهم، بالإضافة إلى الأسلحة، تصدر الأيديولوجية لمواجهة الهيمنة الغربية والممالك الإقليمية.
بالنسبة لجامعتي المرموقة، كانت نهاية سلالة الأسد والمشروع الروسي في سوريا أمراً شخصياً. وبحلول الوقت الذي فرّ فيه بشار الأسد إلى روسيا في أواخر العام الماضي، كنت قد تركت الدراسة منذ فترة طويلة. ولكن علامات سيطرة روسيا المفترضة على الشرق الأوسط بدأت تظهر بحلول الوقت الذي كنت فيه طالباً في السنة الأولى في عام 2002. قبل عامين، وصل إلى السلطة شخصان كانا مسؤولين عن الدمار الشامل لسوريا، الأسد، وفلاديمير بوتين، الذي تخرج من الجامعة في عام 1975.

غالباً ما أكدت الدراسات على التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط. قيل لنا إن المنطقة كانت أشبه بعقدة غوردية، ولكن على عكس الأميركيين الفظين الذين أرادوا قطعها، كنا نحن الروس بحاجة إلى فكها.
تم وضع برنامج تبادل قوي مع العديد من المؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وكان للجامعة عملية مبسطة لتحويل ألمع طلابها إلى أعضاء في الأكاديمية الروسية للعلوم ومديري المتاحف والمؤرخين المشهورين عالمياً.
ولكن سرعان ما أصبح من الواضح أن الجامعة لم يتم إنشاؤها لتعزيز المناقشات حول مستقبل الشرق الأوسط. لم يختر الرئيس الروسي رؤساء الجامعات لتربية المفكرين الأحرار، ولم يكن هناك أحد لطرح أفكار جديدة. السبب في أن كل تكرار للتاريخ الروسي – الإمبريالي والسوفياتي و “الديمقراطي” – أبقى الجامعة تعمل مثل مؤسسة “Ivy League-رابطة اللبلاب“، على الرغم من الفوضى الدائمة في البلاد، يتم تلخيصه بشكل أفضل في عنوان معرض افتتح في أكتوبر الماضي في البرلمان الروسي، بعنوان “جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية: 300 عام من الخدمة للوطن الأم.” أنتجت الجامعة الأشخاص الذين شكلوا جوهر الدولة الروسية المصابة بجنون العظمة والقمعية والمهووسة بالأمن. دخلنا الجامعة بأفكار رومانسية عن الشرق الأوسط، وأخذنا عدد لا يحصى من المخطوطات والأعمال الفنية التي تمكنت روسيا قبل الثورة من انتزاع بلاد فارس وبلاد الشام. بحلول الوقت الذي غادرنا فيه، تحول معظمنا إلى خدم مخلصين للدولة. قام النظام بتحويل المواهب إلى أدوار تخدم الكرملين، تاركاً مجالاً صغيراً للاختيار الشخصي أو المعارضة.
*مواد ذات صلة:
تأسست جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية منذ 300 عام من قبل القيصر بطرس الأكبر. ويعد خريجوها مهداً حقيقياً للنخب في البلاد، ومن بين خريجيها فلاديمير لينين وآين راند والملحن إيغور سترافينسكي، إلى جانب ثمانية من الحائزين على جائزة نوبل وعدد قليل من رؤساء الدول. جنباً إلى جنب مع نظيرتها في العاصمة، جامعة موسكو الحكومية، تم إدراج المدرسة كبند منفصل في الميزانية الفيدرالية الروسية، على غرار صادرات الأسلحة أو الحفاظ على الطبيعة. منذ الغزو الشامل لأوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، يعكس مجلس أمنائها قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تضم مسؤولين حكوميين وأوليغارشية مسؤولين عن مسعى الإبادة الجماعية الروسية.

- كان الالتحاق بالجامعة قراراً شخصياً: غادرت عائلتي الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة عندما كنت في المدرسة الابتدائية، وعدت للدراسة في نفس المدينة والجامعة التي كانت والدتي وجدتي فيها. في ذلك الوقت، كانت حرب العراق مستعرة، وكان التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط هو الموضوع اليومي. على الرغم من أنني التحقت بكلية التاريخ، إلا أنني التحقت بما يسمى بالكلية الشرقية – التي تسمى الآن، لحسن الحظ، كلية الدراسات الآسيوية والأفريقية – وتخرجت في عام 2007. كنت محظوظاً لتخطي “مذبحة السنة الأولى” ، عندما ترك العديد من الطلاب الدراسة تقليدياً بسبب الدرجات الضعيفة، أو عدم القدرة على تعلم اللغة المستهدفة أو بسبب تعرضهم للتنمّر من قبل أعضاء هيئة التدريس – وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة لأولئك في السنة الأولى من دراستهم. أما التنمر، عندما كنا نتعرض للتوبيخ والإهانة من قِبَل الأساتذة، فقد توقف بحلول السنة الثانية.
تضمنت الدراسات أيضاً جانباً غير رسمي – المعرفة التي لن يتم ذكرها في الكتب المدرسية. تم تصوير الأمريكيين على أنهم يتبنون نهجاً غير مستنير تجاه المنطقة. على النقيض من ذلك، كان البريطانيون يحظون بالتبجيل بسبب دراساتهم للعالم العربي وقدرتهم على العمل في المنطقة دون اللجوء إلى القصف الشامل- على الأقل في النصف الثاني من القرن العشرين. تم الإشادة بالاتحاد السوفيتي لأنه تمكن من تجنب كونه الدولة التي رسمت الحدود واستخرجت الموارد الطبيعية وتدخلت عسكرياً عندما كانت مصالحها الاقتصادية على المحك. بعبارة أخرى، لم تكن إمبراطورية استعمارية، وبالتالي تمتعت بدرجة من المودة الحقيقية في جميع أنحاء الشرق الأوسط العربي.
بالنسبة لجميع المخطوطات والنظريات، كانت المعرفة العملية للمنطقة هي التي جعلت المدرسة ممتعة للغاية. كان من المفهوم أن الكتب المدرسية السوفيتية التي استخدمناها غالباً ما عفا عليها الزمن، لذلك تم استكمال المحاضرات عن السلوقيين والأمويين والقومية العربية بنوادي شبه غير رسمية يديرها أساتذة وخريجي دراسات عليا. هناك، كنا نتعلم من الأشخاص ذوي الخبرة المباشرة في هذا المجال. تعلمنا أنه من الأفضل أن نبتسم ونلعب بغباء مع المسؤولين المحليين، مثل حرس الحدود، وأن نساوم في الشوارع، حيث كلمة “لا” هي مجرد بداية للمساومة. نصحونا بعدم إظهار عادات غير مألوفة، أو إعطاء وتلقي أي شيء بيدنا اليسرى. في سوريا، قيل لنا ألا نخاف من الأصوات المرتفعة، لأن الخلافات نادراً ما تتطور إلى معارك، ولكن في تركيا، قد تتحول الأمور إلى العنف بسرعة كبيرة.
قبل فترة طويلة من نهاية نظام الأسد، قيل لنا إن الجيش السوري ضعيف بطبيعته بسبب المحسوبية والبنية التنظيمية غير الفعّالة. كان الجيش يديره أبناء أخوة الجنرالات السوريين الذين تلقوا تدريباً سيئاً، والذين كانوا بدورهم أبناء أخوة وزراء في الحكومة، ولم يكن أي قدر من المستشارين العسكريين السوفييت ــ بعضهم من خريجي جامعتنا ــ كافياً لشن دفاع فعال ضد هجوم إسرائيلي. وكما قال أحد الأساتذة بشكل محبط: “كل ما يفعلونه هو شرب الشاي”. وينطبق نفس الشيء على جيوش مصر والجمهورية العربية المتحدة في النصف الثاني من القرن العشرين. ومن بين جميع الجيوش وجماعات حرب العصابات التي كان المستشارون العسكريون السوفييت يتواجدون فيها، كان “الفيت كونغ” فقط هو الذي يحظى باحترام واسع النطاق من قِبَل هيئة التدريس.

كانت دراسة الشرق الأوسط بمثابة حلم: فأينما ذهبت، شعرت بأنك مميز، حتى ولو لم يكن الناس الذين التقيتهم يعرفون شيئاً عن الدراسات العربية. وكان ميخائيل بيوتروفسكي، رئيس متحف الإرميتاج الشهير في سانت بطرسبرغ وخريج دفعة 1967، لديه قاعدة غير مكتوبة مفادها أن أي شخص يدرس اللغة العربية في الجامعة، كما فعل هو، يحق له أن يقابله لمدة خمس دقائق. وكانت هناك مؤتمرات علمية لا حصر لها، بعضها تحت رعاية وزارة الخارجية. وكان بعض كبار أعضاء الخدمة الخارجية في البلاد، وأحياناً وزير الخارجية نفسه، يلقي البيانات الافتتاحية. لقد فتحت المدرسة الأبواب ــ وهو ما لم تتمكن معظم الجامعات الروسية من تحقيقه على الإطلاق. ولكن إلى أين تقود تلك الأبواب كان الأمر مختلفاً.
خارج قاعاتها، قدمت المدرسة طلابها تدريجياً إلى خبراء السياسة الخارجية والمسؤولين الحكوميين – ليس من خلال الاحتكاك بهم، ولكن ببساطة من خلال التواجد في نفس الغرفة. كان لدى الجامعة دائماً نوع من وحدة التجسس في الداخل. كانت وكالة المخابرات السرية السوفيتية، تعمل إلى حد كبير مثل السفارة. بعد عودته من ألمانيا، أصبح الجاسوس المحترف بوتين مساعد رئيس الجامعة للشؤون الدولية. رسمياً، قام بتنسيق علاقات الجامعة مع المؤسسات التعليمية والبحثية الأجنبية. شكل غير رسمي، ومن المفهوم على نطاق واسع أنه عمل كممثل للمخابرات السوفيتية في الجامعة، حيث راقب أنشطتها الدولية وضمن الأمن في الارتباطات الخارجية. كانت الهيئة الطلابية، وخاصة الفنون الحرة، عبارة عن مجموعة من المجندين المحتملين: شاركت جدتي، التي كانت جزءاً من فصل 1939، في الغزو السوفيتي لفنلندا بينما لم تنجح “الكي جي بي-المخابرات الروسية” في الاتصال بوالدتي، فئة 1970، في الظهور كمرشد سياحي والتجسس على طلاب البعثات الأجنبية والسياح الفرنسيين.
وبحلول عامنا الأخير، بدأ طلاب المدرسة يتلقون عروضاً للانضمام إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، خليفة جهاز الاستخبارات السوفييتية (كي جي بي)، للعمل كمترجمين عسكريين، أو الانضمام إلى الخدمة الخارجية. وذهب بعضهم للعمل في مؤسسات واجهة، مثل المنظمة الروسية للتعاون في الخارج، في حين دخل آخرون، سعياً وراء تدفقات نقدية أكبر، قطاع الطاقة. وفي غضون عام أو عامين، انتشروا في مختلف أنحاء المنطقة: تنسيق المعارض الثقافية في أنقرة، وبناء الغواصات في بندر عباس في إيران، ومواجهة النفوذ الأميركي في طرابلس. وحتى أنا، بالعربية الركيكة التي أتقنها، حصلت على وظيفة مترجم على منصة نفط في مصر.
أدت جميع الطرق من الجامعة إلى خدمة الدولة، وحتى أولئك الذين يتابعون وظائف أكاديمية انتهى بهم الأمر بالحصول على منح رئاسية، أو الجلوس في اللجان والمجالس الحكومية أو القيام بأعمال أثرية كجزء من جهود بوتين لاستعادة الوضع الإمبراطوري لروسيا. يتجول زميل لي، وهو متخصص في تاريخ الفن، الآن في الأراضي المحتلة في أوكرانيا بمرافقة عسكرية، بحثاً عن القطع الأثرية السكيثية. كما أنه يشرف على إنشاء متحف دعاية في ماريوبول – المدينة التي قتل فيها عشرات الآلاف من الأوكرانيين.
في حين أن الجميع من المدرسة لم يذهبوا للعمل في الدولة، إلا أن الحقيقة هي أن الدولة فقط هي التي يمكنها توفير وظائف للخريجين الحاصلين على شهادات في الدراسات العربية أو الأردية أو الفن الفارسي قبل الإسلام. في رحلتي إلى إيران في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أقمت أنا وأصدقائي في الجامعة في السفارة الروسية حيث كان يعمل بعض زملائهم في الدراسة. لقد رأيت نوع الحياة التي أعدتنا لنا المدرسة: كان عليك تسجيل الخروج في كل مرة تغادر فيها المجمع، وكانت أماكن المعيشة تراقب من قبل المخابرات الأجنبية الروسية، ومن المحتمل أن يكون كل بوّاب أو عامل نظافة، أو سبّاك أو بستاني معين محلياً عميلاً لأجهزة المخابرات في البلد المضيف.
كانت هناك أقسام كاملة من المجمع حيث لا يمكنك التحدث على الإطلاق. أصبح الطلاب السابقون جنوداً مخلصين، وصارت حياتهم مختلفة الآن: لقد أصبحوا بمناصب سكرتير ثاني وثالث؛ يحملون جوازات سفر خدمية ودبلوماسية؛ يفتقدون المطر وليالي سانت بطرسبرغ البيضاء في الصيف؛ يتوقون إلى الطعم الحامض لخبز الجاودار الروسي. وكانوا يشربون الفودكا – ربما مهربة. قال أحد موظفي السفارة مازحاً إنها كانت تأتي في حقيبة دبلوماسية.
في سوريا، بدأ الروس في العمل مثل قوة استعمارية في القرن الثامن عشر مزودة بنظارات للرؤية الليلية، واستخرجوا الموارد الطبيعية وتدخلوا عسكرياً عندما كانت مصالحهم على المحك. كان ذلك بفضل شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة وزعيمها الراحل يفغيني بريغوجين. واتهم مرتزقتها لاحقاً بارتكاب العديد من جرائم الحرب في كل مكان تم نشرهم فيه. جاء الرجال الذين يحملون البنادق من جميع مناحي الحياة (التجارب)، لكن فاغنر كانت أكثر من مجرد قوة: فقد كانت تدير العمليات السياسية وجمع المعلومات الاستخباراتية، وحتى كان لدى زعيمها ذراع دبلوماسية – للتفاوض مع العديد من أمراء الحرب الذين تخدمهم شركته. بالصدفة أم غير ذلك، كان مكتب بريغوجين على بعد مبنى من المدرسة، وللأسف، جاء العديد من خبراء السياسة والمترجمين والمحللين في فاغنر من المؤسسة.
- الأشخاص الذين درسوا إفريقيا والشرق الأوسط ذات يوم بدافع اهتمام حقيقي يطبقون الآن معارفهم لتدمير المناطق. برر البعض أفعالهم بأنها خدمة للدولة، معتقدين بالمجد لروسيا، بينما بالنسبة للآخرين، كان العمل مع بريغوجين مجرد وظيفة. “وإلا كيف يمكنني العمل في إفريقيا؟” قال لي أحدهم. علمت المدرسة الكثير من التاريخ والسياسة والتقاليد لدرجة أنها نسيت على ما يبدو أن تعلمنا الأساسيات: المرتزقة سيئون، ومساعدة أمراء الحرب على قتل الفقراء من أجل الماس أمر سيئ والعمل في شركة تحرق الناس أحياء – كما فعل فاغنر في سوريا – فعل إجرامي بلا شك.
زرت سوريا مرة واحدة فقط، في عام 2006، خلال سنتي الأولى. كان لدى شركة إيروفلوت رحلة أسبوعية مباشرة من موسكو. عندما هبطت، كان ينتظرني ممثل من وكالة السفر التي كنت أستخدمها في دمشق على مدرج المطار. أخذ جواز سفري وقادني بعيداً عن الركاب الآخرين. مررنا عبر ممر دبلوماسي فارغ. لم يكن هناك كوّة لمراقبة الجوازات. تم تسليم جواز سفري إلي مختوماً بالفعل.
كنت أعلم أن لفت الانتباه إلى نفسي ــ أو الظهور بمظهر الأجنبي الواضح ــ نادراً ما يكون فكرة جيدة، ولكن هذا كان غير حكيم بشكل خاص في الشرق الأوسط، كما ذُكِّرنا في المدرسة كثيراً ــ ما لم تكن في منتجع بالطبع. لذا، قبل المغادرة، أمضيت ساعات في دراسة صور الحياة اليومية في دمشق، واختيار أنواع ملابس تساعدني على الاندماج مع الناس. كان أجدادي من جهة أمي يهوداً ــ على الأرجح من السفارديم ــ من خرسون، وهي مدينة أوكرانية تقع على البحر الأسود. احتفظت ببعض سماتهم المتوسطية، وفي سوريا، افترض معظم الناس أنني لبناني. وما لم أتحدث، لم أحظ بالمعاملة السياحية. وفي إحدى بعد الظهيرة، كنت الزائر الوحيد في تدمر، حيث تناولت طعامي على رواق متهالك. وزرت المسجد الأموي شبه الخاوي، وهو أحد أعظم المساجد في العالم، وتناولت المشروبات في حي باب توما القديم في دمشق، وتسلقت حول قلعة الحصن الصليبية. ومرت الرحلة التي استغرقت شهراً دون أي عقبات. تقريباً.
في المطار، احتجزني حرس الحدود في نقطة تفتيش الجوازات. كانت لغتي العربية جيدة بما يكفي لفهم ما قالوه لي: كانت العلامة الموجودة على جواز سفري مجرد ختم دخول. لم يكن لدي تأشيرة سورية ودخلت البلاد بشكل غير قانوني. أخذوني إلى غرفة في المطار حيث كان ثلاثة جنود مسلحين ببنادق كلاشينكوف صينية الصنع يتجاذبون أطراف الحديث أثناء تناول الشاي.
كانت رحلتي تغادر في أقل من ساعة؛ الرحلة التالية لن تكون لمدة أسبوع. إذا لم أصعد إلى الطائرة، فإن المخابرات (الشرطة السرية) ستكتشف في النهاية أنه على الرغم من النسر ذي الرأسين على جواز سفري الروسي الأحمر، كنت يهوديا أمريكياً. من حيث العواقب، هذا إلى حد كبير أسوأ شخص يمكن أن يكون في سوريا، في المرتبة الثانية بعد يهودي إسرائيلي. قام أحد الجنود بضبط حزام بندقيته الآلية. وخطر ببالي فكرة: “إذا أطلقوا النار علي، فسوف تقتلني أمي”.
بسبب ما أطلقوا عليه “الولاء المزدوج” – وجود أقارب إلي في دول معادية وتراثي غير السلافي – لم أتلق أبداً عرضاً للعمل في المخابرات الروسية. ومع ذلك، يمكنني طلب مكالمة هاتفية، والتواصل مع أصدقائي في روسيا، وطلب منهم الاتصال بأصدقائهم في السفارة في دمشق وتسوية الأمر قبل إقلاع رحلتي. ومع ذلك، فإن إجراء هذه المكالمة سيكون بمثابة ما يعادل التقدم للوظيفة. لم أكن أعرف سوى القليل عن كيفية عمل وكالات الاستخبارات الروسية، لكنني كنت أعرف أنك لا تريد أبداً أن تكون مديناً لها.
ظهر رجل سوري يرتدي بدلة، ورمقني بنظرة تقييمية – لطيفة يقدمها عملاء المخابرات عندما يقابلونك. تذكرت ما علموني إياه عن التفاعل مع المسؤولين المحليين: فتحت ذراعي قليلاً وابتسمت وشرحت له بلغة إنكليزية مكسورة بلكنة روسية ثقيلة أن ما حدث كان خارجاً عن إرادتي. لم أكن أعرف أنني مررت ب “خط مطار خاص“. كل ما فعلته هو التقاط صور للمساجد وتدمر، كما أخبرته، وكنت أعشق صور بوتين في الشوارع. رفعت يدي في وشبكت كفيّ: “روسيا، سوريا، صديق”، توسلت، مستخدماً واحدة من العديد من الكلمات العربية لكلمة “صديق”. أدار الرجل وجهه وقال شيئاً للجنود واصطحبوني إلى الطائرة.
كان كل ما كتبته من معالجة سينمائية للممثل الذي تحول إلى منتج من الدرجة الثانية يثير غضبه. كانت القصص مبنية على ما أعرفه عن الروس على الأرض: كان بطل الرواية مدمناً للكحول، وكان يكره المكان الذي كان متمركزاً فيه، وكانت وظيفته، في الغالب، التعامل مع الأوراق الرسمية. كنت أتقاضى أجراً مقابل ما أوصله، لكنهم أخبروني أنني لن أكون مطلوباً بعد الآن. قال إنني لم أكن مناسباً، لأنني كنت أسخر من أعظم أبناء روسيا. قبل بضع سنوات، أصدرت وزارة الدفاع الروسية الفيلم الروائي الطويل “نيبو” أو “السماء”، وهو فيلم دعائي عن الطيارين الروس في سوريا. تم تصوير القتلة الذين ألقوا القنابل (البراميل المتفجرة) على المدن على أنهم أبطال.
لم أستطع أن أرغم نفسي على مشاهدة الفيلم، ولكنني متأكد من أن الإنتاج استعان بأشخاص من مدرستي. لقد درست التاريخ، ورأيت مدينة تدمر قبل أن يدمروها، ولم أمسك بأي شيء بيدي اليسرى قط. كنت أفتخر بفهمي للشرق الأوسط. ولكن رؤية المنطقة باعتبارها عقدة غوردية كانت تعني في نفس الوقت رؤيتها باعتبارها كائناً، لغزاً يجب حله، وليس مجموعة من الناس يجب فهمهم. وكانت وجهة نظري لا تزال وجهة نظر استعمارية ــ مجرد وجهة نظر متعلمة. وبغض النظر عن مدى محاولتي التمييز بيني وبين أولئك الذين جلبوا الألم إلى الشرق الأوسط باسم خدمة بلادهم، فأنا أعلم أنني كنت أقرب إليهم كثيراً من الأشخاص الذين حاولوا تحسين الحياة هناك ــ أو على الأقل ابتعدوا عنها.