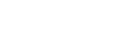*ميثاق: تقارير وأخبار
ترجمات: المصدر “New Lines”
هوية مفقودة في الحرب
“ما تعلمته عندما غامرت في عمق البيروقراطية بدمشق ما بعد الحرب لتقديم طلب للحصول على بطاقة هوية بديلة”
“خلال رحلة العودة الأخيرة إلى سوريا، وجدت في وضع محفوف بالمخاطر حيث اضطررت إلى استبدال بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بي، والتي فقدت”.
كان من الممكن أن يكون مثل هذا الأمر كارثة في زمن الحرب، عندما اعتمد السوريون على السوق السوداء للحصول على بطاقات الهوية المفقودة والمسروقة كوسيلة لتجاوز التجنيد العسكري الإلزامي عن طريق الاحتيال وأوامر الاعتقال من قبل نظام مصمم على معاقبتهم على إظهار المعارضة. في ذلك الوقت، كان التقدم بطلب للحصول على بديل يشير إلى مواطن كمهرب محتمل. مرتكب أي عدد من الجرائم، بما في ذلك “مساعدة وتحريض الإرهابيين”، وهي الطريقة التي وصف بها نظام بشار الأسد ما لا يقل عن نصف البلاد، بما في ذلك معظم سكان الريف، منذ الأيام الأولى للانتفاضة عندما كانت الأمور لا تزال سلمية.
ولكن الآن بعد أن “انتصر النظام“، تغير تركيزه الرئيسي. كل ما يهمه هو المال. ومع انهيار العملة المحلية التي أجبرت حتى بائع القهوة على استخدام آلة عد النقود لأن العملاء يدفعون بأكياس مليئة بالنقود، يتتبع الجميع عن طريق تحويل قيمة أرباحهم بالدولار الأمريكي في رؤوسهم. هذه هي الطريقة التي يفكر بها المسؤولون والبيروقراطيون الصغار في الرشاوى التي يتوقعونها في كل منعطف ومنعطف أثناء تفاعلهم مع المواطنين. قدمت بطاقة هويتي المفقودة فرصة ممتازة لمثل هذا الشيء، على الرغم من أنني في البداية لم أكن أعرف إلى أي مدى.
وهكذا بدأت رحلتي إلى عمق بيروقراطية الأسد، التي، كما علمت، أصبحت أكثر جشعاً وأكثر جرأة مما تذكرت. لمساعدتي في التنقل في هذه المتاهة، بما في ذلك البروتوكولات الدقيقة لتوزيع الرشاوى (وهو علم جزئياً ولكنه في الغالب فن)، رافقني ابن عمي بلطف، سترته الجلدية مليئة بحشوات من النقود مدسوسة ومخبأة داخل جيوب سرية.
في وزارة الداخلية، وجدنا أنفسنا داخل صرحها، واضطررنا إلى صعود السلالم والسير عبر الممرات، والدخول والخروج من المكاتب والتنقل من مكان إلى آخر. اعتاد ابن عمي، وهو تاجر شاب، على التنقل في الروتين، وطلب هذا الشخص وذاك وملأ النماذج نيابة عني، ودربني على ما يجب أن أقوله في كل مفترق طرق.
“لقد فقدت بطاقة هويتك هنا، في هذا الحي، في أسفل الشارع، بجانب النافورة، حسنا؟” قالها بهمس خفيف.
“حسنا”، قلت، معتقداً أنه مكان جيد مثل أي مكان لفقدان بطاقة الهوية. مع ذلك، كنا على استعداد لتقديم تقرير الشرطة.
ولكن قبل أن نتمكن من الذهاب إلى مركز الشرطة لملء الأوراق، كان علينا أولاً أن نروي قصتنا للمختار المحلي – أقرب إلى عمدة المنطقة – الذي يجلس داخل مكتب قائم بذاته، وهو مبنى من غرفة واحدة مصنوع من الخرسانة، مع نوافذ وباب يفتح على الرصيف. كل حي في المدينة لديه مثل هذا الهيكل، وهو المكان الذي يذهب إليه السكان المحليون للتواصل مع ممثلي “الدولة” وبدء المسار الورقي البيروقراطي الذي يميز الأحداث الرئيسية في الحياة، أشياء مثل الزواج وشهادات الميلاد والوفاة أو، في حالتي، طلب لاستبدال بطاقة الهوية المفقودة.
كنا قد بدأنا يومنا في الساعة 8 صباحاً، وكان منتصف النهار عندما وصلنا إلى مكتب المختار، لنجده مغلقاً. ربما كان قد خرج لتناول طعام الغداء أو للقيام بمهمة ، كما اعتقدنا ، لذلك وقفنا وانتظرنا عودته. ظهرت عائلة مكونة من خمسة أفراد ، مثلنا ، أصيبوا بخيبة أمل عندما وجدوا المكتب مغلقاً.
“لقد كان هنا للتو!” قال الأب، جزئياً لنا وجزئياً لعائلته. “لقد أرسلنا للتو للحصول على توقيع قاب قوسين أو أدنى. أين ذهب؟” حمل صوته يأس شخص أيقظ عائلته في منتصف الليل وحشدهم للقيام برحلة تستغرق ساعات بوسائل النقل العام من قريتهم – الواقعة في مكان ما في المقاطعات الريفية حيث، لم تعد الخدمات الحكومية الأساسية تقدم منذ الحرب – إلى المدينة لتجاوز الروتين لتسجيل أطفالهم في المدرسة أو نقل سند الملكية. هذا من شأنه أن يفسر النظرات الفاترة لأطفاله والهالات السوداء تحت أعينهم.
لحسن حظنا جميعاً، ظهر المختار بعد فترة وجيزة. يجب أن يكون قد ذهب بالفعل لتناول الغداء أو القيام بمهمة. فتح مكتبه، دعانا جميعاً للدخول. بعد أخذ الوثائق من الأسرة الريفية، أشار إلي، مستفسراً عن العمل الذي ربما جلبني إليه.
- قلت: “أحتاج إلى الإبلاغ عن بطاقة هويتي المفقودة”. تقدم ابن عمي على الفور وسلمه وثائقي.
نظر المختار إلى أوراقي بتجهم، ثم أعاد توجيه تركيزه إلى العائلة وخلط الورق على مكتبه كما لو كان يشتري بعض الوقت للتفكير في الرد. استغرق الأمر دقيقة أو دقيقتين قبل أن ينظر إلي ويعلن أنه لا يستطيع المساعدة. وقال: “يجب أن تذهب إلى المختار الآخر، هناك”، مشيراً إلى الجانب الآخر من الساحة العامة. لم يعط أي سبب لذلك، ولم نستفسر عن واحد قبل أن نذهب.

في وقت لاحق، تكهننا أنه ربما كان خائفاً جداً من لمس مستنداتي. تظل طلبات الحصول على بطاقات الهوية الوطنية المفقودة أو المسروقة بمثابة “مانع صواعق” للمسؤولين الحكوميين، ولا أحد يريد أن يرتبط بمساعدة مواطن على التنقل في مثل هذا المستنقع. إلى جانب ذلك، يمكن التدقيق في هذه الطلبات في السلسلة، حيث قد يشك الرئيس بحق في أن المرؤوسين يجب أن يكونوا قد تلقوا رشاوى كبيرة لتسهيل مثل هذا الشيء، وبالتالي سيضغط عليهم للحصول على حصة مما تخيلوا أنه مبلغ كبير من المال – ربما يكفي لملء حقيبة بالليرة السورية.
وجدنا المختار الثاني جالساً خلف مكتبه داخل مكتبه على الرصيف، وبدا مشرق العينين ومتيقّظ. هنا، كان لدينا استقبال مختلف.
قلت له: “أحتاج إلى تقديم تقرير للشرطة للحصول على بطاقة هوية مفقودة”. قام بالنظر إلينا من أسفل إلى الأعلى، ثم تابع بعدد كبير من الأسئلة: أين ضاعت؟ متى كانت آخر مرة حصلت فيها على ذلك؟ أين أعيش الآن؟ أي حي بالضبط؟ لم أمانع في خط استجوابه لأنه على الأقل كان يعني أنه مستعد لمساعدتنا في تحريك العملية.
ومن حوارنا، سرعان ما اتضح له أنني مغترب، لأن “لساني تحدث بهذا الثقل الواضح” للسوريين الذين يعيشون في أماكن أخرى. وتأكد أيضاً من عنواني المحلي أن منزلي كان في حي ميسور الحال في دمشق، “ليس بعيداً عني، في الواقع”، أضاف، وبدا منبهراً. لم يكن هذا رمزاً للطبقة فحسب، بل للانقسام بين المناطق الحضرية والريفية التي لا تزال تتفاقم في المجتمع السوري. كنا كلانا من سكان المدن، دمشقيين حقيقيين، يفترض أننا من عائلات جيدة، في حين أن أول مختار زرناه كان رجلاً من أصول متواضعة، وهو واحد من العديد من المسؤولين الريفيين الذين نقلتهم الدولة للخدمة في منطقة حضرية، وهو أمر يثير الذعر الشديد للنخب الحضرية، الذين لا يسعهم إلا أن ينظروا بازدراء إلى أهل الريف.
ويحيط بهذا الانقسام أيضاً الواقع الطائفي المتمثل في أنه مع احتدام الحرب في سوريا، كان المسلمون السنة الريفيون هم وحدهم الذين وجدوا أنفسهم يقاتلون النظام. وقد أكسبهم ذلك ازدراء “كرهاً” من المسؤولين الحكوميين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى نفس الطائفة العلوية (الإقليمية) مثل طائفة الأسد، وكذلك من سكان المدن المسلمين السنة الذين يعتقدون أنهم “أفضل” من أي شخص آخر.
بدا أن هذه التعقيدات كانت تلعب دوراً في مكتب المختار عندما قرر أننا من نفس الطائفة (السُنة)، وهكذا انتقل إلى خط التحقيق التالي.
“هذا أنت وهذا أنت؟” سأل، وبدا متشككاً، مشيراً إلى صورتي- واحدة من اليوم السابق والأخرى من 25 عاماً مضت، من نسخة من هويتي المفقودة، والتي لحسن الحظ كانت بحوزتي للمساعدة في تسهيل العملية. من المؤكد أنني كنت أكبر سناً الآن وكان شعري طويلاً وفضياً، ولكن كان هناك ما هو أكثر من استفساره من مرور الوقت الواضح. كان يخضعني لأسلوب استجواب كلاسيكي أصبح السوريون معتادين عليه خلال الحرب. مسؤول يسأل عن الوثائق الخاصة بك. عندما تقوم باستصدارها، يخبرك المسؤول، تلقائياً تقريباً ودون التدقيق فيها بأي طريقة مقنعة، أنها مزيفة، متهماً إياك بالتزوير والاحتيال. خلال الحرب، كانت هذه طريقة لأتباع النظام لزعزعتك، وطردك من المألوف ومعرفة ما إذا كنت خائفاً بسهولة. إذا كنت كذلك، فماذا كنت تختبئ؟ لا بد أنه كان جزءاً من تدريبهم، وهي خدعة روسية قديمة تكررت في كتيبهم العلمي الزائف عن “الحرب النفسية”.
رددت على المختار بنفس الطريقة التي كنت أرد بها على الحراس المسلحين أثناء الحرب: حافظت على هدوئي وأصررت بصوت رتيب على أن وثائقي ليست مزورة. كلتا الصورتين كانت بالفعل لي.
خلال هذا التبادل، قاطعنا رجل في الثلاثينات من عمره بخجل في مكتب المختار لكنه لم يقل شيئاً، الأمر الذي بدا أنه يزعج المختار، الذي قرر يوجّه إليه توبيخاً.
- “إيه! أنت تدس رأسك في البحث عن المختار ولا تسأل أين المختار؟ ألا أبدو مثل المختار بالنسبة لك؟” سأل.
- “أوه، لا، أنت تفعل”، أجاب الرجل، بشكل محرج.
- “هيا، ماذا تحتاج؟” سأل المختار. وكان صوته جهورياً وصاخباً.
- قال الرجل: “أحتاج إلى تغيير عنوان شهادة الزواج”.
- “من يتزوج في ظروف اليوم؟ لماذا يتزوج أي شخص في الوقت الحاضر؟” قال المختار ساخراً.
- “الأوراق ليست لي، في الواقع. لكنهم بحاجة إليها للعروس”، قال الرجل، وهو في حالة ضعف.
- “كيف يمكنني أن أنقل لك رسالة ‘من يتزوج هذه الأيام؟'” قال المختار. “هل أرسلها بالجمل؟ بواسطة الأغنام؟ بالماعز؟”
كانت لهجته ساخرة، لكن في السؤال عن الزواج لم يكن مخطئاً. من يريد أن يؤسس أسرة ويجلب الأطفال إلى هذا العالم؟ لم أذهب إلى سوريا منذ سنوات، وما رأيته الآن جعلني أتساءل كيف يتدبر الناس أمورهم ويدبرون أمورهم، بالنظر إلى التضخم والفساد وعدم وجود فرصة لكسب عيش شريف – أو حتى كريم. كان هذا بلداً في حالة سقوط حر بعد الحرب، حيث لم يكن للمنتصر فضيلة وكانت الضحية منسية. بلد لا يزال ممزقاً، شعب محكوم عليه بالعيش تحت رحمة العناصر والزلازل والغارات الجوية التي ينفذها الأسد وروسيا من حين لآخر والتي تستمر في الشمال، أو العيش في ظل العقوبات الدولية التي تشل أجزاء البلاد التي هي في قبضة الأسد. في غياب ما يشبه خطة مارشال لإعادة بناء ما تم تدميره (في الغالب من قبل نظام الأسد والروس)، يبدو أن ما يبقي السوريين متفائلين هو فكرة مصححة للمضي قدماً إلى شيء يشبه الماضي، ولكن أسوأ. ومع ذلك، بطريقة ما، في هذا السياق، لا يزال الناس يرغبون في الزواج وتكوين أسرة، متخيلين أنهم سيتمكنون من الهجرة إلى مكان يسمح بذلك.
في نهاية المطاف، طلب المختار من الرجل “أن يذهب لمعالجة مثل هذه الأوراق في أماكن أخرى”، في إشارة إلى المناطق الريفية.
“لكن عندما أذهب إلى المحكمة هناك، يطلبون مني المجيء إلى هنا”، اعترض الرجل، ولا يزال يحافظ على صوته ناعماً ووديعاً.
وقال المختار: “لذا اذهبوا إلى محكمة المقاطعة – في أسفل الشارع”، في إشارة إلى واحدة من العديد من البلديات الريفية التي تم نقلها مؤقتاً إلى دمشق. غادر الرجل دون مزيد من الجدل. كنت أظن أنه سيستمر في الحصول على الهروب حتى يجد شخصاً متعاطفاً لمساعدته. أعاد انتباهه إلي، أعلن المختار عن الخطوة التالية في العملية. كان علي أنا وابن عمي الذهاب إلى مخفر الشرطة لتقديم بلاغ. كان يرافقنا إلى هناك، ولأننا أصبحنا الآن “أصدقاء”، كان يعتني بنا. “هل لديك وثائقك العسكرية جاهزة؟” سأل ابن عمي. من خلال دخول مركز الشرطة، يخاطر الشاب بالتجنيد في الجيش على الفور إذا لم تكن وثائقه سليمة. “نعم ، هي جاهزة”، أجاب ابن عمي.
- “هل أنت متأكد؟ كل شيء على ما يرام؟” كرر المختار.
- “نعم، نعم. أنا متأكد”، قال ابن عمي.
- “جيد. وأنت؟” قال المختار وهو يلتفت إلي. “أي شيء قد يظهر في بحثهم؟ أي شيء على الإطلاق؟”
“لا. أعتقد أن كل شيء يجب أن يكون على ما يرام». بالتأكيد لم أكن لأتمكن من دخول البلاد إذا لم يكن سجلي نظيفاً، كما اعتقدت. بالتأكيد، لم يكن هناك استدعاء معلق بالنسبة لي، ولا شيء يذكر أنني كنت مطلوباً للاستجواب من قبل المخابرات العسكرية، كما كان الحال في الماضي. كما هو الحال لمئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من السوريين. يمكن أن تكون أسباب ذلك متنوعة مثل القدوم من قرية معارضة إلى كونك موضوعاً للثأر الشخصي من قبل شخص لديه علاقات وطيدة.
نهض المختار راضياً ورافقنا سيراً على الأقدام إلى مركز الشرطة، الذي يقع على بعد بضعة مبان في الشارع.
في المخفر، تم إدخالي أنا وابن عمي على الفور إلى مكتب بينما وقف المختار في الردهة بالخارج، وتجاذبنا أطراف الحديث سراً مع أحد المحققين. في المكتب وقف رجلان في ثياب مدنية. لم أستطع على الفور معرفة ما إذا كانوا هم أيضاً هناك لتقديم تقرير للشرطة أو إذا كانوا هم أنفسهم الشرطة.
- “أين فقدت لك؟” سأل أحدهم. حمل نفسه بنفس ثقة المختار. حرصت على التمسك بقصتي.
قلت: “بالقرب من هنا، أسفل الشارع، بجوار النافورة مباشرة”. الحقيقة هي أنه لم يكن لدي أي فكرة عن المكان الذي فقدته فيه. لا أعتقد حتى أنني كنت الشخص الذي فقدها. أعتقد أن شخصاً ما في منزلي قام بنقلها أو تخبئتها، وقد يظهر يوماً ما أثناء التنظيف في الربيع، أو تستقر في الجزء الخلفي من الخزانة أو بين المرتبة وإطار السرير. لم أستطع أن أقول شيئاً من هذا للمختار لأنه كان سيضطر إلى إرسالي إلى دائرة أخرى في منطقة مختلفة تماماً، دائرة لها سلطة قضائية على الحي الذي فقدت فيه هويتي، حيث لم يكن لدي أي اتصال مثل ابن عمي لمرافقتي في هذه الرحلة الغريبة.
- “إذن، بجانب النافورة؟” كرر الرجل الذي يرتدي ملابس مدنية.
- “نعم، هناك فقط بجانب النافورة”، قلت، متمسكاً بالكذبة. لقد فقد قول الحقيقة فضيلته منذ فترة طويلة في مكان كهذا.
- “ومتى حدث ذلك؟” قال. قلت: “بالأمس فقط”. كذبة أخرى. كانت هويتي مفقودة منذ عام على الأقل.
المزيد من التوتر. المزيد من الخلط. وجدت أنا وابن عمي أنفسنا في مكتب مختلف، هذا المكتب الأبعد داخل المنطقة، كما لو كنا نبتعد ببطء وبعيداً عن الباب الرئيسي، حيث ظللت أحاول البقاء. لم أفعل ذلك كثيراً لأنني شعرت بالحاجة إلى أن أكون قريباً من الخروج في حال احتجت إلى الخروج من مركز الشرطة أو أي شيء من هذا القبيل. فعلت ذلك للابتعاد عن الرائحة الكريهة الخانقة لدخان السجائر التي اجتاحت المكان. لكن في أي وقت اقتربت فيه بما يكفي من البوابة الرئيسية لشم رائحة الهواء النقي في الخارج، أمرني مسؤول في ثياب مدنية بالتحرك أبعد في الداخل. لقد فعل ذلك دون إبداء سبب، ولم أشعر بالحاجة إلى الاستفسار.
لكنني أعتقد، بشكل عام، أنني كنت أكثر هدوءاً من ابن عمي، الذي جلس بجانبي في المكتب الكبير، بالتناوب بين قضم أظافره وهز ساقه. واجهنا مكتبان فارغان غير مشغولين في هذه الغرفة، وبقينا صامتين بينما كنا نشاهد المحققين يأتون ويذهبون، وينزلون الوثائق ويفتحون الأدراج ويغلقونها، كما لو كانوا يبحثون عن شيء استعصى عليهم، على الرغم من أن الأدراج كانت فارغة. في مرحلة ما، دخل أحد المحققين ولم يضع زوجاً واحدا بل زوجين من الأصفاد على مكتبه، ثم شرع في المرور عبر الأدراج. تحدث محقق آخر على هاتف خلوي، وهو يتمتم عن “الصور المفقودة”.
نظرت حول الغرفة ولاحظت تناثرها. لم تكن هناك أجهزة كمبيوتر ولا هواتف أرضية ولا دباسات ولا مشابك ورق ولا ورق طباعة. كانت الأرضية قاحلة وقذرة، وكانت الجدران، البيضاء في الأصل، قد تراكمت طبقة رقيقة من السخام. صورة وحيدة للأسد معلقة على الحائط، وإطار بلاستيكي رخيص يحيط بها. كان المشهد نموذجياً للمباني الحكومية، حيث حتى لو تم تزويد الحمامات بالصابون وورق التواليت، فإنها تختفي على الفور – يسرقها الموظفون ويأخذونها إلى منازلهم أو يبيعونها في الشارع للحصول على نقود إضافية. لكنها لا تزال تشعر بالحزن والندرة أكثر مما كانت عليه في سوريا التي عرفتها في السنوات الماضية، وأكثر إثارة للخوف، خاصة وأن الفرق بين من يملكون ومن لا يملكون أصبح أكثر وضوحاً. في وقت سابق من اليوم، رأيت في أحد المباني ما استحوذ على المزاج العام لسوريا ما بعد الحرب. كان رجل يمشّي حيوانه الأليف، الذي كان يرتدي قميصاً للكلاب، بينما كانت امرأة عجوز تغوص في حاوية قمامة، بحثاً عن لقمة للأكل. سارت امرأة شابة في الشارع تظهر وسطها، أي أن سرّتها مشكوفة، بينما كان رجل مسن، أعمى وذو أرجل مقوسة، يتسول. لقد تجاهلوا بعضهم بعضًا، كما لو أن “الداروينية” الجديدة المتمثلة في قيام حكومة تتغذى على المواطنين والفقراء الذين يتغذون على فضلات أولئك الذين يكادون يتغذون بينما كلاب اللعب تتمايل في الشارع لم تكن تذكيرًا مقلقًا بكيفية تحول البلاد إلى دولة وهم في حد ذاتها.
بالعودة إلى المنطقة، كان هناك المزيد من المجيء والذهاب. مر بعض الوقت، وقبل أن نعرف ذلك، قدم أحد المحققين المستند الذي أحتاجه من أجل المضي قدماً في طلب بدل عن الهوية المفقودة. لم أصدق ذلك عندما سلمها لي وأخبرنا أننا “انتهينا جميعا”، أحرار في الذهاب. في الخارج تحت أشعة الشمس والهواء النقي تنفست أنا وابن عمي الصعداء، وروينا لبعضنا البعض الأجزاء الأكثر إثارة للقلق.
“عندما وضع زوجين من الأصفاد على مكتبه؟ اعتقدت أن هذه كانت نهايتنا”، قال ابن عمي.
“أنا أعلم! أنا أيضاً»، أجبت.
بالعودة إلى وزارة الداخلية، سلمنا تقرير الشرطة وقيل لنا إن بطاقتي البديلة ستكون جاهزة للاستلام في غضون أيام قليلة.
تركت ابن عمي ليعتني بعمله وقررت التجول في المدينة لتغيير مزاجي. تركتني أبخرة العادم الناتجة عن حركة المرور ألهث بحثاً عن الهواء بنفس الطريقة التي شعرت بها عندما أحسست بأنني محاصر داخل المنطقة، لكنني كنت في المدينة القديمة، المنطقة التاريخية التي كانت دائماً الجزء المفضل لدي في دمشق. اعتدت أن آتي إلى هنا حتى أثناء الحرب، بعد أن أغلقت المتاجر التي تبيع الحلي والشاورما والتخصصات المحلية مثل عصير عرق السوس أبوابها، وتضاءل عدد التجار الذين باعوا المنسوجات واللؤلؤ والتوابل لأجيال، أو أفلسوا أو نفيوا أو – مثل بعض أقاربي – قتلوا، اختفوا أو اختطفوا للحصول على فدية، ولم يسمع عنهم مرة أخرى.
الآن، بدت المدينة القديمة مصممة على إحياء نفسها، على الرغم من كل التحديات. أعيد فتح المطاعم، ولكن لم يكن هناك سوى عدد قليل من العناصر المدرجة في قوائمها معروضة، وحتى تلك كانت باهظة الثمن بالنسبة لشخص يحقق متوسط دخل محلي يبلغ 50 دولاراً شهرياً أو نحو ذلك، مما جعلني أتساءل عن سبب ازدحامها مع ذلك. في بلد تحمل قدراً كبيراً من المعاناة، حيث لا تزال الأنقاض والدمار الناجم عن الحرب في مكانها كشهادة على ملايين القتلى أو النازحين، ومع وجود كثيرين آخرين على حافة اليأس، كيف يمكن للعديد من الناس أن يتدفقوا بالمال لدرجة أنهم يستطيعون قضاء ساعات في تناول الطعام بالخارج، ثم العودة إلى المنزل في سياراتهم الرياضية الجديدة اللامعة؟ لم يكن لدي أي إجابة على هذا، وفي أي وقت سألت فيه السكان المحليين، بدا أنهم أيضاً يتجاهلون في حيرة من التناقضات من حولهم.
بعد بضعة أيام، عدت إلى وزارة الداخلية واستلمتُ بطاقة هويتي الجديدة، اللامعة. على مر السنين، أخذتني بطاقة هويتي القديمة في جميع أنحاء سوريا – إلى القرى والمواقع الأثرية والشواطئ وقمم الجبال والبساتين والصحراء. عندما بدأت الحرب، أخذتني عبر معابر مثيرة للجدل إلى مناطق ذات أنقاض رمادية أحادية اللون، ومرت عبر أيدي مسلحين كانوا يهدفون إلى قتل بعضهم البعض. إلى أين ستأخذني الجديدة الآن؟ لقد كلفت ما يقرب من 1 مليون ليرة سورية (حوالي 200 دولار) كرشاوى، كما أخبرني ابن عمي لاحقاً، وهو ما يعادل تكلفة زيت التدفئة لعائلة صغيرة مقتصدة للبقاء دافئاً لمدة نصف فصل الشتاء ربما.